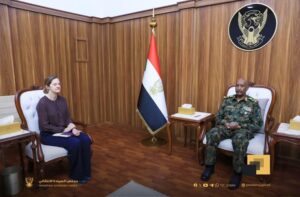حكومة الجبهة في طريقها إلى النهاية
الحكومه السودانية: أسباب البقاء وحتمية السقوط

في الوقت الذي لم تعرف السنوات الأولى من السبعينيات غير حفنة ضئيلة من الأنظمة الديمقراطية في أمريكا اللاتينية، غدت كوبا وجيانا منذ أوائل التسعينيات الدولتين الوحيدتين في النصف الغربي من الكره الأرضية اللتين لا تسمحان بانتخابات حرة. كذلك حدثت تطورات مشابهة في آسيا.
وبوسعنا أن ندرك الخطوات البطيئة، ولكنها في الاتجاه ذاته نحو الديمقراطية في كل من إفريقيا والشرق الأوسط.
عانت كل أشكال الحكم الديكتاتورية عيوباً خطيرة وانتهاكات للعقل أدت في النهاية إلى سقوطها. لكن كل الدكتاتوريات سعت إلى إقامة مفهوم خاص بشرعيتها، خاصة الشيوعية منها، التي حاولت إكتساب الشرعية من خلال برامج الإصلاح الزراعي، وتوفير الرعاية الصحية المجانية، ورفع نسبة المتعلمين، ومع ذلك حدثت خلخلة داخل الكتلة السوفيتية وفي الصين.
وفي الخليج هناك شكل من أشكال الرضا بالرخاء والرفاهية في مقابل التنازل عن الديمقراطية.
وبالرغم من تنامي الاعتقاد السائد بأن الديمقراطية هي المصدر الوحيد للسلطة في العالم الحديث، وجدنا على النقيض تماما الجبهة الإسلامية في السودان تستولي بالقوة على نظام ديمقراطي، وهو حدث يسير عكس اتجاه التاريخ ومسار التوجه الإنساني. وكان واضحاً منذ الوهلة الأولى أن جماعة الجبهة الإسلامية تفتقر إلى سياسات واضحة تجعلها تكسب الشرعية في أعين الشعب.
ولكي نفهم طبيعة هذه الدكتاتورية الشمولية،هناك ضرورة للتفريق بين الأنظمة الديكتاتورية التقليدية اليمينية “نظام عبود مثلاً” من جهة، وبين الأنظمة الشمولية الراديكالية اليسارية “كنظام نميري في بداياته”. والنظام الديكتاتوري الشمولي الإسلامي “كنظام الجبهة الاسلامية الحالي” من جهة أخرى. فالأولى لا تمس التوزيع القائم للثروة أو السلطة أو المركز الاجتماعي. أما الثانية فتدعي لنفسها الحق في تنظيم كل الجوانب الاجتماعية، وتنتهك القيم والعادات الشائعة، وتصادر الممتلكات الخاصة، وتحتكر السلطة والثروة ،وهي قادرة على التحكم في المجتمع بقسوة.
إن الأزمة التي صاحبت حكومة الإنقاذ هي أزمة فكرية وسياسية وتنفيذية. فقد تسببت الأزمة الفكرية في المذهب العقلي الجبهوي في انفصال الجنوب وإشعال الحروب الداخلية، وانقسام المجتمع ومصرع عشرات الآلاف من المواطنين، وأجبرت الملايين على العيش في ظل أشكال جديدة من الحرمان والفقر والجوع والقهر والإذلال.
أما في الجانب السياسي والتنفيذي فيتمثل الفشل في معاناة السودان من العزلة الخارجية، وداخلياً صار هدفاً للنقد حين فقد ثقة الناس فيه في تحقيق طموحاتهم في التعليم والصحة والأمن والرخاء الاقتصادي. وعلى النقيض تماماً أصبح النظام رمزاً للفساد ومسؤولاً عن هذا التدمير الانتحاري للدولة والمجتمع والاقتصاد.
وأصبح قادة النظام يمثلون قطاعات اجتماعية منبوذة تزداد بمرور الأيام هامشية في المجتمع السوداني، كما أنهم يفتقرون إلى الأفكار الجيدة والعقل النير والنوايا الحسنة. فبعد كل هذا الفشل غير المسبوق لم يعد هناك سبب في تمسك النظام بالسلطة سوى الخوف من الخطر الشخصي عليهم، بالنظر إلى أنهم سيفقدون بعد تنحيهم الحماية المتوافرة لهم ضد انتقام من أساؤوا معاملتهم.
وبعد كل هذا الفشل يكون السؤال: لماذا إذاً لم تسقط الحكومة؟!، كذلك يذهب بعض في اتجاه اتهام الأحزاب بالضعف؛ لأنها فشلت في إسقاط الحكومة.
وللإجابة عن هذه الأسئلة يمكننا أن نذكر الأسباب الآتية:
أولاً: كان لسلطان التنظيم الحديث والتكنولوجيا الحديثة وثوره الاتصالات العالمية الأثر في ظهور دكتاتوريات لها القدرة على التحكم، وبكل سهولة في أعداد كبيرة من الشعوب، وفي الوقت ذاته، تجعلها محصنة ضد التغيير والإصلاح؛ ولذلك ربما لم يكن مستغرباً أن أغلب الدكتاتوريات الحديثة انتقلت إلى الديمقراطية من تلقاء نفسها، بعد أن أثبتت عجزها عن التصدي للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي أسقطت عنها الشرعية، كما حدث في البيرو عام ١٩٨٠م، والبرازيل في عام ١٩٧٣م، وفي الأورغواي عام ١٩٨٣م، والسودان عام ١٩٦٤ و١٩٨٦م، عندما انحاز الجيش للشعب . واليونان والأرجنتين اختارتا العودة إلى الديمقراطية فى عامي ١٩٧٤م و١٩٨٣م، على التوالي، ولم يطرد العسكريون فيهما بالقوة من الحكم، وإنما أفسحوا الطريق أمام السلطة المدنية بسبب انقسامات داخلية في صفوفهم، وهي انقسامات تعكس تبدد الإيمان بحقهم في الحكم، وكان الفشل الخارجي هو السبب المباشر كما حدث في البرتغال.
ومع إدراكنا للإختلافات الحقيقيهة بين هذه الحالات، فإن هناك قدراً من الاتساق بين حالات الانتقال إلى الديمقراطية بين هذه الدول. فباستثناء سوموز فى نيكاراجوا، لم تكن هناك حالة واحدة اضطر فيها النظام إلى التخلي عن السلطه نتيجة الثورة أو أعمال عنف خطيرة.
ثانيا: نجحت ثورات الربيع العربي في إسقاط النظم في مصر وليبيا واليمن، لكنها لم تتمكن من ضمان أن تحل محلها الديمقراطية والاستقرار ما عدا تونس.
وانتتهى فرض الصمت والطاعة بأجهزة الأمن والدولة، وحل محله عصر الفوضى وسفك الدماء بلا نظام وبلا تحديد مسؤوليات، وهو ما أضعف إيمان بعض الناس بالثوره بوصفها أداة للتغيير، ومن هنا تعلمنا جميعا درساً مهماً، وهو أن أي تغيير في هذا العصر يجب أن تتوافر له شروط الغطاء السياسي والتوافق الاجتماعي وإلإ سوف تعقبه حالة من عدم الاستقرار، وربما الفوضى.
ثالثا: من الصعب اليوم إسقاط الحكومة من خلال احتجاجات محدودة في العاصمة، كما جرت العادة فى الفترات السابقة، لأن العاصمة أصبحت خارطة جغرافية مصغرة للسودان الكبير، وليس كما في السابق عندما كانت مجموعة اجتماعية متجانسة تتميز بمستوى متكافئ من الوعي تجعلها دائماً تتحرك بشكل جماعي تجاه ما تقرر.
ويمكننا أن نلمح إلى انحصار الاحتجاجات في أحياء تقع غالبيتها في حدود العاصمة القديمة، وغياب مشاركة الأحياء الطرفية، وهذا يؤشر لغياب القاسم الاجتماعي المشترك، ووجود اعتقاد أن كل مجموعة أخذت نصيبها من الظلم والإهمال، ولم تجد تضامناً وطنياً مقنعاً،خصوصاً أن تداعيات أغلب الكوارث كانت تفوق الأزمة الاقتصادية الحاليّة، نذكر منها: كارثة تهجير المحس، ومجاعة كردفان في ١٩٨٣م، وحرب الجنوب، وحرب دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وشرق السودان، وضحايا السدود الحديثة وغيرها من المظالم.
وقد يكون من الصعب تعميم هذا الاعتقاد لاستثناءات كثيرة من أحزاب ومثقفين وكتاب تصدوا وبكل شجاعة للأخطاء التي إرتكبتها الدكتاتوريات، إلأ أن النتائج كانت محدودة بسبب إرهاب الدولة وتحكمها في كل شيء.
رابعآ: كما نعلم هناك مجموعات مسلحة في أطراف البلاد تتحارب مع الحكومة، إضافه إلى تشكيلات عسكرية أخرى كونتها الحكومة (كالدعم السريع وحرس الحدود وغيرها) سيكون لها دور في التغيير القادم، وربما ستفرض سياسة الأمر الواقع، وتستولى على الحكم بالقوة في حال حدوث أي فراغ ، ومن الواضح أن هذا الأمر جعل كثيراً من المكونات الإجتماعية والسياسية غير راغبه في المشاركة في تغيير لا تتوافر فيه ضمان الانتقال الآمن إلى الديمقراطية والإستقرار.
ختاما: علينا أن ندرك أن العامل الأساسي الذي يجب توافره لنجاح أي ثوره ضد أي نظام دكتاتوري هو وجود شبه إجماع شعبي علي مطلب التغيير، وشيء من التجانس بين أبناء الشعب. كما يعدّ الموقف الفعلي للجيش والقوات المسلحة الأخرى من الانتفاضة الشعبية عاملاً مهماً، فإذا كان مؤيداً لها يصبح نجاهها حتمياً. وفي الانتفاضات السابقة كان الجيش قومياً ومحايداً، وإنحاز في كل مرة إلى الثورات، وهذا ما أدى إلى نجاحها.
وبناءً على ما سبق لأ أرى ما يدعو إلى تبسيط مسألة الثورة، كأنها أمر بيد الأحزاب، بيد أنها -أي الأحزاب- تستطيع أن تقوم بعملية تنظيم قيادة للشعب عندما يتوافق على أمر التغيير، وتوفير المظلة السياسية لذلك، والمشاركة في إنجاز ميثاق اجتماعي وسياسي يضمن مساهمة جميع المكونات في عملية التغيير والتزامهم جميعاً للانتقال إلى الديمقراطية والاستقرار.
ومهما يكن من أمر فالواضح أن حكومة الجبهة في طريقها إلى النهاية مثلها مثل أي حكومة تسقط عندما تفقد الشرعية في أعين الشعب. وسوف تستمر في المعاناة من أزمة قاسية متواصلة في جميع النواحي، فعليها أن تختار ما بين تسليم السلطة لحكومة قومية أو أن تنتظر أمراً مفاجئاً، وسوف لن يكون ذلك في مصلحتها ولا في مصلحه الوطن.
عبدالحليم تيمان