حول علاقة المتعلمين السودانيين بالسلطة الاستعمارية.. شذرات من كتاب “العيش مع الاستعمار” لهيذر شاركي

Living with colonialism: Nationalism and culture in the Anglo-Egyptian Sudan. By Heather Sharky

تقديم: هذه ترجمة لشذرات قليلة من الفصل الخامس في كتاب “العيش مع الاستعمار: الوطنية والثقافة في السودان الإنجليزي – المصري” (الذي هو قيد الترجمة الآن) للمؤرخة الأمريكية هيذر شاركي، المتخصصة في التاريخ الحديث للشرق الأوسط وإفريقيا، والعالمين المسيحي والإسلامي. حصلت المؤلفة (الأستاذة بجامعة فيلادلفيا) على درجة البكالوريوس في الأنثروبولوجيا من جامعة ييل الأميركية، ودرجتي الماجستير والدكتوراه من جامعتي درم البريطانية وبرنستون الأميركية، على التوالي، ولها عدة كتب ومقالات عن السودان ومصر.
صدر هذا الكتاب عام 2003م عن دار نشر جامعة كالفورنيا، وبه ستة فصول وخلاصة وشرح للمصطلحات، وعدد هائل من الحواشي (Notes) والمراجع (Bibliography)والإشارات لمقابلات مع شخصيات سودانية وأجنبية. ولم نشر في هذه الشذرات لتلك لحواشي أو المراجع.
المترجم
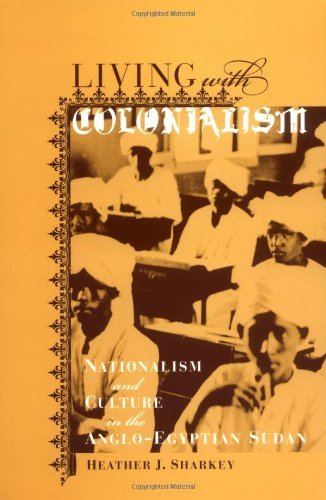
1.كان لموظفي الحكومة (الأفندية والسادة Babus والأهالي المُتَأَوْرِبين / المُتَفَرْنِجين) في مستعمرات بريطانيا بأفريقيا وآسيا علاقات حميمة مع الدولة الاستعمارية، ولكنها كانت أيضاً علاقات يسودها التوتر. وقد عانى أولئك الرجال في سبيل التعامل مع اندماجهم الهامشي في النظام الحاكم، إذ أن مجموعتهم كانت تتألف من “نخبة” (في مقابل باقي “الأهالي”)، ولكنهم كانوا أيضاً يمثلون طبقة ثانوية من الموظفين ذوي الرتب المتدنية داخل التسلسل الهرمي للحكومة. وزَادَ الطِّينَ بَلَّةً أنه في حين أن الدولة الاستعمارية قد ألهتهم التفكير في المنطقة كأمة، أو بالأحرى “أمتهم” – فقد حرمتهم تلك الدولة الاستعمارية من القيادة فيها. وجعلت تلك المضايقات من سيكولوجية خدمتهم لها، وشروط تعاونهم معها، أمراً في غاية التعقيد.
وتوضح التجربة السودانية تلك النقاط. فقد حافظت بريطانيا على النظام الحاكم في السودان الإنجليزي – المصري بتعيينها لأعداد كبيرة من المتعلمين السودانيين الشماليين في وظائفها الحكومية. وعمل هؤلاء في جمع الضرائب، وفي ترجمة وبث القوانين واللوائح والمذكرات التي تصدرها الحكومة، وقاموا حتى – في بعض الحالات – بالانضمام لقوات الحكومة في حملاتها ضد انتفاضات من تمردوا عليها في المناطق الريفية. وبفضل العون والتأييد والمساندة التي لقيها النظام الاستعماري من المتعلمين السودانيين الشماليين بقي ذلك النظام لأكثر من نصف قرن من الزمان. وعلى الرغم من ذلك، فقد نمت وطورت ذات المجموعة من المتعلمين السودانيين الشماليين أيديولوجيات وطنية لتحدي الوجود البريطاني في مجالات السياسة والثقافة. وحظي أولئك الرجال، بعد نيل السودان لاستقلاله في 1956م، بالذكر الحسن في كتب التاريخ الوطني السوداني، بحسبانهم أبطالا ناهضوا الاستعمار.
كان التوظيف في خدمة حكومة السودان (الإنجليزي – المصري) يوفر للمتعلمين السودانيين الشماليين سبلاً لكسب العيش. وكانت رواتبهم في تلك الوظائف منتظمة وقابلة للزيادة مع أمكانية الحصول على ترقيات منخفضة المستوى. وكان بمقدور خريج كلية غردون الذي يعمل بخدمة الحكومة أن يبتني لنفسه منزلاً (مثاليا، في الخرطوم الكبرى)، وأن يعول أسرته في يسر ورفاهية معقولة. “كانت الحياة سهلة” أو هكذا بدت لمن تخرج في عام 1995م، (بحسب ما أدلى به أمين التوم ساتي في مقابلة مع المؤلفة. المترجم)، وهو يسترجع مسيرة شبابه حين كان يعمل مثمناً جمركياً لفترة زادت على نصف قرن من الزمان. وكانت الوظائف الحكومية تغطي الحاجات الأساسية، إلا أن الكثير من المتعلمين السودانيين الشماليين كانت لديهم العديد من الأسباب للشعور بخيبة الأمل. فقد كانوا حساسين تجاه رتبهم المتدنية، وإقصائهم من عملية صنع السياسات وإصدار القرارات، ومن إطاعتهم لرؤسائهم البريطانيين، خاصة من كانوا أدنى منهم سناً وأقل خبرةً. ورغم أنه كانت لديهم فرصاً للترقي، إلا أن حركتهم لطبقة أعلى كانت جد محدودة؛ وبالنسبة للكتبة والطابعين على الآلة الكاتبة كان العمل مملا وبالغ الرتابة. وفوق كل هذا وذاك، كان الكثير منهم يشعرون بأنهم يعاملون بطريقة تبدو ظاهريا طريقةً لطيفة أو مفيدة، ولكنها كانت تشعرهم بالدونية. وأحيانا تؤكد المصادر البريطانية، على سبيل المثال، على تدني وضع الموظفين من السودانيين المتعلمين الشماليين (الذين تكون أعمارهم في بداية الثلاثينات) بالإشارة إليهم بكلمة “أولاد”، بينما تشير إلى البريطانيين الذين تخرجوا لتوهم في الجامعة بكلمة “رجال”.
3.وكان البريطانيون يظهرون، من ناحية شكلية وظاهرية، احتراما للمتعلم السوداني الشمالي عند التعامل معه، ويخاطبونه باللقب العثماني – العربي “أفندي”. وهذا اللقب نظير لكلمة السيد (Mister)، ويمثل اعترافا بكسب “الأفندية” في المجالين التعليمي والمهني، بحسبانهم من الرجال العصريين الذين يعملون في خدمة الحكومة. (وكان هناك استثناء لمن درسوا العلوم الشرعية، مثل القضاة الشرعيين، الذين كانوا يُطلق عليهم لقب “شيوخ”، وكان لباسهم مختلف أيضا عن الأفندية، إذ أنهم يرتدون القفاطين والعمائم، وليس البدل الإفرنجية وربطات العنق، التي تميز مظهر “الأفندية” الخارجي وتشير إلى وضعهم). أما فيما وراء الناحية الشكلية الظاهرية، فقد كانت كلمة “الأفندي” عند الرجل البريطاني شيئا أسوأ بكثير: فالأفندي بالنسبة له رجل فائق الطموح (بأكثر مما ينبغي لأمثاله. المترجم)، ودائم الشِكاية، وهو أيضاً سياسي عجول متهور محتمل. وتسلل الازدراء للأفندية إلى أسفل السلم الاجتماعي البريطاني. وهو أمر أحس به حتى المبشرين المسيحيين البريطانيين، مما دعاهم لتنبيه وتحذير زملائهم القادمين حديثا للسودان وهم يتعلمون اللغة العربية، من “استخدام لغة المكاتب العربية الغريبة (هكذا! المترجم) التي يستخدمها، للأسف، الكثير من الأفندية”، وتشجيعهم على استخدام “اللغة العربية الحية والمعبرة والغنية التي يستخدمها عوام الناس (عوضاً عن لغة الأفندية)”. وبالنظر إلى الدلالات البغيضة التي يحملها مصطلح “أفندي”، إلى جانب ارتباطاته المهينة بالوظيفة البالغة الصغر، فلم يكن من المستغرب أن يتخلى الناطقون باللغة العربية عن ذلك اللقب بعد رحيل المستعمر، وأن يستخدموا لقب “السيد” الأكثر حيادية. وتعود جذور الازدراء البريطاني للأفندية إلى القَلْقَلة والضيق (unease) الذي لازمهم طوال سنواتهم بالبلاد.
وكان “الأفندية” (بنوعيهما، في مصر أو شمال السودان)، وكذلك السادة البابوس (Babus) في الهند، يثيرون أعصاب البريطانيين لأسباب عديدة منها أنهم كانوا يلحون في الطلب دوماً من أجل تسنم وظائف أكثر مسؤولية، وصاروا لاحقاً يطالبون بالوظائف التي يشغلها البريطانيون أنفسهم. كما أنهم كانوا يرتدون نفس ملابس الأوروبيين (باستثناء الطرابيش على الرؤوس)، وهذا مما من شأنه أن يقوض استثنائية المظهر البريطاني. والأسوأ من ذلك، أنه كان بإمكانهم التحدث بلغة الليبرالية البريطانية؛ فقد لقنهم ما تلقوه من تعليم حديث مفاهيم سياسية أوروبية مثل الاستقلال والوطنية / القومية، والتي صار بإمكانهم استخدامها لمعارضة الوجود الاستعماري. وكان البريطانيون يدركون مثل تلك الأخطار منذ أن غزوا مصر عام 1882م، حين كان “الأفندية” في مصر هم من قدموا الحجج ضدهم عند مناداتهم بإحياء الوطنية والدعوة للاستقلال. وكان أحد البريطانيين في قسم المخابرات بمصر (هو غيلبرت كلايتن، 1875 – 1925م) قد ذكر في رسالة له لونجت باشا في 10 مارس عام 1910م بأنها مسألة وقت، ليس إلا، قبل أن يقوم الجيل الجديد من السودانيين الشماليين “بتشرب الأفكار البغيضة في المدرسة” من خلال الوقوع تحت تأثير المعلمين المصريين الذين كانوا هم أنفسهم “ملوثين” بالوطنية.
لقد كان الازدراء بين البريطانيين والأفندية متبادلاً. فبينما كان البريطانيون لا يثقون في “الافندية” ويسخرون منهم لتشبههم بالغربيين ولطموحاتهم الاجتماعية (المفرطة)، كان “الأفندية”، بذات القدر، يكنون للبريطانيين أشد مشاعر الاستياء والحنق بسبب إحباط البريطانيين لآمالهم، واستنكارهم لجهودهم في أن يكونوا أناسا عصريين. ومرة أخرى، كانت الهموم والمخاوف المهنية هي من أهم الأسباب. وكانت من أكبر دواعي الشكوى المتكررة عند المتعلمين السودانيين الشماليين هي أن تعليمهم لم يهيئهم سوى لشغل أدنى الوظائف (ولم يكن تعليمهم من أجل منحهم “معرفة من أجل المعرفة”)، وأن وظائفهم لم تكن تتيح لهم فرص الترقي الاجتماعي والمهني بصورة كافية، وأن آمالهم في التخصص وفي تطوير مهاراتهم قد كُبِتَتْ. وكان البريطانيون – بالفعل – قد قدموا لهم تعليماً محدوداً، وحرموهم من التقدم. وكتب أحد السودانيين (وهو خضر حمد. المترجم) متحسراً: “كان التعليم هو آخر المطاف بالنسبة لنا”. وكان افتقاد الصلات الاجتماعية غير الرسمية بين المسؤولين البريطانيين والموظفين السودانيين الشماليين قد وسع من هوة الارتياب وعدم الثقة. فقد كان البريطانيون العاملون في الخرطوم والمدن الكبيرة الأخرى يقضون أوقات فراغهم في غشيان الأندية الخاصة بهم، وحضور حفلات الشاي، وحفلات العشاء، والمباريات الرياضية. وكان حضور تلك النشاطات يتم بحسب وضع المسؤول البريطاني الاجتماعي والوظيفي. وفي النصف الأول من فترة الاستعمار، في مدينة مثل بورتسودان، كانت علاقة الباشمفتش الإنجليزي مع محاسب المنطقة أو الكاتب لا تزيد عن الصلة المهنية بالمكتب أثناء يوم العمل. أما في النصف الأخير من فترة الاستعمار، وعندما كان بعض المسؤولين البريطانيين يصطحبون زوجاتهم معهم للسودان، كان بعض أولئك المسؤولين يَدْعُونَ في بعض الأحايين زملائهم السودانيين الشماليين إلى بيوتهم. غير أن مثل تلك المجهودات لتقليل الفجوة الثقافية كانت من الأمور المكبوتة.
¬¬¬—— ——- ——
6.كان المتعلمون السودانيون الشماليون يتعاملون، في غالب الأحوال، مع إحباطات عملهم في خدمة الحكومة الاستعمارية، أو ينتقدون ظلمها بطرق صغيرة وثانوية. وتميز نهجهم في العمل معهم على التعايش الحذر، وليس العداء أو المقاومة النشطة. ومِنْ ثَمَّ، فإن البعض ظلوا يتَلَكّأَون عن إنجاز أعمالهم، في حين بقي البعض الآخر يؤكدون ببساطة على فرديتهم من خلال ملابسهم أو أسلوب كلامهم. واستخدم الكثيرون منهم الأدب للتعبير عن مشاعرهم، والتنفيس عن النفس والفضفضة عن طريق ترميز المشاعر المعادية لبريطانيا أو التقارب مع مصر في قصائد عربية يَلْقَوْنَها أمام أصدقائهم ويتبادلونها فيما بينهم. وكان كثير من المتعلمين السودانيين الشماليين يرغبون في تخيلاتهم في تمزيق النظام، غير أن تحكيم العقل ومنطق الأشياء أبقاهم تحت السيطرة. فقد كان أولئك المتعلمين السودانيين الشماليين يعتمدون على وظائفهم الحكومية في كسب عيشهم وإعالة أطفالهم وأسرهم الممتدة. وإضافة لذلك، فقد كان كثير من أولئك الموظفين يفخرون بوظائفهم، ولا يرغبون في تخريب وظائفهم بأيديهم، وقد بلغوا ما بلغوه من وظائف بعد تنافس شديد. وتفسر تلك التوترات الداخلية عدم وجود تخريب مستمر واسع النطاق في كل مناطق السودان الإنجليزي – المصري.
… غير أنه كان هناك أيضاً الكثير من الاستياء من الوظيفة الحكومية، مما يؤكد أهمية المظالم المهنية في نشوء الوطنية / القومية الباكرة. وبالفعل ورد في وثائق المخابرات البريطانية ما يؤكد الرأي الذي يذهب إلى أن الكثيرين من المشاركين في انتفاضات 1924م كانوا من الذين كانت لديهم مظالم في وظائفهم، وكانوا من الساخطين على الحكومة. ووردت في تلك التقارير أسماء مثل علي أحمد صالح، الذي لم يعد يعمل بعد فقدانه لوظيفته في جمع الضرائب في البلدية، ثم منضداً للحروف المطبعية في مطبعة تجارية. وكان الرجل قد تورط في بعض قضايا فساد يسيرة. وشارك الرجل في انتفاضات 1924م، ثم تحول ليعمل مخبراً للسلطات، ربما بعد اغرائه بعرض مالي، لا سيما وقد كان يعول أسرة كبيرة ممتدة (وكان هو شاهد الاتهام الرئيس في محاكمات 1924م، وقيل إنه صار – بعد تلك المحاكمات – يتجول في شوارع الخرطوم حاملاً مسدساً منحه له البريطانيون حماية له بعد أن تم استهدافه فيما بعد. المترجم). وقبل سنوات من ذلك كان ذات الرجل (علي أحمد صالح) قد عمل جنديا في فيلق الهجانة بجبال النوبة، وتم تسريحه من العسكرية بعد أن تعرض لإصابة أعاقته عن حمل بندقيته. وكان من ضمن المشاركين في انتفاضات 1924م بعض الذين كانوا يعملون في وظيفة “وكيل مأمور” وتم فصلهم من العمل (مثل نور الدين فرج)، الذي تم تسريحه من وظيفته العسكرية لسبب طبي. (كان قد تحول لشيخ صوفي وأصيب – كما قيل – بـ “مالَنخُوليَا دينية religious melancholy”، حسب شهادة علي أحمد صالح في يوم 24 سبتمبر 1924م). وكان هناك أيضا بعض الموظفين السابقين في مصلحة البريد، مثل كامل حسن يوسف (المولد – نصف مصري) وكان عاطلا عن العمل، وسعى ليغير وظيفته السابقة ويلتحق بعالم الإدارة كـ “وكيل مأمور”. غير أن ذلك لم يتحقق له لفشله في اجتياز دورة تدريب وكلاء المآمير. ووردت قصص مشابهة في بعض قواميس الشخصيات العربية. فقد ذُكر في أحد تلك القواميس ما يفيد بأن عضوية جمعية “اللواء الأبيض” ارتبطت ارتباطا وثيقا بمشاعر الخذلان وخيبة الأمل عند إبراهيم عبد الرازق (1896 – 1975م)، الذي هو سليل أسرة مشهورة، إلا أنه أخفق مرتين في الحصول على فرصتين كان يؤمل أن ينال إحداهما. ففي البدء فشل في الالتحاق بكلية غردون، حيث كان يؤمل في أن يدرس قانون الشريعة ويتخرج قاضيا شرعيا. وصار لاحقا مدرسا في “كُتاب”، وعندما تقدم ليلتحق بسلك الإدارة أخفق مرة أخرى. وكان إبراهيم عبد الرازق، كغيره من مؤيدي انتفاضات 1924م المخلصين، يقاسي جروح مرارات مهنية.
تقدم ملفات العمل الشخصية للموظفين السودانيين (المليئة بالالتماسات المُستعطِفة للترقية) نوافذ أخرى لمعرفة الإحباطات المهنية التي ملكت على المتعلمين السودانيين الشماليين أنفسهم، ودفعتهم إلى تطوير أيديولوجيات مناهضة للاستعمار. وتبرز هنا حالة عرفات محمد عبد الله (1898-1936م)، الذي غدا لاحقاً شخصية مشهورة لتأسيسه وتحريره لمجلة الفجر الأدبية (التي صدرت بين عامي 1934و1937م).
وعلى الرغم من أن عرفات محمد عبد الله كان واحدا من أنبغ الطلاب الذين تخرجوا في كلية غردون طُرًّا، وتلقى تعليمه على نفقة الحكومة لندرة وجود أمثاله من النوابغ، إلا أنه لم يُقْبَل في أي وظيفة حكومية بسبب فشله في اجتياز الفحص الطبي الالزامي. (وكانت الفحوص الطبية تُجْرَى على المتقدمين للوظائف الحكومية منذ عام 1910م. وأظهر تقرير طبي صدر عام 1910م أن ما لا يقل عن 13% من طلاب الكلية كانوا مصابين بداء المنشقات (البلهارسيا)، وأن نحو 20% منهم كانوا مصابين بمرض الرمد الحبيبي أو الحثار (التراكوما)، الشيء الذي أضعف حاسة البصر عندهم. وبذا صارت الإعاقة الجسدية عائقا أمام صعود عرفات في سلم الترقي الاجتماعي. ولم يشفع له حتى توسط بعض كبار المسؤولين البريطانيين للحصول على وظيفة حكومية لمن في مثل مواهبه. غير أنه وُفِقَ أخيراً في الحصول على وظيفة صغيرة في مصلحة البريد والبرق (البوستة والتلغراف) حيث عمل بها كاتبا clerk. وكانت تلك من الوظائف “غير المصنفة unclassified” وتُعد وظائف غير ثابتة أو دائمة، ولا يستحق من يشغلها أن يحصل على معاش تقاعدي. وعلى عكس ذلك، كان من يُعين كاتباً – في أول السلم الوظيفي – ويجيد اللغة الإنجليزية يُعين في وظيفة “مصنفة” وهذه وظيفة لها ميزات عديدة ومستقبل أفضل من تلك الوظائف “غير المصنفة”. وكان مما أحزن أحد المسؤولين البريطانيين (واسمه ستانهوب سيمسونS.R. Simpson ) أن يرى عرفات وهو يعمل في تلك الوظيفة التي لا تحتاج لمهارة مثل مهارة عرفات في اللغة الإنجليزية، ولا تتطلب من شاغلها إلا أقل القليل من المبادرة والذكاء.
وظل عرفات يواصل في كتابة خطابات بلغة إنجليزية سليمة ومنمقة تستنجد المسؤولين منحه وظيفةً أفضل من وظيفته في مصلحة البريد والبرق. غير أن السكرتير المالي لحكومة السودان (وهو أكبر مسؤول عن أمور التعينات والترقيات والرواتب والعلاوات وإصدار تصاريح السفر المجانية الخ) رفض التماسات عرفات لترقيته أو نقله لمصلحة أخرى، متعللاً بإعاقته الجسدية. وأخيراً، فر عرفات لمصر عند اندلاع انتفاضات عام 1924م في بعض مدن السودان نتيجة لتزايد حالات الاستياء والسخط العام عند السودانيين الشماليين من الاستعمار البريطاني. وفي مصر شرع عرفات في شَحْذ قلمه للهجوم على الاستعمار البريطاني عبر الصحافة الوطنية المصرية. وبحسب ما أورده محجوب باشري في كتابه “رواد الفكر السوداني” نشر عرفات بعض المقالات لفترة قصيرة في الصحافة المصرية، ثم تركها ليعمل مترجما للغة الإنجليزية في شركة بريطانية للبترول في سيناء، وعمل لاحقا في شركة جلاتلي – هانكي في مدينة جدة. وعاد بعد ذلك ليصدر مجلة “الفجر في عام 1934م. وكانت السلطات البريطانية بالسودان قد أعلنت رسميا عن تغيبه عن العمل في 4 سبتمبر 1924م.
ما الذي دفع عرفات ليقوم بما قام به في 1924م؟ لقد كان الإحباط المتصاعد الذي يظهر في ملفه الشخصي – عند كتابته رسائل للمسؤولين البريطانيين يتوسل فيها الحصول على ترقية – يبدو أنه ساهم في اتخاذه لقراراته السياسية. كم هو عدد “الأفندية” في شمال السودان مثل عرفات، الذين دفعوا للعمل في خدمة الحكومة رغم خيبة الأمل المريرة التي جابهوها في العمل؟
وأدت خيبات الأمل والإحباطات دوراً في قيام انتفاضات 1924م، رغم أن الفجوة بين الأجيال كانت لها أيضا دور كذلك. لقد توترت العلاقات بين شبان الطبقة المثقفة ليس فقط مع البريطانيين، بل مع آبائهم أيضا، حيث تصادمت آراءهم وتوقعاتهم المتغيرة مع كلٍ من السلطتين الاستعمارية والأبوية. وإلا فكيف يمكن لنا إعادة تفسير تقارير المخابرات التي أشارت إلى أنه بعد الحكم على مجموعة من الشباب وجلدهم لمشاركتهم في بعض أعمال الشغب الصغيرة في أم درمان، خاطب بعض آباء أولئك الشبان السلطات وطلبوا منهم زيادة عدد الجلدات التي حُكم بها على أولادهم؟ وكان المشاركون في أحداث عام 1924 من مختلف العائلات، ولم تفصل تلك الأحداث بين الأب والابن فحسب، بل فصلت أيضا الأخ عن أخيه. فعلى سبيل المثال، كان أحد أبناء الخليفة عبد الله قد سُجِنَ عام 1924م بعد قيامه بمحاولة جريئة لإيصال عريضة الولاء من “جمعية اللواء الأبيض” لمصر، بينما التزم أخوه الصمت، واحتفظ بعلاقة طيبة مع المسؤولين البريطانيين. ومن الجدير بالذكر أن أخاه الثوري محمد المهدي الخليفة عبد الله كان يعمل في ذلك الوقت موظفاً في الحكومة الاستعمارية (مترجما من اللغة الإنجليزية للعربية)، بينما كان شقيقه، محمد السيد الخليفة عبد الله، الذي لا علاقة له بالسياسة، يعمل مزارعاً مستقلا، وأثبت تقواه وبره بوالده برعايته لقبره في “أم دبيكرات”. وكان الاختلاف في مواقفهم يتبع ذلك الخط الذي يفصل بين “الأفندي” و”الشيخ”.
كانت “جمعية الإتحاد السوداني” جمعيةً سرية تكونت في صالون أدبي بأم درمان أقامته مغنية (وربما مُومِسٌ) كانت تسمي نفسها “فوز”. (قيل إن اسمها الحقيقي هو الشول بت حلوة. وذكرت المؤلفة أن تلك الفترة شهدت ظهور عددٍ من “الصالونات الأدبية” التي كانت تديرها نسوة، واعتمدت في ذلك على كتاب “سودانيات في صالونات الأدب” لمؤلفه محمد صالح يعقوب. المترجم). وكان عدد من خريجي كلية غردون يتجمعون بعد انتهاء وَقْت العمل في صالون “فوز”، ومعهم المغني الشهير وعازف العود خليل فرح (حوالي عام 1892 – 1932م)، وهو أحد خريجي الورش الفنية بكلية غردون. وكان خليل فرح يعمل ميكانيكا في مصلحة البوستة والتلغراف، حيث كان كثيرا ما يُعاقب بسبب تأخره عن الحضور في المواعيد الرسمية المقررة. أما بالليل، فقد ذاع صيته مؤلفاً ومؤدياً للأغاني التي تؤكد على الصلات بين السودان ومصر، وتنمي من روح وحدة وادي النيل. واشتهر خليل فرح بالأغاني التي جمعت بين اللغة الأدبية العربية الفصيحة وبين اللغة العامية، مما جعل أغانيه متاحة ومحبوبة لعامة المستمعين. ولا تزال أغاني خليل فرح محبوبة إلى يومنا هذا. وكان مُرْتَادو صالون “فوز” المداومين على غشيان دارها يشكلون غالب أعضاء “جمعية الإتحاد السوداني”، وكانوا يجتمعون في صالونها من أجل الغناء والامتاع والمؤانسة والشرب، ولكنهم كانوا أيضا يَتطْرُقُونَ لنقاشات سياسية جادة. وكانوا في بعض اجتماعاتهم تلك يكتبون إعلانات ومنشورات تحريضية (ضد الاستعمار) ويقومون عند الغَسَق بتثبيتها على الأعمدة والجدران. وجاء في تقرير للمخابرات صدر في فبراير من عام 1922م تقييم لتلك الملصقات إلى أنه “بقدر ما يمكن التأكد منه، فإن تلك الملصقات والمطبوعات التي ظهرت بعد عام 1919م، ربما تكون قد جُلِبَتْ من مصر كي توزع في السودان”. غير أن ذلك التقييم لم يكن ينطبق على ما كان يكتبه أعضاء “جمعية الإتحاد السوداني”. وبعد سنوات ذكر أحد قدامى أعضاء تلك الجمعية أنهم كانوا يستخدمون آلة يدوية بدائية (baluza) كانوا يجدونها في مكاتبهم بالخرطوم لطباعة منشوراتهم محليا. وكان المهندس والضابط عبد الله خليل (1892 – 1971م)، وهو أحد خريجي كلية غردون، وصار لاحقا رئيسا للوزراء في السودان المستقل، مسؤولاُ عن طباعة تلك المنشورات المعادية للاستعمار، وتوزيعها على خلايا الجمعيات السرية الأخرى كي يلصقوها على الأعمدة والجدران في مختلف أحياء المدينة، أو يبعثوا بها بالبريد.
كان محمد عباس أبو الريش مؤسس ورئيس تحرير مجلة “النهضة” (1908 – 1935م) يُحَضِّرُ سراً لإصدار مجلته مكتوبةً بخط اليد، عندما كشفت السلطات سره، وطلبت منه إصدار مجلته بصورة علنية، ووعدته بالموافقة على طلب يتقدم به لإصدار تلك المجلة. غير أن ذلك لم يصدق على صحيفة أخرى كانت يكتبها بخط اليد طالب المعهد العلمي بأم درمان محمد عبد الوهاب القاضي (1911 – 1940م) وتصدر بعنوان “الأصيل”، وكانت تحتوي على مقالات تدور حول الإصلاح الإسلامي والقيم الفاضلة. وبعد مراقبة وتدقيق فيما ينشره ذلك الطالب المعهدي، طلبت السلطات من شيخ المعهد أن يأمره بإيقاف إصدار تلك الصحيفة، واستجاب محمد القاضي للأمر. وهاتان الحالتان تشيران إلى أن المتعلمين السودانيين الشماليين واصلوا في ممارسة نشاطات سرية وشبه سرية – وغير معارضة للاستعمار أيضاً – بقيامهم بكتابة أوراق سرية في أعقاب أحداث 1924م.
وكان “الأفندية” من السودانيين الشماليين يمثلون غالبية من كانوا يشاركون في كتابة المقالات بالمجلات والجرائد التي تصدر باللغة العربية، بما في ذلك الصحيفة التي وافقت الحكومة على إصدارها منذ عام 1919م، وكان اسمها “حضارة السودان”، ولاحقا مجلتي “النهضة” و”الفجر”. غير أن معظم أولئك الكتاب كانوا ينشرون مقالاتهم وقصائدهم بأسماء مستعارة، وذلك لتفادي المساءلة القانونية، إذ أن قوانين الحكومة كانت تمنع العاملين بها من نشر أي شيء قبل الحصول أولاً على موافقة مكتب السكرتير الإداري. وغني عن القول بأن السلطات كانت علي علم بالأسماء الحقيقية للذين يكتبون بأسماء مستعارة – فبحسب قانون الصحافة الصادر عام 1930م، كان للسلطات الحق في معرفة هويات جميع من يكتبون في الصحف والمجلات. وقبل عام 1930م، كانت السلطات تحصل على مثل تلك المعلومات بالإكراه. وإذا ظل هؤلاء الكتاب ينشرون أعمالهم بأسماء مستعارة أو بالحروف الأولى من أسمائهم، فعادة ما تتركهم السلطات وشأنهم. فعلى سبيل المثال ظل خضر حمد (1908 – 1970م)، الضارب على آلة الطباعة (typist) في مكتب السكرتير المالي لحكومة السودان وأحد كبار قادة الحركة الوطنية والسياسة في بداية عهد الاستقلال يكتب في الصحف والمجلات باسم مستعار هو “طبجي”؛ بينما كان إبراهيم حسن محلاوي (1898 – 1977م)، الذي كان يعمل بالسكة حديد في أتبرا، وصار منظما نقابيا، يستخدم الأحرف الأولى من اسمه الكامل (ا.ح.م). ولم تكن تلك الأسماء المستعارة أو الاختصارات مجهولة عند أغلب القراء. ولكن في بعض الأحيان، كان الموظفون يواجهون مشكلة عند نشرهم لكتاباتهم في مواضيع حساسة بأسمائهم الحقيقية كاملة، من دون إذن. وكان من هؤلاء يحي الفضلي (1911-1974م) المحاسب في مصلحة المالية، وصار بعد ذلك من السياسيين الوطنيين. تم استدعاء يحي الفضلي مرتين أمام مجلس المحاسبة والانضباط، لذلك السبب. وكانت المرة الأولى في عام 1936م، عندما نشر مقالاً في جريدة “النيل” لم يكن قد تم اعتماده مسبقا. وفي تلك المرة تم توبيخه رسمياً. وفي المرة الثانية، في عام 1937م، تم خصم أجر سبعة أيام من راتبه، لنشره فيما يبدو مقالاً في مجلة “الفجر” يتناول مشكلة الطائفية السياسية.
وفي سياق مماثل، اُسْتُدْعِيَ الشاعر والناقد الأدبي ووكيل المأمور حمزة الملك طمبل (1897 – 1951م) لمجلس المحاسبة والانضباط بعد أن قام في عام 1931م بنشر مجموعة قصائد شعرية عنوانها ” ديوان الطبيعة”، دون الحصول على موافقة السلطات على نشره. ولم يكن للحكومة أن تلحظ “عيباً” في ذلك الديوان إلا بعد أن قام بعض السودانيين الشماليين من زملاء حمزة طمبل السابقين في الدويم بتقديم شكوى للمسؤولين مفادها أن إحدى قصائد الرجل كانت تتضمن إساءات لهم. بينما كان المؤرخ والشاعر والمحاسب محمد عبد الرحيم (1878 – 1966م) أكثر حذراً. فقد أرسل لمسؤول المخابرات طلبا في يوم 7.7. 1931م يسعى فيه للحصول على الموافقة على نشر كتابه الأدبي المعنون (نفثات اليراع في الأدب والتاريخ والاجتماع). وتحصل في اليوم التالي على تصريح بالنشر. وبالفعل تم نشر الكتاب في عام 1936م، ووضع المؤلف صورة من خطاب الموافقة الصادر من مكتب السكرتير الإداري في مقدمة الكتاب من ضمن ما كتبه أصدقائه في مدح الكتاب.
وبعبارة أخرى، كان أعضاء “جمعية الإتحاد السوداني”، ومن بعدهم أعضاء “جمعية اللواء الأبيض” قد وجدوا الوسيلة التي يطبعون بها منشوراتهم التحريضية ضد الحكومة في مكاتب الحكومة نفسها. ويصح هذا القول أيضا على عدد كبير من المسؤولين السودانيين، الذين كانوا يستخدمون التقنيات المتوفرة في أماكن عملهم لمناهضة النظام، خاصة قبيل وقوع أحداث 1924م. وبذا كان التداخل بين الوظيفتين المهنية والسياسية كبيراً. وكان القاء القصائد الحماسية المحرضة في المناسبات العامة أمراً شائعا في سنوات 1919 – 1924م. غير أن بعض الشعراء واصلوا في الأعوام التي تلت انتفاضات 1924م في تحدي الحكومة وإلقاء مثل تلك القصائد الملتهبة. وبحسب ما أورده ميرغني حسن علي في كتابه (شخصيات عامة من الموردة) فقد أمر النظام في عام 1938م بنقل مهندس المساحة علي نور (1903 – 1972م) من ود مدني إلى الدامر من أجل منعه من إلقاء قصائده الوطنية في مهرجان ود مدني الثقافي. وسبق لعلي نور أن مثَلَ أمام مجلس المحاسبة والانضباط بسبب نشره لقصائد وطنية. وأرسل علي نور للقائمين على مهرجان ود مدني الثقافي برقية من سطرين يفسر لهم فيهما سبب غيابه عن المشاركة: ” اِقْتَضَانى مجلس التأديب أن أقوم بواجبي كأديب”. وكان إرسال برقيات مكونة من أبيات شعرية من العادات الشائعة عند الشعراء السودانيين الشماليين، خاصة الذين تم نقلهم للعمل الحكومي في مناطق السودان المترامية. (ضربت المؤلفة هنا بالإداري الشاعر توفيق صالح جبريل الذي كان يراسل أصحابه مثل حسن نجيلة وإبراهيم بدري وغيرهما ببرقيات تتضمن أبيات شعرية. المترجم).
12.كان توفيق صالح جبريل (1897 – 1966م) عضوا في “جمعية الإتحاد السوداني” و”جمعية اللواء الأبيض” عندما وقعت انتفاضات 1924م. وكان توفيق مثالا نموذجيا لموظف الحكومة الساخط. وظل يعمل وكيلاً للمأمور من عام 1923م حتى تقاعد في عام 1952م. وعلى غير العادة، لم يحصل الرجل على ترقية لرتبة المأمور على الرغم من طول خدمته في الحكومة. وقد يقال إن توفيق صالح جبريل لم يُرْقَ لرؤسائه في العمل، ولم يكن محبوباً أو على وفاق معهم– وأنه شديد العداوة للاستعمار. والحقيقة ربما هي إن مزاجه لم يكن متوافقا قط مع تلك الوظيفة. وعلى تعاقب السنوات، ظل رؤساؤه البريطانيون المتعاقبون يكتبون تعليقات سالبة في تقاريرهم السنوية عنه مثل: “… ليس ذكياً، ولا يسارع لتحمل المسؤولية” (1925م)؛ “… هو مهمل جداً” (1926)؛ “هو ليس مناسباً ليكون مسؤولا عن مركز … فهو شديد الإهمال، وسجل عمله في مجال مكافحة الجريمة وتطبيق القانون والنظام القانوني والإصلاحيات لم يكن حسناً؛ … يفتقر للشخصية، ولا يتمتع بالجرأة الكافية!” (1927م)؛ “أدركت أن فيه إخفاقا ِبنيَوِيّا تَكوِينِيا، ليس بسبب أي رذيلة أو كسل متعمد، ولكن ….” (1928م)؛ “هو رجل بائِخ يفتقر إلى المرح والتنوع في الاهتمامات، وإلى الشخصية، وليس له أي مبادرات مفيدة” (1933م)؛ وَهَلُمَّ جَرّاً. غير أنه كان هناك أيضا بعض المسؤولين البريطانيين الذي أشادوا بتوفيق صالح جبريل عبر سنوات خدمته الطويلة، وذلك لخصال حميدة عديدة منها لباقته وموثوقيته وأخلاقه المهذبة (فهو “جنتلمان” بحق). بل إن بعض رؤسائه البريطانيين رشحوه للترقية لمرتبة مأمور. غير أن ذلك لم يتحقق قط. ومع ذلك، ربما كان “عقله التأملي الشعري”، كما كتب أحد المسؤولين في عام 1948م، هو ما جعله رجلاً طيباً حَنُونا، ولكنه لم يكن فعالاً في وظيفة وكيل مأمور. وقبل فترة قصيرة من تقاعد توفيق كتب عنه مسؤول بريطاني آخر عام 1950م التالي: “ما زال أمر تعيين توفيق أفندي جبريل في وظيفة وكيل مأمور في الأساس، وبقائه في ذلك المنصب لغزاً بالنسبة لي. فبغض النظر عن كونه رجلاً لطيفا فيما يبدو، لا أستطيع تخيل وجود أي شخص أقل صلاحية منه لذلك المنصب. كان عليه أن يعمل أميناُ لمتحف، أو مفتش بريد في مكتب صغير هادئ”. أما في الدوائر الأدبية، فقد كان توفيق صالح جبريل، كما وصفه محمد عثمان ياسين في كتابه “الشاعر توفيق صالح جبريل: ذكريات وأحاديث” شاعرا بارعاً يحظى بكامل الاحترام. ولكن، لسبب ما، بدت شخصيته باهتةً عند رؤسائه. وربما كان كل ما في الأمر، كما توقع أحد المسؤولين البريطانيين (في كسلا) عام 1938، أن “أسلوبه الرقيق المتواضع وإحجامه اللطيف عن دفع نفسه إلى الأمام قد أدى في الماضي إلى جعل المسؤولين يقللون من ذكائه ويستصغرون قدرته”. وعلى كل حال، تفاعل توفيق مع تعاسته المهنية بعدة طرق، كان أهمها تأليف قصائد شعرية تهاجم الاستعمار. واحتفظ توفيق بتلك القصائد لنفسه، ولم تُنْشَر الكثير من قصائده إلا بعد وفاته. وتتضح تجارب توفيق من عناوين بعض قصائده مثل قصيدة “من ذكريات الاستعمار البغيض”. وخط توفيق تعليقا على هامش الورقة التي كتب فيها تلك القصيدة يعبر فيه عن ألمه مما حاق به جاء فيه: “عندما فصلني باشمفتش المنطقة السيد آرثر (في عام 1953م) … لم يكلف أحدهم نفسه بتوديعي في يوم مغادرتي باستثناء أصدقائي المخلصين”
وكان توفيق وأصدقاؤه يشعرون بالارتياح والرضا لإدراكهم أن انتفاضات 1924م كانت قد هزت النظام، وأنهم قد عملوا ما في وسعهم على تخريبه بطرق أخرى متنوعة. وكتب حسن نجيلة، صديق توفيق الصدوق، في كتابة “معالم من المجتمع السوداني” قصة عن توفيق عندما كان يعمل نائبا للمأمور في أم روابة بكردفان. وكانت المناسبة هي الاحتفال بعيد الملك. وحدثت القصة التي سجلها حسن نجيلة عام 1929م، حين كان توفيق صالح جبريل هو وكيل المأمور الذي أسندت إليه مهمة تزيين المدينة الصغيرة بالأعلام واللافتات. وفي الليلة التي سبقت صباح يوم الاحتفال تسلل توفيق ومعه صديقه الباشكاتب عابدين عبد الرؤوف الخانجي في جنح الظلام إلى ميدان المدينة الرئيس، ومزقا الأعلام البريطانية ونثرا قطعها مع الريح. ولما جاء الباشمفتش البريطاني للميدان مع شروق شمس يوم الاحتفال شاهد ما فُعِلَ بالأعلام واللافتات فأحمر وجهه من شدة الغضب، وثار وأزبد وأرعد. وأرسل توفيق، الذي كان جاء للميدان قبل رئيسه البريطاني رجال الشرطة للبحث عمن قاموا تلك الفعلة والقاء القبض عليهم. وبالطبع لم يتمكنوا من العثور على “الجناة”! وكتب توفيق في هامش الورقة التي كتب فيها قصيدة بتلك المناسبة: “كان “الحاكم” في ذلك الوقت هو متوحّش المنطقة آرم استرونق. لكم ذقت على يديه صنوفاً من التضييق والكَرْب والاستبداد!”.
وكانت هناك في مدينة ود مدني حالة مشابهة أخرى من حالات “التخريب الداخلي” في حوالي نهايات الثلاثينيات أو بداية الأربعينيات. وحاولت مخابرات النظام الاستعماري الكشف عن مصدر تلك الحالة التي تضمنت توزيع منشورات– دون أخذ إذن من السلطات – باسم مؤتمر الخريجين، والكشف عن المتورطين فيها، غير أنها أخفقت في مسعاها. وكان محمود عبد العظيم الشاب المتدرب الزراعي بالمدينة قد ذكر بأن مصدر تلك المنشورات لم يكن هو إلا مصطفى سعيد، مأمور سجن ود مدني، وهو أحد الشخصيات المهمة والقوية بالمدينة. وكانت مجموعة قليلة من شباب السودانيين الشماليين قد صاغوا تلك المنشورات وذهبوا بها لزيارة مصطفى سعيد في منزله الملاصق للسجن. وسلم ذلك المأمور القوي البنية تلك الأوراق إلى أحد المساجين (وكان موظفا حكوميا سابقا تمت إدانته بالابتزاز) لطباعتها، وكان رجلا مجيدا للطباعة. وقام المأمور بنسخ آلاف النسخ من تلك المطبوعة بآلة نسخ الرسائل mimeograph التي كانت في سجن واد مدني.
وعلق محمود عبد العظيم على ذلك بالقول: “لقد كانت فكرة طبع تلك المنشورات في مبنى السجن من بنات أفكار مأمور السجن نفسه. والسبب هو أن السجن كان المكان الوحيد الذي لم يكن ليخطر ببال رجال الأمن أن يشتبهوا فيه، وكان مصطفى سعيد نفسه هو آخر شخص يمكن الشك في مشاركته في مثل ذلك النوع من النشاط. وكانت حالة المأمور مصطفى سعيد تمثل نوعاً من المقاومة التي تتم أثناء العمل، وربما كانت مثل تلك الحالات أكثر شيوعاً مما يعلمه المسؤولون البريطانيون.
وخلاصة القول، هنالك أمران يتعلقان بعلاقة المتعلم السوداني الشمالي مع النظام الاستعماري. الأمر الأول هو أنه بغض النظر عن مدى عدم ارتياح المسؤولين السودانيين الشماليين من الاستعمار، وبغض النظر عن شعورهم بأنه قد ظلمهم من الناحية المهنية، فإن أولئك المتعلمين كانوا قد شَكَلُوا جزءًا من النظام الاستعماري، وشُكِلُوا أيضاً من خلال ذلك النظام. وكان الاستعمار يمثل مصدر ضيق وسخط للمتعلمين لأكثر من سبب. فقد كانوا يتبرمون منه حتى عندما صار جزءًا منهم. وكانوا في بعض الأحايين يَتَحَدَّوْنَه، أو يشجبونه سراً (أو فيما بينهم)، ولكنهم كانوا، في غالب الوقت، يعيشون (أو يألفون العيش) معه. أما الأمر الثاني، فقد جعل الموظفون السودانيون الشماليون الحكم الاستعماري ممكناً، وذلك من خلال أدائهم لأدوار إدارية متعددة في ذلك الحكم. لقد طبعوا خطابات النظام؛ ورتبوها في ملفات، وسلموها؛ وجمعوا ضرائبه؛ بل وسجنوا معارضيه. وكان التخريب subversion الداخلي الخطير والمستمر للنظام نادراً بينهم. وكان من الشائع جدا بين أولئك الموظفين السودانيين تأكيد حصتهم في النظام الاستعماري من خلال السعي للترقية داخله، والاعتزاز بالوظائف التي تم تعيينهم لشغلها. لقد كانت الخدمة الاستعمارية طريقة حياة (a way of life) لمعظم المسؤولين الشماليين. وعلى الرغم من أن التحريض الوطني جاء من بين صفوف بعض أولئك المسؤولين الشماليين، إلا أنهم كانوا جزءًا من النظام الاستعماري، مثلهم مثل البريطانيين الذين حكموه به.
alibadreldin@hotmail.com



