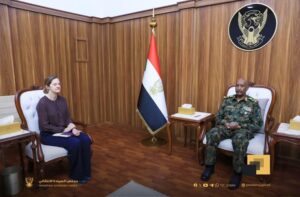يا راحلا عنا وباق فينا
ذكريات مع (العم) بكري


حين سقط خبر انتقال (العم) بكري في هاتفي سقط الدمع مني مدراراً ولا عجب. وغالبت عواطفي مستذكراً ما نقلت السيدة عائشة عن لبيد العامري :
ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب
لا يعلم المرء ماذا كانت ستقول أم المؤمنين رضي الله عنها، إن عاشت في زمانها ورأت واقعاً كواقع سوداننا. واقع على وطأته يرحل عنه الأخيار من أمثال بكري عديل.
واقع ينطبق عليه قول القائل:
(وأفجع من فقدنا من وجدنا، قبيل الفقد معدوم المثال).
أو قول القائل:
قد أبكرت يا رجل الرجال
وأسرجت المنون بلا سؤال
رحيل شكل نقطة فارقة في حياتنا الشخصية والحياة السياسية السودانية التي تتعرض لتجريف وتأجيج وتسميم يبث منذ حين. رحيل نبكيه بدمع تحجر في في المحاجر، وآهات متن في الحناجر، رحيل شكل نقطة فارقه لكثيرين.
كانت العلاقة مع (العم) من انتصارات الحياة ومن إنجازاتها. وهو ما ينطبق على كاتب السطور منذ أن التقيته وأنا في نهاية المرحلة الثانوية، حين جاء معزياً في خالي الشيخ المبارك، رحمه الله، كان وقتها حاكماً لإقليم كردفان، وكان قد خرج لتوه من سجون السفاح نميري، ونجا من حكم إعدام طال الشهيد حسن حسين عثمان وبرشم وزملائه في حركة سبتمبر 1975.
ومنذ أن التقيته وسمت وكلمات العم بكري ساكنة بأعماق الروح، وظلت تتجدد كذكرى يختلط فيها الحزن بفرح لقائه. وظللت استعيد المناسبة كلما سنحت الظروف واقتضى الحال.
فالذكريات بالنسبة للعم ولي جزء من حياتنا، وما الإنسان إلا ذكريات وصلات وعلاقات. تستوي في ذلك الذكريات الأليمه والسعيدة، وتشمل التي في مستشفى الأبيض حين كان (العم) سجيناً برفقة الحبيب عبد الرسول النور في عام 1983م، أو في رحاب بيت الله، حين جاء العم بكري مستشفياً ومؤديا عمرة في صيف 1995م، بعد خروجه من سجن طويل ومرير في عهد الحكم الحالي.
وفي كل حال ظل العم بكري مثل الذهب، مثالاً وبطلاً ونموذجاً يحتذى، وخاصة في صبره وتجلده على المشاق. وظل أبداً على طبعه البدوي العفوي ابن القرية الكردفانية التي بلا شوارع وبلا كهارب وبلا أضواء ولا بلا تكاذب. هكذا لم تغيره الوظيفة، ولم تبدله الألقاب فلم يستعلي، ولم تغره أم بنايا قش، وأكد دائما أنه الشبل ابن الأسد.
ظل (العم) نموذجاً للسياسي النظيف الذي ينسج العلاقات مع القوى السياسة أيا تكن التوجهات ومهما تتباين المواقف. وظل يقرب وجهات النظر بين القوى السياسية الوطنية، ويرفع من صوت المستبعدين.
وكان يجذب المختلفين لمواقفه التي لا تقبل قسمة. كان (أبو عادل) عديلاً وعدلاً يقول الحق، ولو على نفسه، وكان نموذجاً للسوداني العفيف النظيف، الذي يرى هدفه في الحياة مع مساندة الضعيف. ويرى نفسه صادقاً إن كان صوتاً لأهل السودان بلا فرز. لهذا ما أن يسمع بمشكلة طلاب العراق حتى يهب مسرعًا يعيدهم للوطن، ويعيد لهم كرامتهم، التي تكتمل بالبحث عن مقاعد دراسة في الجامعات الوطنية وفي الخارج. وهكذا رسخ قناعة بأن أي سوداني يجب أن يهمه أمر أي سوداني آخر.
لم يهتم كثيراً لعنصرية (ألوان) التي كانت ترى (عديل) مرادفاً (للسكن العشوائي)، أو من يسكنه لا فرق. ففي أحد المؤتمرات الصحفيه قال لمن يشنون عليه الحملات، أمامي الجرائد حقتكم، ومنها سأقول لكم من أنا، وماهي خططي المستقبلية. فابتسم من فهم. كان بليغاً بدون تكلف، وكان ينتقي مفرداته ليحملها بالدرر، وكانت عبارته تنضح بالبيان. لا يسيء ولا يسخر وركز دائما فيما يجمع السودانيين، وليس ما يفرقهم. فالكلام الشين يحسنه كل إنسان والكلام الحسن يفرز المواقف.
وعلى الرغم من اهتمامه بالسياسة السودانية المحلية، لكنه لم يغفل تأسيس علاقات عربية وعالمية أفادت السودان فيما بعد، وعززت من دور التعليم العالي. فقد فتح الباب لعلاقات أكاديمية مع ليبيا وسورية والكويت، كما عزز العلاقات مع السعودية والمغرب فضلاً عن مصر وبريطانيا. كان يرى في التعليم مخرجاً للسودان والسودانيين، وأنه أنجع وسيله للتخلص من الفقر والانتقال إلى آفاق الرفاه. وأفضل أداة لانتشال الريف من التخلف والتردي إلى فضاءات التنميه النمو.
قبيل رحيله بأشهر، زرته وأصدقاء، كان متماسكاً في وجه آلامه ومليئاً بالأمل كعادته وقوياً لا تهز الرياح العواصف. تكلم عن تحذيرات طبيبه، وكعادته أسند الأمر كله لله. وعندما تطرق الحديث إلى السياسة كان حاضراً فيها ومتابعاً لها، وتبدى لي أن فهمه للعسكر لا يقل عن فهمه للسياسة والسياسيين مما منحه بعد نظر ينقص كثيرين. يؤكد ذلك عندما استنتج أحدنا بأن أمراض (العم) وعلله كانت ناتج سياسة ومن آثار سجون الشموليات الانقلابيه، كان رده عبرة لمن يعتبر. قال: لا بد أن يتعلم الإنسان كيف ينسى، ولا بد أن يتعلم كيف يتعالى على ما يحدث. ولله دره.
تلك سطور من سيرة عطرة ودموع وذكريات ترد من شرفة الأحزان لتقول ليس صحيحاً أن (أمس والعصر الحجري سيان)، فالأمس سيظل حاضراً، ولن ننسى (العم) ما بقينا وما بقيت أبو زبد، ولسان الحال يقول: يا راحلا عنا وفينا باق ما بقي الليل والنهار.