الرواية في السودان الآن تشهد أجمل لحظاتها التاريخية
منصور الصُويّم: كسل في تعاطي العرب مع الأدب السوداني

أجرى الزميل الصحافي محمد الحمامصي حواراً مطولاً مع الروائي السوداني منصور الصويم الكاتب في صحيفة “التحرير” الإلكترونية، ولأهمية هذا الحوار تقوم “التحرير” بنشره.
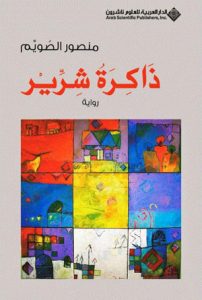
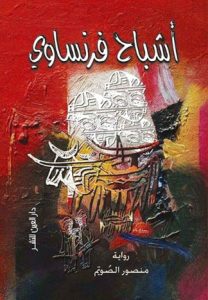
تشكل أعمال الروائي السوداني منصور إدريس الصُويّم إضافة مهمة لمسيرة الرواية السودانية، ليس فقط على مستوى الشكل والأسلوب واللغة وجماليات تقنيات السرد بشكل عام، ولكن أيضا على مستوى معالجة الموضوع وارتباطه بالواقع الإنساني أمكنته وأزمنته، حيث يتمتع الروائي بالجرأة في طرح قضايا الواقع المحلي السوداني وما يجري فيه من تناقضات تلقي بظلالها على المهمشين الذين يغوص في عوالمهم ويشكلها برؤية ذات بعد إنساني عام. وقد تجلى ذلك في رواياته الخمس التي أصدرها “تخوم الرماد”، “ذاكرة شرير”، “أشباح فرنساوي”، “آخر السلاطين”، و”عربة الأموات”.
الصُويّم الذي درس الدراسات النقدية بكلية الموسيقى والدراما جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا؛ له ثلاثة كتب أخرى بالمشاركة مع كتاب عرب وسودانيين. وقد ترجمت روايته “ذاكرة شرير” إلى اللغة الفرنسية، وروايته “تخوم الرماد” إلى اللغة الإنجليزية، وله قصص قصيرة إلى عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والسويدية. واختير ضمن أفضل 39 كاتباً عربياً دون الأربعين للمشاركة في فعالية بيروت عاصمة للكتاب العالمي 2010. وفي هذا الحوار معه نتعرف على جوانب مهمة في تجربته.
بداية وحول مراحل التكوين الرئيسة التي ألقت بظلالها وانعكست على رؤيته للعالم في أعماله، قال الصويم: أنظر الآن في مرآة ذاتي، محاولا الإمساك بأهم المفاصل الرئيسية التي أسهمت في تكويني الأدبي، وساعدت في اختياري “الرواية” وسيلة لمجادلة العالم؛ أجدني أتوقف كثيرا أمام صورة أبي “إدريس الصويم”، فهذا المثقف النادر، والأب المختلف، والرجل السابق لأبناء جيله وزمانه، كان بلا شك الموجه الأول لشخص مثلي، فهو من بذر بذرة الشغف الأولى، بميله الثقافي إلى الأدب، وبما كان يوفره لنا من كتب ثقافية في البيت، وبما كان يقصه علينا من حكايات وقصص تغترف من التراث العربي والعالمي والسوداني المحلي، بمواقفه الخاصة جدا في مواجهة الأنظمة الظالمة، وتاريخه النضالي التليد.
إذن من مكتبة منزلية متنوعة؛ وميل أسري عام نحو كل ما عو أدبي وفني جمالي كونت أول اهتماماتي بالأدب والفن. في البداية كنت أميل إلى الدراما “المسرح والسينما” وكنت أخطط لأصبح أحد أهم المخرجين والمؤدين في بلدي “السينما”، لكن مع تقدم العمر تراجعت هذه الرغبة وحل مكانها شغف الكتابة، الشخصيات المتكونة والمتحولة سينمائيا عبر الصورة، تشكلها الكلمات الآن وتموضعها الأحداث بما يجعل سؤالها أمام العالم أكبر وأكثر فداحة. من البيت إلى الشارع ثم إلى الأسواق – حيث يعمل أبي – وإلى السفر المتواصل – داخل إقليم دارفور ومن ثم العالم – من كل هذا تشكلت رؤيتي للأشياء، موقفي من هؤلاء “الناس”، تفجرت الأسئلة في مواجهة هذا العالم المتحول والمتفكك.. إلى أين تمضي بنا هذه البلاد، أو إلى أين نمضي بها نحن؟!”.
ورأى الصويم أن الزمن بالنسبة لأعماله الروائية يمثل ما يمكن أن أصفه بـ “عمق العمق”، وقال “أعني إذا كان موضوع الرواية، وتقنياتها زائدا لغتها، تلك هي الاشتغالات الأساسية التي أركز عليها عند إنجاز أي عمل روائي؛ فإن “الزمن” يصبح الإطار المحرك لكل ذلك والرابط الرئيس بين ثناياه. والزمن الذي يشغلني ويقودني إلى تشكيل كافة مفاصل الرواية وفقا لذلك هو ذلك الزمن الذي يسهم في الكشف عن هذه الخلخلة التي تحدث، داخليا – داخل النفس – وخارجيا – مجتمعيا وسياسيا وتاريخيا واقتصاديا -، فالزمن هو الأداة الأمثل لنزع القشرة عن المتحول في كمون، إزالة الضمادة عن المتعفن من جروح.. الزمن في تحولاته وتنقلاته يرتفع بنا ويهبط على مستوى الفعل، والحكي، والتكون السردي النهائي.
• غرائبية العالم
ولفت إلى أن غرائبية مفتتح رواية “عربة الأموات”، أظنه كان ضروريا كعتبة داخلية تقودنا إلى عوالم واقعية تتفوق في قسوتها وغرابتها على كل عالم غرائبي يمكننا أن نتصوره. وحضور الغرائبية في هذا الجزء من الرواية برأيي يأتي متناسقا مع التقديم الأولي لإحدى أهم الشخصيات المتناولة في الرواية؛ وهي الشخصية شبه المركزية في العمل بأكمله، وعلى يديها نستكشف أكثر المظاهر بشاعة وشناعة. وربما تبين غرائبية هذا المفتتح حجم السخرية الهائلة التي تواجه بها شخصيات الرواية هذا الواقع المأساوي الذي تحتم عليهم مواجهته في كل يوم، وأعني هنا بالتحديد الشخصية الموازية “الغراب” وما تمثله من صوت داخلي يتأرجح ما بين المقاومة والاستسلام والثورة”.
وحول رؤيته في التعامل مع اللغة في أعماله قال الصويم “حين يأتي الحديث حول اللغة في أعمالي الروائية المنجزة، أجدني منتقلا مباشرة ما بين اللغة الشعرية الناعمة جدا في رواية “أشباح فرنساوي” وبين اللغة السردية الخشنة جدا في رواية “عربة الأموات”، هذا التباين الكبير بين لغتي هاتين الروايتين يوضح الطريقة التي أتعامل معها لغويا أثناء اشتغالي على عمل روائي ما، فطبيعة العمل “موضوعه، تقنياته، شخصياته” هي التي تحدد إلى أي لغة يجب أن انحاز، وقد يحدث أن أمزج بين اللغتين مثلما حدث في “ذاكرة شرير”، أو إلى لغة تستند في تكوينها على التقنيات اللغوية المستخدمة في كتابة القصة القصيرة – التكثيف والتقطيع واعتماد الجمل القصيرة – وهي الطريقة التي كتبت بها أولى رواياتي “تخوم الرماد”، كما قد يفرض الشكل الفني لرواية بعينها أن تستخدم لغة خاصة جدا لها جذورها التاريخية، وقد تكون لغة غير مستخدمة تماما في الوقت الحالي. وهذه تجربة أنوي خوضها قريبا في عمل مستلهم من “الحقبة السنارية” في السودان”.
• عوالم المهمشين
في “ذاكرة شرير” رصد الصويم على لسان بطلها عالم المهمشين أو قاع المدينة أو العالم السفلي لها وهو العالم القادمة منه، فكان هناك وجه للتشابه بين عالم عربة الأموات وذاكرة شرير وإن اختلفت الأماكن والشخصيات، وقد علل هذا الشبه الظاهري بأن كلتيهما تمتحان من عوالم المهمشمين في المدن الكبيرة.
وأضاف: لكن عند العمق سنجد أن هناك فروقات جوهرية بين العملين، وما بين التوصيف “تهميش” فيهما. في رواية “ذاكرة شرير” المقصود بالمهمشين فئات المجتمع الدنيا، أولئك المنسيون والمحاربون: أطفال الشوارع “الشماسة”، والمتسولون، ومعاقو الحروب، وكل من لا ينتمي للمؤسسة الرسمية ويعد خارجا عليها. مهمش “عربة الأموات” إذا حولناه إلى “ذاكرة شرير” سيكون تصنيفه ضمن الفئة العليا، ويخرج تلقائيا من فئة المهمشين، وهنا ربما تكمن المفارقة، فالتهميش في رواية “عربة الأموات” يطال الجميع بما أنهم “أغراب” على هذا المكان، تميزك الطبقي أو الاثني أو الوظيفي “المجتمعي” لا يخلق فارقا عند انتقالك إلى هذا المكان، فأنت مواجه بذات أدوات التهميش التي – ربما – كنت تمارسها بوعي أو دونه على الآخرين قبل قدومك إلى هنا. وهذه في رأيي حالة وعي جديدة تسطع داخل أدمغة هذه الشخصيات وليدة التهمييش الجديد.
• هوجة الجوائز
وأشار الصويم إلى أن ارتبط الاحتفاء النقدي والجماهيري في المنطقة العربية مؤخرا، يما يمكن أن نطلق عليه “هوجة” الجوائز الأدبية. فحتى تصبح اسما يعترف به الجميع عليك الفوز بإحدى الجوائز الإبداعية الضخمة، فما ينتج على هامش هذه الجوائز أصبح هو الموجه الرئيسي لخريطة الأدب العربي، وبغض النظر عن رأينا في هذه الجوائز ومدى أهميتها إلا أن الأمر بحاجة لمراجعة نقدية شاملة، فكثير من الأعمال خارج هذا السباق لا تجد حظها من التناول رغما عن جودتها وأهميتها.
هذا مستوى، المستوى الآخر، التعاطي العربي مع الأدب السوداني عموما يتسم بالكثير من الكسل وربما في العمق التعالي؛ وما أعنيه أنه بالنسبة للإعلام العربي أن يكون للسودان ممثل واحد أو اثنان في الخريطة الأدبية فهذا يكفي وليس من داعي للبحث عن آخرين. الطيب صالح في الرواية. الفيتوري في الشعر، أما إذا وهبتنا الجوائز اسما أو اثنين آخرين فلا بأس. أعتقد أن الإشكالية الأساسية تتعلق بمدي حركية وجدية الإعلام والنقد العربي في التعرف على أسماء جديد وتقديمها سواء من السودان أو اليمن أو ليبيا أو ارتيريا وغيرها من الهوامش الثقافية العربية.
• الإبداعي والثقافي العربي السوداني
وكشف الصويم عن أن السودان ولظروفه الداخلية الخاصة جدا، يكاد يكون منفصلا تماما عن أي تواصل إبداعي أو ثقافي على المستوى العربي، وأعني هنا التواصل على المستوي الحي “مهرجانات، ندوات، مشاركات.. الخ”، كما أن المركز الثقافي العربي يتعامل مع الحالة السودانية بطريقة أشبه بالتمثيل النسبي في البرلمانات العربية، هناك مهرجان ثقافي عربي ما، يتم استفسار أقرب شخص للمنظمين عن مرشحين سودانيين، وهكذا سنجد أن هناك أسماء بعينها تحضر وتتكرر في هذا المشهد أو قد تغيب حتى هذا الأسماء دون أي مشاركة. نعم وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بصورة عامة يعمل على خلق حالة بديلة وأكثر صحية من هذا الواقع، فعلى هذا المستوى التواصل الناجح جدا وكثير من المثقفين والكتااب العرب بدأوا الآن بالتعرف التدريجي على المشهد الثقافي السوداني في صوره المتنوعة والمتعددة. على المستوى الواقعي أتمنى أن يتطور الموقف لما هو أفضل من هذا كثيرا.
• المشهد الروائي في السودان
وأكد الصويم أن الرواية في السودان الآن تشهد أجمل لحظاتها التاريخية على الإطلاق، فلا يكاد يمر شهر إلا ونجد عملا روائيا جديدا، فما نشر من روايات خلال العقد الأخير يفوق كل المنشور خلال النصف الأول من القرن العشرين.
أسماء كثيرة جديدة الآن تغذي هذا الشكل الإبداعي الجميل. نعم قد يأتي شخص ويتحدث عن أن هذا إنتاج على مستوى الكم أكثر منه على مستوى الكيف، لكن هذا لا ينفي أن هناك الكثير من الأسماء المهمة التي ظهرت مؤخرا وأثرت المشهد الروائي سودانيا وعربيا، كما أن عملية الفرز النوعي التي يطالب بها البعض ستحدث تلقائيا متى ما التفت النقد الجاد لرصد هذه العملية التراكمية المتفردة. هناك أكثر من تيار روائي جاد الآن في السودان، يجرب ويكتب ويحاول تقديم صورته الروائية الخاصة؛ وفي رأيي أن عملية التمايز بين هذه التيارات تمضي في النهاية لصالح الرواية السودانية، وستهبنا بلا شك تلك التجربة الخاصة التي ننتظرها جميعا.
• التضييق على المثقف
وعن تجليات المشهد النقدي في السودان ومدى متابعته للمشهد الإبداعي الروائي تحديدا قال الصويم: إذا نظرنا إلى المشهد النقدي السوداني مقارنة مع حالة “الانفجار الروائي” التي تحدث الآن قد نجده متأخر قليلا، وهذا كما أرى يعود إلى أسباب كثيرة أهمهما أن العملية النقدية في ذاتها أكثر بطئا من العملية الإبداعية الصرفة، فأدوات وآليات التقد تتطلب الكثير من التأني حتى تحقق الرؤية النقدية الجادة والمنصفة، هذا جانب داخلي، أما الجانب الآخر فيتعلق بالظرف الآني الذي يمر به السودان، فالبلاد تفتقد تماما للمجلات الثقافية المتخصصة، كما تفتقد لدور النشر التي يمكن أن تهتم بالإنتاج النقدي، وعموما لا وجود لأي مؤسسة ثقافية داعمة وجادة. غياب الصوت النقدي في هذه المرحلة تتحكم به مثل هذه العوامل ومع زوالها بلا يشك سيتفاعل النقد أكثر مع الواقع الثقافي المحلي.
وأضاف الصويم أن المثقف السوداني بصورة عامة يواجه تضييقا كبيرا من قبل السلطات المحلية. أغلب المراكز الثقافية والكيانات الإبداعية تم إغلاقها ومنعها من العمل خلال الأعوام الأخيرة، والتي سمح لها بالعمل تواجه ظروفا سيئة جدا لا تسمح لها بعكس ما هو مطلوب منها. هذا إلى جانب أن كثيرا من الكتاب يواجهون بما يعرف بسلطة المصنفات الأدبية في حال ما فكروا في نشر أعمالهم الأدبية والفكرية. لكن رغما عن كل هذا لم يتوقف المثففون السودانيون عن محاولات فتح نفاجات تساعد في إثراء وتجديد المشهد الثقافي السوداني، وكثير من المبادرات الخاصة والجماعية تصب في هذا الاتجاه، على مستوى الشعر والسرد والتشكيل والمسرح والسينما. ولو توفر القليل من الحرية لممارسي الأنشطة الثقافية في السودان بلا شك سنشهد نشاطا إبداعيا متقدما جدا.
محمد الحمامصي



