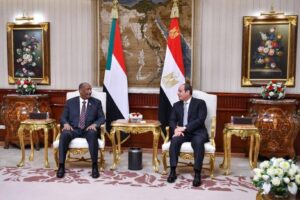لمَ لم يُقتص من الجلاد والظلمة؟
سلام على الخالدين وإمامهم

تمر علينا هذه الأيام ذكرى شهداء أبا وود نوباوى مارس/أبريل 1970م، وتتداعى المشاهد كما جسدتها الوقائع والمواقف وسيرة الإمام الشهيد الهادي المهدي وصحبه.
فقد تحرش النظام المايوي الانقلابي بالأنصار، وشرع يوم 27 مارس يقصف الجزيرة أبا بالبر والجو على مدى أربعة أيام ليلاً ونهاراً، وفي يوم 29 مارس خرج الأنصار من مسجدهم في ود نوباوي يطالبون بوقف قصف أبا، ثم تفرقت مظاهرتهم.
لكن النظام الشيوعي قرر قصف مسجد الإمام عبد الرحمن بود نوباوي. وبعد قتل أطفال الخلوة وحفظة كتاب الله، أمر جلاوزته بقتل الإمام الهادي المهدي، ورفيقيه سيف الدين الناجي، ومحمد أحمد مصطفى .
كانت مطالب جزيرة أبا الوادعة ومطالب الجبهة الوطنيه لا تستوجب هذا العقاب وهي:
– عودة الجيش إلى ثكناته.
– إطلاق سراح العتقلين السياسيين، وعلى رأسهم السيد الصادق المهدي.
– إزالة الواجهة الشيوعية تمهيداً لاستعادة النظام الديمقراطي.
– وقف التدخل الأجنبي في الشأن السوداني.
– اعتماد مشروع الجمهورية الإسلامية التي كان في مراحل الإجازة من الجمعية التأسيسية.
تلك الذكرىات الدامية ظلت جرحاً لم يندمل، إذ فقد الأنصار إمامهم وآلاف الشهداء وخصوصاً الذين جرت تصفيتهم وهم عزل إلا من إيمانهم. وتظل الذاكرة الجمعية للأنصار تستعيد مشهد سفاح صغير اسمه أبو القاسم محمد إبراهيم وهو يشرف على قتل العجزة والنساء داخل الجزيرة أبا، التي دخلها كأنه فاتح لأرض أجنبية.
تعرف معاجم اللغة الشهيد بأنه مشتق من الجذر الثلاثي لكلمة (شهد)، فهو الشاهد أو الحاضر. ويعرّف الفقهاء الشهادة والشهيد بأنه من مات إعلاء لكلمة الحق، وفي سبيل الله.
قال العلامة الطريحي: (وقيل سمي كذلك؛ لأن ملائكة الرحمة تشهده، فهو شهيد لأنه مشهود)، وقال آخرون سُمي كذلك؛ لأن الملائكة ستشهد له يوم القيامة.
والشهادة درجات والشهداء، قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)، وحسبك من فضل.
الكتابة إذن عن شهداء مارس 1970م، وعن ذكرى الإمام الهادي المهدي شرف، مع أن الحدث حزين، والخوض فيه تختلط فيه لواعج الغبن بمشاعر الغبطة والفخر. الغبن لأن هذا القتل المجاني يجري في السودان المتسامح؛ ولأن بعض القتلة لحم أكتافهم من بعض أفضال أبا. والغبطة تستدعيها حقيقة أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون في مراقي سرمدية.
ومع ذلك، فإن الكتابة عن الشهداء هي استعادة لبطولات تندرج في بطولات حمزة وعبدالله بن الزبير والحسين والإمام علي كرم الله وجهه. فمن بذل النفس دفاعاً عن الدين وإعلاءً لكلمة الله، والوقوف في وجه سلطان جائر كما في مارس 1970م فهو وقوف في وجه الحجاج أياً كان لقبه، والباطل حينها ضرب أرقاماً قياسية في التبجح، فلم يخف وجهه ولا توجهه. أو يداري استفزازه للشرعية الشعبية، بل توعدها بالصلب والقطع من خلاف، وخصوصاً في ليلة الاحتفاء بميلاد لينين تحت (الرايات الحمر).
حينها كنا دون سن الوعي، فلم نستوعب ما جرى، ولماذا جرى؟ وإن ظلت ذاكرتنا تسمع صدى شهادة الإمام الهادي وحضورها في الكلام والوجدان الديني، وأحياناً ينقل الشعر مشهداً وشهادة عنه. مثلما أسمعنا رفقاء في سوق الحصاحيصا أبيات عكير الدامر، وهو يرثي الشيخ الجيلي الشيخ دفع الله الكباشي، الذي انتقل في تلك الفترة من سبعينيات القرن الماضي، كأنه يرثي الإمام الشهيد :
خبر الشوم طلق بيه القبب إترجت
والنار في ( البطاحين) البترجموا وجت
أمواج المحبين بالشوارع دجت
وربات الحجول كشفت قناعها وعجت
ثم حفظنا فيما بعد قول من قال في الإمام الشهيد الهادي:
قلبك مو لحم من الدبادب طاير
صنديد عركة الحارة الخيولها دماير
الموت يا جليس الحضرة كأسا ً داير
سماحته عليك متل يوم العريس الساير
هكذا خطت أناملنا حروف تلك الأبيات على الرمال، وهكذا حفظنا دون وعي ما قيل من شعر في (الإمام الشهيد). لم نكن نعرف لماذا نفعل ذلك، إذ لم نقرأ عن الإمام سطراً. إذ الكتابة عن الإمام الشهيد وصحبه كانت ضمن قائمة الممنوعات التي لم تستثن لبس الزي الأنصاري. وعلى كلٍ، أحببنا سيرة بطلنا، ولم يطل بنا المقام حتى تشكل وعينا، وسمعنا الحكاية من أولها وإلى آخر مآسيها. فقد حدثنا الخال حسن مصري وروى لنا طلاب من أهلنا في المعهد العلمي بأم درمان عن المجزرة، وعن بطولات الأنصار.
وشمل النقل حلقة التفسير التي يقدمها الإمام الشهيد في مسجد ود نوباوي. وصورته وسماحته. فقد كان رجلا ًسمحاً جسد مدنًا بتاريخها وإرثها، ومثل مواقف يملأ ما بين لبب وسوح أم درمان. ومثل جسراً ما بين بطولات كرري وكربلاءات الشكابة.
كان بطلاً بمعنى الكلمة، وكان كلما نادى منادي الجهاد تمنى أن يكون في المقدمة. وكم تمنى مع الملك فيصل الصلاة في القدس. وكان قبساً من الإمام الأكبر، وظل مفتوناً بنهجه، ومأخوذاً بتساميه، وسموه الروحي. كان الإمام الشهيد الهادي يزن كلامه بماء الذهب، ويعرف مقتضى الحال، ودواعي المقام.
وكان في حبه للناس مثل ابن عربي لا يلتمس شوقاً يسكن الأطلال، وإنما محبة مفتوحة على مقام الأحلام، ومقام الأخلاء.
كان عندما يتحدث لمحبيه وللطلاب وهو يفسر الآيات البينات كان البيان يتدفق كالدعاش في خريف الرتوع، وكانت الآيات نفسها تخرج طرية، كما لو أن عبد الله بن مسعود يتلوها للتو في سوح المدينة المنورة.
مع ذلك، كان متواضعاً في قعوده ومشيه ولفظه، وفي رؤيته لذاته. وكان في حركاته وسكناته يجسد بطولة مؤجلة، وشهيداً محتملاً، فقد عرف بأنه لا يخاف في الحق لومة لائم. ثم تشرفت بأن استمعت إلى زوجه الحبيبة السيدة رقية عبد الله الفاضل المهدي، رحمة الله عليهم أجمعين، كانت تقول: “إن الإمام الشهيد كان أباً لطيفاً يتمتع بالظرف واللطف، ومزج السياسة بالأدب، والثقافة بالفكر الإسلامي.
وكان من أهل العفو والرحمة والتجاوز. وكان بسيطًا يشارك (بالونسة) أخواته وبناته وأبناءه، وكانت له ذكريات عن مدن السودان، وعن رجال ونساء من الأنصار، وعن أصدقاء، وعن رجال سياسة ودبلوماسيين وملوك.
وكان محيطاً بالحياة العامة في السودان، وأدوار الرجال والنساء في ثورة أكتوبر، وأحداث مارس (الحزين). وكان يتحدث عن الشعر والشعراء وعن علاقاته بدول الجوار وعن كتاب مفضلين ومفسرين وعمالقة في مجالات الإعلام والصحافة”.
ومن عجائب قدرة الله أن انقلاب السفاح انتهى في التاريخ ذاته الذي قصف فيه الجزيرة أبا، وذهب إلى المذبلة في السادس من أبريل 1985م، وفي ذلك عبرة لمن يعتبر.
وأما الذين تلطخت أياديهم بدماء الأنصار وإمامهم فقد انتهوا إلى مصير أرادوه لغيرهم في يوليو 1971م، فشنقهم السفاح، ثم أطلق إعلامه على (راياتهم)، فجرى وصفها بما كانت العرب في جاهليتهم تطلقه على نوع من النساء يسمين صاحبات (الرايات الحمر). وفي الذكرى، تتساءل: لماذا قتل الأنصار وإمامهم؟ ولم لم يقتص من الجلاد والظلمة؟ فتأتي الإجابة صاعقة، لهذا لا نزال تحكمنا النسخة الأسوأ من شمولية 1970م.