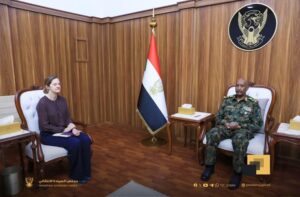زمن نقل الفضائح على الهواء
لماذا نكتب؟

هل نكتب لنكذب؟ أم نكتب لنعيش؟ أم نكذب بالكتابة؟ أم أن الكتابة نفسها أضحت وسيلة مثلى للمداهنة واللزوجة، وتحقيق المصالح الذاتية والانتصار على الأعداء؟ تغطية الاستغناء عن خدمات وزير الخارجية المخلوع الدكتور غندور ولدت هذه الأسئلة، وبالطبع ظلت هذه الأسئلة حاضرة فيما مضى من خطاب الإنقاذ الإعلامي.
لاشك أن ما جرى كان تلويثًا لصفحات الصحف، والفضاء الإلكتروني الذي امتلأ بالتضليل والتطبيل والافتراء بارتفاع شعبيته.
إن الإجابة عن هذه الأسئلة التي طرحت نفسها، بقدر ما تحمل من مغالطات بقد رما تؤكد الواقع البائس للإعلام في بلادنا.
ولكن مهما اختلفت الاستنتاجات حول مبررات ودوافع التكاذب الإعلامي، فإن الكذب يظل رذيلة، ويبقى حبله (قصير). ففيما يتعلق بشعبية أي عضو بالمؤتمر الوطني يستطيع أي سوداني بما في ذلك (شبه الأمي) تمييز التضليل بأقل المهارات العقلية، مثلما ميّز السودانيون دموع التماسيح، ومن بكى ممن تباكى.
ربما لأن التضليل واللف والدوران ضد الفطرة الإنسانية. ولهذا سخر السوداني العادي من دموع (شاعر أغنية رجعنالك)، إذ يسهل تحديد التحايل أو إجادة التمثيل، ولو كان الممثل بارعاً وأتقن دورة بحذاقة.
المفارقة أن كتّاب حكومة الإنقاذ رغم ادعائهم وصلا بليلى إلا أنهم منذ استيلاء جماعتهم على السلطة في عام 1989م ظلوا يمارسون التقليل من ذكاء الشعب، ولم يفطنوا حتى اليوم، أو ربما يتجاهلون حدة ذكاء الإنسان السوداني. الذي لم تغب عنه لحظة أن كتّاب الانقاذ في أغلبيتهم يظهرون ما لا يبطنون، وأن الله ثم الشعب يعلمون ما في قلوبهم، وأنهم ألد الخصام. هذا التذاكي (الغبي) أوقع جماعة الإنقاذ باستمرار في خطيئة الكذب المرضي، ولا عجب أن عُرفوا بذلك عند جميع السودانيين وعند العالم.
فعلى سبيل المثال، لم يصدق أحدا مبررات إعلام النظام بشأن إعفاء وزير الخارجية المخلوع، مثلما لم يصدق أحد نفي بنك السودان لما صرح به أمام المجلس الوطني، بل شرع الناس في تاويل ما كتب من نفي لانعدام المصداقية. فضلا أن الوزير قبل طرده كشف تلكوء بنك السودان في حل مشكلة تأخير أجور الدبلوماسيين، وعدم سداد إيجارات السفارات السودانية مدة سبعة أشهر( سونا 19 أبريل 2018م). وهذا ما يعني أن النفي أتى من متهم. مع ذلك جلاوزة إعلام الإنقاذ لم ييأسوا وشنوا هجمة إعلاميه على الورق، وفي الفضاء الافتراضي، وأطلقوا كمية من الدخان لحد تلويث فضاء إعلام التواصل الافتراضي، مرة بأن الوزير اكتسب شعبيه، ومرة أنه كشف حال (الدولة) لا السلطة، ثم تمخضت الحملة الإعلامية الحكومية الكريهة عن تأكيد أمر جديد قديم، كشف المزيد عن التيارات المتقاتلة داخل النظام، ونشر أسرار بعضها، وإتقانهم المدهش لطرائق وعمليات الإيذاء والاغتيال السياسي.
وفي الحقيقة، هو أسلوب أتقنه بعضهم على نحو ما اتقنوا مراقبة هواتف الرجال والنساء، وتصويرهم في عرباتهم، وفي داخل بيوتهم.
وبما أن الكذب حبله قصير، فقد جاءت المطافي فانقشع دخان الحملة بمفاجأة من عيار نائب الرئيس بكري حسن صالح، الذي وقف أمام المجلس الوطني (30 مايو 2018م) متحدثاً من المنصة ذاتها التى تحدث منها الوزير المخلوع؛ ليؤكد أن الحكومة أيضاً عاجزة عن توفير (102) مليون لتمويل استيراد الطاقة، فساد صمت القبور، وإلا هل سنرى من كتاب النظام ومقاوليه السياسيين حملة مماثلة. الإجابة كلا قولاً واحداً. وهو ما يطرح السؤال: لماذا نكتب؟
السياسة بوصفها علماً صارت لها تعريفات ونظريات تجمع على أن الإعلام المهني الشفاف ركن ركين في استقرار وتعزيز بقاء الدول واستمرار السلطة، ومن دون إعلام شفاف، فإن الحكومات تطلق النيران على أقدامها، من حيث تعتقد أنها تحصن نفسها بالكذب.
وأيضاً ينصحنا علم السياسة بأن الشعب باختياره الحر وافق على احتكار (السلطة) الوطنية في بلاده للقوة، ولكنه احتكار ينبغي أن يكون إيجابياً، أي يستهدف تحقيق الخير للمجتمع مثلما يستهدف الاستقرار والسلام والتنمية والعدالة، أي ألا يكون تضليلاً وقمعاً. لهذا لن تتحقق هذه المعاني الخيرة إلا بوجود ركائزها ومن أهمها الشفافية الإعلامية، وتطبيقات الحوكمة الرشيدة. وهي جوانب تشرعن أنظمة الحكم، أو ترفع عنها غطاء الشرعية؛ لهذا تعرف تطبيقات السياسية بأنها إدارة شؤون الأمة على نحو يوفر الاستقامة.
السياسة بهذه القراءة تعنى إجادة فن حكم الشعوب، وليس إجادة وسائل التضليل والقمع والقهر. لكن مشكلة كل ديكتاتور أنه يقلب دور الإعلام لينقل ما تريده السلطة للشعب، وليس نقل ما يريده الشعب من الحكم. لهذا يرفض الدكتاتور المساءلة والمحاسبة والشفافية مع أن المحكومين يريدون ذلك؛ لأنها ستظهره على نحو ما ظهر فرعون أمام الملأ عارياً من ورقة توت تستر عورته.
من هنا تقوم جمهوريات الخوف، ومن هنا تنحرف الكتابة والصحافة والإعلام، وتقمع حرية الكلمة. ومن هنا يصبح سؤال: لماذا نكتب مشروعًا بل ملحًا؟ والإجابة ستجعلنا نذرف الدموع، ولكن ليس دموع (التماسيح) التي نقلت في زمن نقل الفضائح على الهواء.