أوتوقراطية اللغة العربية في السودان
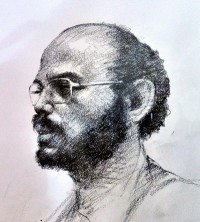
انتشرت اللغة العربية في السودان نتيجة لصيرورة متصلة بالقواعد والقوانين العامة لحركة اللغة وخزينها المعرفي والإنساني. وبما أن اللغات الكبرى، كاللغة العربية، يمكن أن تعكس هيمنتها من خلال التمثلات الأيدلوجية والسلطوية للناطقين بها على الناطقين بغيره، عبر استثمار التأثير الناعم للمكانة الدينية التي تحوزها مثلاً؛ فقد تحولت تلك الهيمنة بمرور الزمن إلى أداة في يد مجتمع تلك اللغة التي منحته سلطة وضع التصورات العامة للحياة من خلال مؤثرات أنتجتها الثقافة المحلية لذلك المجتمع، وبحيث تم تعويم تلك الثقافة، عبر الإعلام، كما لو أنها نموذج وطني لا يقبل القسمة على أحد، بطريقة ضخت حرجاً شديداً في لاوعي الآخرين كلما حاولوا تمثل لغاتهم السودانية الراطنة (والسودان كله راطن في جهاته الأربع)؛ هذا الحرج المتأتي من وهم الدونية اللغوية كان ينعكس غالباً استلاباً للهويات الراطنة عند غالبية السودانيين الذين أصبحوا بتقليدهم لمجتمع الثقافة العربية في السودان -لا سيما مجتمع الشمال والوسط – كمن يؤدون أدواراً وطنية لا يصلح معها التعبير عن هوياتهم الراطنة في الفضاء العام، إلا بوصفه مصدراً للحرج !؟
ومنذ استقلال السودان تضخم هذا الحرج ضاغطاً على وعي تلك القوميات السودانية حتى انفجرت تناقضات المأزق السوداني الذي طبق آيدلوجيا عوّمَ من خلالها هوسه باللغة العربية ضمن دعايته الأيدلوجية للمشروع الإسلامي؛ فظهرت حركات التمرد والحركات القومية والمناطقية كردود فعل كانت أشبه بالقنابل الزمنية.
****
والحقيقة أن هناك حاجة وطنية حقيقية إلى تدريس اللغات المحلية الكبرى في السودان كلغات (النوبة) و(الفور) (البجا) بشقيها (التبداوي والتقري) وغيرها ضمن رؤية معرفية يكون هدفها الوطني من توظيف اللغة ممثلاً في غايتين الأولى: تصفير الفاقد التربوي إلى نسبة الصفر بتدريس اللغة الأم في البوادي والمناطق الراطنة تماماً، لثلاث سنوات على الأقل، إلى جوار العربية؛ فحين يتم ذلك سيتمكن الطفل، عبر معرفته بلغته الأم، من الرغبة والحب والتفاعل الذي يجعله مؤهلاً للاندماج بسلاسة في العملية التعليمية، ومن ثم تمثلها تمثلاً يتجاوز به عقدة حاجز اللغة ذلك أن أهم أسباب الفاقد التربوي في السودان، الذي كان منتشرا في البوادي الراطنة مثل مناطق البجا المغلقة بشرق السودان كـ(هيا) و(قرورة) تمثل في سوء الفهم التاريخي لمنهجية تعليم اللغات الراطنة وفق استراتيجية معرفية ووطنية. فمثلاً حين يتلعثم الطفل الراطن في أثناء التعلم في المدرسة سيوحي بعجز عن الاستيعاب والتواصل الطبيعي مع اللغة العربية الجديدة عليه، فيكون بذلك عرضة للسخرية منه، سواء من طرف المعلمين أو حتى التلاميذ في المناطق الحضرية بطريقة تجعله يستشعر حرجاً معيقاً لاندماجه في العملية التعليمية، ومن ثم تدفعه تلك العقدة إلى ترك الدراسة في سن مبكرة جدا لتلافي الحرج، فيصبح ضمن الفاقد التربوي ويفقد من ثم الفرصة في الحصول على تعليم كامل.
وعادة ما يتم تفسير هذه الحالة النفسية من طرف المعلمين بأنها تخلف ذهني أو بلادة بدوية في التلقي؛ في حين الأمر ليس كذلك، وإنما هو نتيجة خطيرة لخطأ استراتيجي قاتل في العجز عن استثمار التنوع اللغوي في العملية التعليمية. ونظراً لأنه طفل لا يستطيع التعبير عن مشكلته، يضيع حقه المشروع في التعليم.
أما الغاية الثانية فهي الاندماج في الهوية الوطنية، فحين يقرأ الطفل بلغته الراطنة وبالعربية كذلك، تاريخ منطقته ويعرف معاني مفردات لغته من خلال كتب منهجية وتربوية تأتيه من المركز فهو هنا لن يستشعر التهميش، بل سيستشعر معنى وطنيته عبر إحساسه بها في مفردات حياته المحلية كاللغة والتاريخ والتراث وعند ذلك يصبح مؤهلا ويكون قادراً على الاستمرار في العلمية التعليمية حتى النهاية. هذا بالطبع ممكن جدا وسيؤدي دوراً كبيراً في تحقيق الاندماج في الهوية الوطنية وخلق الوعي والاستقرار. كما أنه قابل للتحقيق.
لقد حققت الهند نموذجاً وطنياً متقدمًا في استثمار التنوع اللغوي، وعلى الرغم من أن الهند أكثر تعقيداً في الأديان واللغات والأعراق من السودان مع ذلك أصبحت أكبر ديمقراطية؛ ولهذا ستظل المثال الساطع لعجز السودان عن إنجاز مصهر لهويته الوطنية. وإلا تحول ذلك التنوع إلى كارثة معيقة للاستقرار ومنتجة للنزاعات والحروب الأهلية كما هو الحال اليوم في السودان.
وإذا كان الغلاة يستنكرون الاستثمار المنهجي والتربوي للتعدد اللغوي في بناء الهوية الوطنية، عبر المزايدة على الخوف من ضياع لغة (القرآن)! وهو خوف أيدلوجي لا تبرره إلا الغايات السياسية والفئوية؛ فإن اللغة العربية ستظل هي اللغة الوطنية للمنهج التعليمي في كل مراحله بالطبع.
بطبيعة الحال نتحدث هنا عن تصور استراتيجي عام متصل بسياسات توظيف اللغات الأم في العملية التعليمية والاندماج الوطني. وإلا فهناك الكثير من النظريات والمنهجيات المتخصصة في الجامعات العالمية حول هذا الموضوع.
سيكولوجيا الحرج
تؤسس الظاهرة الأوتوقراطية للغة من خلال هيمنتها على الفضاء العام للتعبير حرجاً ضاغطاً على الهويات اللغوية الراطنة، بحيث تجعل من محاولة التعبير في الفضاء العام باللغات الأخرى يشكل حالة من الحرج والمشقة، يراكمان وعياً سلبياً في النهاية حيال الإحساس بجدوى اللغة الأم وإهمالاً لدورها في الاعتداد بهويتها. وفي العادة تصبح الظاهرة الأوتوقراطية انعكاسا للتخلف، والهيمنة، والاستعلاء الناعم. ومن ثم تتعرض موروثات وأساطير ومحكيات وأمثال اللغات للضياع والاندثار بفعل تلك الأوتوقراطية النابذة.
هذه الحالة السيكولوجية لمجتمعات الهامش والمجموعات الراطنة، بدورها تؤسس لحالة من الاستلاب لدى أفراد المجموعات الراطنة، والاستلاب داء خطير يمسخ الفرادة الإنسانية للفرد والمجتمع، ويقمع الإحساس المستقل، ومن ثم، يسهم إسهاماً كبيراً في تآكل الهوية الوطنية المتعددة، ويعكس حالة من التقليد غير المبدع والتبعية.
هذه الآفات الأوتوقراطية المنعكسة من هيمنة اللغة القمعية في الخطاب العام للمجتمع لا يمكن الخلاص منها إلا بتدريس اللغات الأم للمجموعات اللغوية الكبيرة.
الأوتوقراطية ضد اللغة
الاستخدام الأوتوقراطي للغة يعكس في الوقت نفسه قمعاً نوعياً حتى للغة المهيمنة ذاتها. حين يجعل من هامش تلك اللغة مظنة للحرج المتأسس من هجرها وانتباذها والحرج منها لضرورة التماهي مع لغة المركز والحواضر كنموذج لاستكمال النقص نحو المثال المكرس في لغة المركز. وبهذا المعنى فإن اللغة ذاتها تعكس هيمنة حتى على لهجاتها الطرفية (اللهجات العربية لريف الشمالية، وغرب السودان). مما يعني أن الظاهرة الأوتوقراطية ليست خاصية في اللغة، بقدر ما هي خاصية في طريقة وأسلوب الناطقين بها والمعتدين بها كشكل وحيد للمثال المرسخ للوطنية، والتحضر.
العربية من جهة راطنة
كما أصبحت العربية مستوعبة بمرونتها وقوانينها لكثير من مفردات اللغات الراطنة في البيئات التي انتشرت فيها، بحيث أصبح لديها ما يشبه طريقة خاصة في النطق (كعربي جوبا مثلا) ؛ كذلك أصبحت جزءاً أصيلاً في طبيعة التعبير المصاحب للأداء الراطن بحيث لا يشكل الاستخدام المزدوج بطريقة التقطيع بينها وبين اللغة الراطنة في حديث المتكلم أي غرابة، بالعكس بل ينطوي ذلك الحديث على ألفة وحب واندماج في هذه اللغة.
وهذه ظاهرة مطّردة في كثير من البيئات الراطنة في السودان، لاسيما في المدن الإقليمية حيث يمكنك أن تستمع لشخص يتحدث إلى قريبه أو صديقه بلغة راطنة مثلاً؛ كالبداويت أو التقري أو النوبية أو الهوساوية ثم يواصل حديثه بالعربية ويعود مرة أخرى إلى الحديث بلغته دون أي قطع أو شعور أصلا بالانتقال اللغوي. هنا تماماً تنعكس الألفة التي وطنتها العربية المحكية في نفوس الناطقين بغيرها مما يدل على أن الأوتوقراطية ليست من سماتها ولا انعكاسا لوجودها.
أثر فلسفة ما بعد الحداثة في اللغات الراطنة
بناءً على العلاقات العشوائية، وغير الاتفاقية بين الدال والمدلول في اللغات الإنسانية جميعاً شكلت فلسفة ما بعد الحداثة وعياً جديداً في إعادة الاعتبار لمختلف اللغات البشرية. هذا يعني أن أي لغة بشرية هي في ذاتها قيمة رمزية وإنسانية تستحق التقدير والاهتمام؛ فليست هناك قيمة مضافة للغة على لغة أخرى لمجرد الاختلاف اللفظي؛ لأن اللغات الإنسانية جميعها تستوي في كونها ملفوظات لدوال رمزية بناء على العلاقة العشوائية بين الأشياء وأسمائها.
وإنما تنشأ القيمة المضافة للغة على لغة بناءً على ما تنطوي عليه اللغة من المعاني الكونية والإنسانية العابرة لمحدوديتها، والمتجاوزة لجماعتها ولمنشئها؛ لتصبح تلك المعاني الكونية والإنسانية هي الشرط الرئيس لتقبلها عند الناطقين بغيرها؛ كاللغة العربية مثلاً التي كان الدين الإسلامي وقيمه الكونية والإنسانية شرطاً شارطاً لتقبلها من طرف المجموعات الراطنة في السودان وغيره. وكذلك اليوم أصبحت الانجليزية شرطاً شارطاً لمواكبة التطور والمعرفة لكوتها اللغة الكبرى للعلوم والمعارف في الأزمنة الحديثة. وكذلك انتشرت الفرنسية في أوربا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر،؛ لأنها كانت لغة الآداب والفنون في ذلك العصر.
هذا الاعتبار الجديد للغات البشرية الذي أعادته فلسفة ما بعد الحداثة ينبغي أن يقف اليوم في واجهة الاستحقاقات الإنسانية للغات الأم في السودان، وأن تشرع له السياسيات التربوية والتعليمية، والتشريعات الدستورية الضامنة له كحق أصيل للمجموعات اللغوية، إلى جانب اللغة العربية، التي هي بلا شك لغة الهوية السودانية الجامعة؛ لأنها بذاتها ليست خصماً لأحد في السودان.
* ورقة قدمت في ندوة “خريطة اللغات في السودان” بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض، بتاريخ 23 ربيع الآخر 1435هـ (23 فبراير 2014م).


