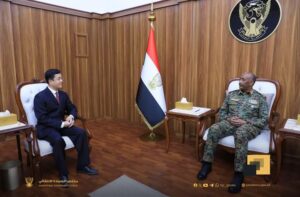و للإخوان في السودان قصة!!

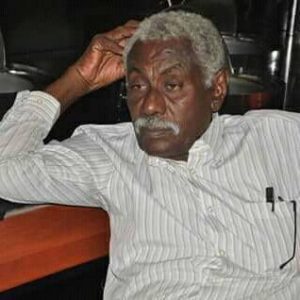 أتاح التاريخ للإخوان المسلمين في السودان سانحة نادرة، قلّ أن جاد بمثلها لأية جماعة أو حزب.. فرصة أحال الإخوان من خلالها وطناً برمته، إلى مختبر كبير للتجريب الأيديولجي، اتخذوا أرضه و شعبه، مجالاً حيوياً لممارسة وتطبيق أنماط من السلوك الراديكالي، بحماس طاغ لا تحده حدود.
أتاح التاريخ للإخوان المسلمين في السودان سانحة نادرة، قلّ أن جاد بمثلها لأية جماعة أو حزب.. فرصة أحال الإخوان من خلالها وطناً برمته، إلى مختبر كبير للتجريب الأيديولجي، اتخذوا أرضه و شعبه، مجالاً حيوياً لممارسة وتطبيق أنماط من السلوك الراديكالي، بحماس طاغ لا تحده حدود.
تفيّل اللافقاريات
إذ اعترت الأخوان بعد نجاحهم السهل في الاستيلاء على السلطة سنة (1989)، حالة تضخم للذات كالتي وصفها د. منصور خالد في تشخيصه لنواقص أهل السودان الذاتية، و التي تقود إلى طموح غير مشروع، ثم إلى خيلاء فكرية، تلك الخيلاء التي قال “منصور” إنها جعلت أغلب هؤلاء، لا سيما العقائديين منهم، يتظنى عن يقين باطل بأنه مالك الحقيقة الأوحد.
بل اعتبر “منصور” أن نمط تضخم الذات الذي وقع في السودان تفيّلت معه حتى القواقع اللافقارية.
شارحاً: أن تفيّل اللافقاريات تضاعف عندما أصبح الانتماء العقدي لحزب أو جماعة جواز مرور لكل موقع مهني عال، كان ذلك في الإدارات الحكومية، أو الجامعات، أو المؤسسات المالية و الاقتصادية.

منصور خالد
و من منصة التاريخ ذاتها أطلق “منصور” شهادة تقول: ( لنعترف بأن تلك الظاهرة بدأت بصورة محدودة في أكتوبر (1964)، تحت اسم التطهير، و تطورت في مايو بدعوى عدم مواكبة الثورة، كما حدث في تطهيرات الجامعة والقضاء في مطلع نظام مايو، ثم بلغت حدها الأقصى بحلول نظام الإنقاذ تحت راية التمكين).
راية التمكين
راية التمكين التي ضربت بجذورها في باطن الأرض بعيداً، لتنبت “دولة شوكية عميقة” تتجلى الآن بوضوح في صورة الواقع المأزوم الذي تتخبط قيد براثنه البلاد.
إذ إنه في الحقيقة واقع معقد مشتبك للغاية، لا يمكن تجاوزه على أية حال بيسر، لارتباطه الجذري والحاسم بمستقبل وجود وبقاء الإسلاميين كتيار فاعل يتشبث بوجوده على الخارطة.
و لذلك فقد بات رهان الحركيين الإسلاميين الوحيد، بعد فشل تجربتهم في الحكم، ذلك الفشل الذي لا تنتطح حوله الآن عنزتان، على تعقيدات صنعوها أحاطوا بها الدولة إحاطة السوار بالمعصم، من خلال تمددهم غير المبرر في كل شعابها، إلى أقصى حد يمكن أن يتصوره عقل.
على جثة وطن
إن صورة هذا الواقع الغريب، يتحدث عنها بزهو كبير الدبلوماسي الشاب خالد موسى، كإنجاز للإسلاميين بالطبع، من شأنه أن يورث الآخرين شيئاً من اليأس في التغيير ربما.. قائلاً: (لا أتطرف إذا قلت إن حكم السودان دون وجود الإسلاميين، يعتبر ضرباً من المستحيل في الوقت الراهن، إلا إذا تغيرت معادلات الواقع، وهذا لا يلوح في الأفق القريب الآن).
و كأني بصوت الروائي الراحل الطيب صالح، ذلك الصوت العميق، يتردد الآن في أذني، وهو يقول: (أما زالوا يحلمون أن يقيموا على جثة السودان المسكين خلافة إسلامية سودانية يبايعها أهل مصر، وبلاد الشام، والمغرب، واليمن، والعراق، وبلاد جزيرة العرب؟).
مسخّرون لخرابه

الطيب صالح
وأقول للطيب صالح في قبره، نعم !! إنهم عادوا يتحدثون اليوم كسابق عهدهم الذي كان عن “حركة إسلامية كاملة الدسم”، و أن ما فعلوه هنا خلال ثلاثة عقود هو لله خالصاً، لا لهوى أو لحظوظ نفس في سلطة أوجاه، بل قالوا سيدي: إن فتحا جديداً ينتظر بلادنا بدخولها ولو بعد حين لنادي الدول العشرين العظمى، تصور سيدي أن هؤلاء الرجال الأوفياء لتاريخهم لم يخذلوا توقعاتك فيهم، ولم يفارقوا نظرك الأول قيد أنملة، تركوا لك الباب مشرعا كما هو،ً لكي تظلّ أسئلتك الأولى قائمة إلى يومنا هذا كما هي كذلك، فكأنك من قبرك الفسيح كما أظن، تسأل اليوم عن ضيق ألم بنا و أنت غائب بقولك المشهور ذلك: (هل مازالوا يتحدثون عن الرخاء والناس جوعى؟ وعن الأمن والناس في ذعر؟ و عن صلاح الأحوال والبلد خراب؟)، ثم سؤالك القديم المتجدد إلى الآن: (هل أسعار الدولار ما تزال في صعود، و أقدار الناس في هبوط؟)، يا سبحان الله.. ألست أنت القائل: (أي ثمن باهظ يدفعه الإنسان حتى تتضح له حقيقة نفسه، وحقيقة الأشياء من حوله).. لقد دفع الناس هنا سيدي ذلك الثمن الفادح، من كل نوع، و في كل شيء، فمتى إذن تتضح لهم حقائق أنفسهم، و حقائق تلك الأشياء التي تجري من حولهم،.. من سيفك لهم طلّاسم سؤالك الكبير (إذاً لماذا يحبونه –أي الوطن- و كأنّهم يكرهونه، و يعملون على إعماره وكأنهم مسخّرون لخرابه؟).
لقد فعلوا أيها الرجل الطيب الصالح كل ما كنت تسأل عنه تماماً، كما كنت تخشى، و أنت تقول: ( من الذي يبني لك المستقبل، يا هداك الله، و أنت تذبح الخيل وتُبقي العربات، وتُميت الأرض وتُحيي الآفات).
فتحت رايات التمكين، كم “تفيّل” على الرؤوس كائن من هذه اللافقاريات الرخوة، و كم حسب الناس، أن ثمة شحما في من شحمه في الحقيقة ورم.
سقوط القناع
هكذا كثيران الساقية، ظللنا لزهاء ثلاثين عاماً أو نحوها، ندور في فلك واحد، بين مرارة الواقع، وحلاوة الوهم، نتخبط.. نغرق في مستنقع الفشل إلى آذاننا، نغوص فيه بعيداً.. فشل اضطر معه الحركيون الإسلاميون أخيراً لنزع قناع كبريائهم الزائف، -أغلى ما يملكون- بحثاً عن طوق نجاة –يؤرخ به- من خارج سربهم المقدس.
إذ إن من أبغض الحلال في عقيدة التمكين مطلقاً، الاستعانة بكادر يساري معروف مثل الدكتور عبدالله حمدوك، الذي اعتذر هو على أية حال عن تولي حقيبة الاقتصاد في دولة المشروع الحضاري –نقيضه الفكري-، بعد أن خسر الإسلاميون من قبل رهاناً مماثلاً على علاقات حليفهم اللّدود مبارك الفاضل الدولية، الذي أسندوا إليه على مضض، ترأس قطاع الاقتصاد بحكومتهم الأخيرة المحلولة، أملاً في نجاح “البلدوزر” بجّر عجلة الاقتصاد إلى خارج مناطق الوحّل، رغم صعوبة تلك المهمة بالطبع، التي تتطلب على الأقل إحاطة تامة بنوع القوى المحّركة للخيوط خلف كواليس تلك الأزمة التي تراكمت ببطء شديد عبر السنوات، بغية تفكيكها بدقة وحذر، كحذر من ينزع أو يفكك حقل ألغام .
بيد أن المؤكد الآن.. هو أن اقتصاد الإنقاذ المأزوم إلى النخاع، قد نجح هو أيضاً بشكل أو بآخر في إجبار هذه الحكومة المترنحة على التعاطي مع خيارات قاسية على نفسها، غير مرغوبة لديها، تجري الآن خارج صندوقها السحري.. ما كان مجرد التفكير بها، ناهيك عن العمل عليها، أو الشروع فيها ممكناً أصلاً.
نقاط ضعف الإنقاذ
رغم أن أحد أهم الباحثين الإسلاميين الدكتور التجاني عبد القادر، كان قد قرع قبل حلول ظلام الأزمة الحالية الدامس، جرس إنذار مبكر، منبهاً في وقت سابق، إلى أن أبرز نقاط ضعف هذه الحكومة تتمثل في افتقارها لوجود مفكرين اقتصاديين، مشيراً إلى أن النظام لا يمتلك سوى موظفين اقتصاديين يتكئون على خبرة حصدوها من تجارب محدودة في المصارف الإسلامية، و بعض المؤسسات الأخرى.
وقال “التجاني” إن هؤلاء الموظفين لعلة القصور تلك يديرون حالياً اقتصاد الدولة بعقلية إدارة شركة لا أكثر.
وقطع “التجاني” فضلاً عن ذلك بعدم وجود رؤية كلية للإنقاذ تتعاطى بها مع كافة قطاعات الاقتصاد، الذي وصفه بأنه يدار كمقاطعات معزولة عن بعضها، يغيب عنها بالتالي التوجه نحو التنمية بصورة واضحة، رافضاً بالكلية نسبّ اقتصاد كهذا ـ تذهب فوائد إنتاجه لشريحة صغيرة ـ إلى مذاهب الإسلام.
التناقض مع الدولة
وهكذا هو بالطبع حال علاقة تنظيمات الإسلام السياسي عموماً بالدول الحديثة التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية على معيار المواطنة فحسب.
فهنا في السودان منذ أن ركّب الشيخ الترابي منظمته، أو قل منظومته أممية الطابع، على فرع الدولة الوطنية القطرية، نشأ تناقض جوهري بين عقل الدولة البارد الجامد، وعقل الإسلاميين الراديكالي الجامح الذي اقتحم قلاع الدولة العتيدة بجرأة كبيرة، إلى أن أدرك أخيرا، وبعد جهد جهيد، أنه فاقد لخاصية الاتصال بجهاز الدولة القائم، الذي لم تتمكن شاشة العقل الإخواني التمكيني، لأول وهلة قراءة عناصره ومكوناته الدقيقة، المثبته على أقراص تلبي فقط المطلوبات والشروط التكوينية للدولة القطرية بلازيادة و دون نقصان.
ومن هذه النقطة بالذات نشأ التناقض الفاضح الذي عبر عنه سؤال الطيب صالح “لماذا يحبونه، و كأنهم يكرهونه، و يعملون على إعماره وكأنهم مسخّرون لخرابه؟” فالإسلاميون يكرهون الأوطان التي لا تقبل خدمة أهدافهم البعيدة، التي ليس من بينها في الواقع خدمة تلك الأوطان، لكنهم يحبون أوطاناً أخرى تذعن تحت أيديهم لأداء أدوار المنصات والرافعات التي ينطلقون منها نحو أهدافهم الحقيقية التي لا تعرف بالضرورة حدودا تقف عندها، من ذات نقطة عدم الاعتراف بمبررات وجود هذه الأقطار والأوطان نفسها في النهاية.