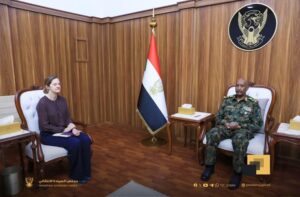أفضل إنجازات البشير

يصرُّ النظام الحاكم إصراراً عجيباً على إكمال حلقات مسلسل سقوط الطغاة كلِّها، والأنظمة الملفوظة من شعوبها، وكانت أولى حلقاتها التعامي الإعلامي عن الأحداث الجارية في شوارع المدن السودانية، بل قراها أيضاً، وعدم نقل أي جانب من الاحتجاجات الشعبية في أجهزة الإعلام الرسمية، ثم إيجاد كتيبة من الهتيفة والببغاوات ينتشرون في وسائل الإعلام للحديث عن إصلاحات لا توجد إلا في مُخيلاتهم، وعن شعب غرَّر به الشيوعيون، واندست بين أفراده قوات عبدالواحد التي تحرك الأمور من وراء ستار، وقد بلغت جرأتهم قمتها بادعاء أن رصاصات عبدالواحد هي التي أسقطت الشهداء.
وهكذا فعل الطغاة من حولنا في الربيع العربي، أنكروا التظاهرات، واتهموا المندسين، و”اللهو الخفي” على رأي الإخوة المصريين، وفات نظام البشير أنَّ السودان لا يزال مجتمعاً ضيقاً لا يمكن أن يُخفى فيه أمر، فكل من أطلق ناراً، وحمل سلاحاً رصده الثوار، وعرفوا أماكن عملهم وسكنهم، وأتوا بمعلومات وافية عنهم، حتى أولئك الذين قُبض عليهم ظلماً، واتهموهم بأنهم مندسون عرفوهم، ومنحوهم صكوك البراءة، ليكون التلفيق والخداع من نصيب النظام الذي حاول الاستخفاف بالعقول، ودفع التهمة عن أجهزة أمنه، وميليشياته، التي قدم عنها علي عثمان محمد طه أحد أركان الحركة الإسلامية اعترافاً مجانياً، وكان هدفه الترهيب، وإدخال الرعب في قلوب الناس؛ لينقلب السحر على الساحر، فيعرف القاصي والداني كيف تُدار الدولة طوال 30 عاماً عجافاً، ولتسقط ادعاءاتهم بضرورة الاحتكام إلى صناديق الانتخابات، والتمسك بمخرجات حوار وطني لا وجود له في الواقع، لأن هذا الحوار ما كان إلا بين شرذمة الأحزاب التي شقَّها النظام، وظفر بمفسديها، وبطالبي السلطة والجاه من العاطلين عن أي قدرة وعطاء، وبالمستعدين لبيع أنفسهم للشيطان في سبيل مصالحهم الضيقة، مما يوجب الشكر للنظام الذي خلَّص كثيراً من أحزابنا من عاهات ظلت تقعدها عن أداء دورها الوطني.
أما الممارسة الجديدة التي لم تكن في فصول الربيع العربي، فهي تلمُّس رئيس الدولة مواضع الجمهور الذي قد يبث في نفسه بعض الطمأنينة، فطاف مدن الجزيرة، وهرع منها عائداً بسرعة إلى الخرطوم، وذهب إلى عطبرة مؤججة الثورة، ولم يجد غير الصد، وذهب إلى دارفور التي اعترف بأنهم قتلوا أهلها لأتفه الأسباب، ثم عاد إلى الخرطوم ليحتمي بجمهور من البائسين الذين أغروهم بوسائل شتّى، أقلٌّ ما يُقال عنها إنها تافهة ورخيصة، مع مال ناله من بذل الجهد في جمع الناس، ومع هذا لا يمكن وصف من جَرُّوهم طوعاً أو كرهاً إلى الساحة الخضراء بالحشد، حتى أصبح منظر عبدالرحيم محمد حسين وهو في انتظار الحشود من الطرائف والنوادر التي تُضاف إلى سجله الحافل بأسباب الضحك والتندر.
وجاء اقتحام مناسبة دينية سنوية يحتشد لها سنوياً جمهور كبير من أهل الصوفية مصدراً للغرابة والاستهجان من أهل الدار الذين أصدروا البيانات التي تنكر على رأس الدولة هذا السلوك الذي لا يليق، ولم ينج الزميل الإعلامي سعدالدين حسن من الاعتقال لقوله الحقيقة، التي أصبحت تعكر صفو النظام المُعكر أصلاً بحراك الشباب الثوري الذي لم يهدأ على مدى أكثر من شهر.
وأطلق النظام (جداده) الإلكتروني ليضع كلاماً على لسان بعض من تراهم مؤثرين، ولهم مصداقية، مثل الزميل فتحي الضو، الذي أنشؤوا صفحة باسمه، والسيد الصادق المهدي، الذي جعلوه يقول زوراً وبهتاناً: “الثورة “ليست وجع ولادة”.
طبعاً يحاول (الجداد) تقليد أسلوب من تنتحل اسمه، ولأن الجهل يغلب عليه نرى الأخطاء اللغوية الفظيعة، والتحليلات (الفطيرة) التي لا تقنع، وهذا الانتحال أساسه عدم وجود أناس لهم مصداقية في زمرة النظام.
أما تكميم الصحافة واعتقال الصحافيين فمن الممارسات المعتادة، إلا أنّ وتيرتها تسارعت مع الحراك الشعبي، وبلغ انتهاك حرية الصحافة مداه بضرب بعضهم، وإصابتهم بجروح، وسحب رخص العمل من بعض مراسلي القنوات الفضائية.
ومن آخر ما سمعت قول الصادق الرزيقي على شاشة قناة “الجزيرة”: “إنّ البلد تمضي فيها الحياة في صورتها المعتادة، وإنّ الناس عافوا الحراك، وإنّ الحل في الانتخابات، وإن المندسين والأحزاب هم من يستغلون غضب الناس”، ولم يفته -كعادة النظام وتابعيه- التحذير من حمَّامات الدم.
وبهذا لخَّص الرزيقي ما قاله البشير ووزير الإعلام، ورئيس جهاز الأمن والمخابرات، أي أن الخيار المتاح أمام الشعب المنتفض: النظام أو الفوضى، وهذا يعني أن البشير يريد أن يسير على خطى بشار الأسد، الذي يبدو أن زيارته له كانت للاستفادة من خبراته، إلى جانب الاستقواء بروسيا كما فعل بشار أيضاً.
وفي ظني أن الرئيس البشير يعيش وهماً كبيراً، فهو يرضى كغيره من الحكام المعزولين عن شعوبهم بما تقوله تقارير الأمن والمطبلاتية لا ما يفصح عنه الواقع، والدليل أنه يردد ببغاوية ما تقوله أجهزة الأمن، وما قاله عن استشهاد الطبيب أبوبكر يقف دليلاً على تشبّعه بثقافة التقارير التي تفصل الحاكم عن الواقع، وهذا ما يجعله يعيش عالماً حالماً، فيرى نفسه القائد المظفر المحبوب الذي انتشل السودانيين من جحيم الفول إلى جنة الهوت دوق، وأي كلام آخر يعيده إلى الواقع المزري الذي صنعه بيده يكون مصدره شيوعياً مغرضاً، أو متمرداً حاقداً.
وهذا التصور الخاص بالبشير هو ما يعقّد المشهد، ويجعل الحلَّ مستعصياً، على الرغم من إدراك كثيرين حوله أن العودة إلى زمن الهيمنة والسيطرة والتهليب قد ولى، إلا أنهم لا يجرؤون على مواجهته بالحقيقة.
والثوار الذين خرجوا إلى الشارع متحررين من قيود الأحزاب وحساباتها، ومن أبوية القيادات وهيمنتها، ومن خوف أسرهم وعاطفيتها لا يمكن لأحد أن يقنعهم بالعودة من منتصف الطريق، وخصوصاً بعد سقوط شهداء منهم، جعلهم يرفعون شعار: “يا نجيب حقهم.. يا نموت زيهم”، وهذا الواقع المعقَّد سيقود حتماً إلى شلل الحياة أكثر مما هي مشلولة الآن، سواء نُفذ الإضراب السياسي أم لم ينفذ.
وبزيارته قطر، يبحث البشير عن حلول تقليدية تتمثل في توفير الخبز والوقود والنقود وبعض الضروريات، وأدوات القمع، وهذا ما يعني أنه لا يزال يسير في الاتجاه الخاطىء، فالشعب فارق محطة البطون والخدمات، إلى محطة العيش الكريم بكل عناصره من “حرية وسلام، وعدالة، وديمقراطية”.
وهذا التخبط من النظام، ومحاولته إنكار الواقع الماثل أمامه، يستوجب سؤالاً مهماً: أليس في نظام الإنقاذ رجل رشيد يمزق التقارير المهترئة التي يرى البشير من خلالها السودان، ويعيده إلى الواقع ليدرك أن أفضل إنجاز له طوال 30 عاماً سيكون قرار التنحي الاختياري، الذي يحقن دماء أبناء هذا الوطن، ويعيد الحياة إلى دورتها الطبيعية.