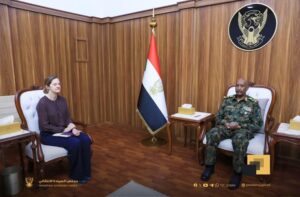(هويدون)…”بت ملوك النيل”

الساعة السادسة والثلث مساء يوم السبت 28 أغسطس العام 2015 م فارقت جنة دنياي وشريكة حياتي وزوجتي( هويدا عبود)، فكتبت بعض قصتي وحزني .
في ذكراها، أحبتي، أشرككم إياها.
لكم من الشكر أجزله.
(لو كان الموت بخبِر)
(هويدون)…”بت ملوك النيل“
مدخل أول: كانت الإعراب تستعيب رثاء الزوجة، وترى في التعبير عن الحزن والأشجان والحنين لفراق الزوجة منقصة.
= مدخل ثانٍ: ثم كان الرسول صلى الله عيه وسلم عندما
يبلغ حده الأقصى في وده وحبه للسيدة (عائشة) يناديها(عائش).
آخر الليل… في العام 1992م، وحين مضى الناس هاجعين، كنا أنا وزميلي المخرج الصحافي القدير لقمان عبد الله نسابق الزمن، ونروض اللحظات، لإكمال تصميم الصفحة الأولى من صحيفة “السودان الحديث” الحبيبة.
من باب تخفيف عبء العمل عن كاهلنا، أمطرت زميلي لقمان، هو القادم إلينا،اللتو، من كلية الفنون الجملية، بسيل من الأسئلة التقليدية، على شاكلة: من أنت؟ ومن أين أنت؟ وأين درست…أنت؟ ولماذا انتخبت التصميم الصحافي مهنة، وسبيلاً لكسب العيش…أنت.
يجيب لقمان بأريحية، حتى بدا الرهق، من وطأة الأسئلة وسيلها المتدفق، على وجهه الصبوح.
سكت لقمان برهة، وهو المنهمك في وضع اللمسات الأخيرة للصفحة الأولى- المرحلة، التي تسبق المونتاج، ثم الطباعة- فرد صاع أسئلتي له صاعين: من أنت ؟ لأي اتجاه من اتجاهات السودان الأربعة تنتمي أنت، إلى آخر الأسئلة في السياق.
قلت له أنا من الغرب الأقصى السوداني: أعني دارفور. مسقط راسي منطقة”كتيلة”، في الجانب الجنوبي الغربي للسودان، على تخوم أفريقيا الوسطى، وواصلت أجيب، جرياً على سخريته في الرد على أسئلتي: كي تصل”كتيلة” هذه، عليك أن تركب الطائرة إلى آخر حدودها، ثم “اللوري” إلى آخر طريق سالك، فعربة ” كارو” إلى آخر جرف من جروف الوديان، وما أكثرها هناك، في المسافة بين منطقة “كتيلة” ومدينة “نيالا”، وتواصل على ظهر حمار “ريفاوي” سريع، لتنتهي رحلتك الميمونة إلى” كتيلة” راجلا، لمسافة كيلومترات محفوفة بالأدغال والوديان…وكل ملامح الريف.
باغتني “لقمان”بسؤال خرج من بين ابتسامة ساخرة حادة: وكيف، يا هذا، عرفت أن بالخرطوم صحافة وصحفاً، وعالماً يضج ويسعى حثيثاً ليعيش.
إجابتي عن سؤال “لقمان” تنطوي على فصول مهمة من فصول حياتي، من صبي يرعى الأبقار والأغنام في فيافي “كتيلة” و”قوز دنقو”، إلى العمل مساعداً في الزراعة في فصل الخريف، إلى مدرسة السحيني الابتدائية في”كتيلة”، ثم مدرسة نيالا شمال الثانوية العامة في نيالا، فمدرسة نيالا الثانوية العليا، فقسم الصحافة بكلية الآداب بمدينة سوهاج التابعة لجامعة أسيوط في الحبيبة مصر.
هي فصول ليست مفروشة بالورد، ولا تبدأ بولوجي العمل الصحافي عبر التدريب في صحيفة الأيام، تلك المدرسة المرموقة الراسخة، ولا تنتهي بالتحاقي بالعمل في صحف: “السياسية والاتحاد والخرطوم “، وهي مدارس لا يشق لها غبار، ولا بمراسل متعاون لصالح صحف ووسائل إعلام خليجية ولندنية، غير أنها تمضي، بلا شك، لتمهد لفصول تالية في حياتي جمعتني بالحبيبة والشريكة والصديقة وأم أولادي: هويدا إبراهيم محمد عبود” هويدا عبود“.
لا شك بأنه كان ” أول التكوين”، حين فتح الأساتذة الراحل محمد سعيد معروف رئيس مجلس إدارة صحيفة السودان الحديث في العام 1994م، والنجيب آدم قمر الدين رئيس التحرير وفتح الرحمن النحاس مدير تحريرها، باب الصحيفة، واسعاً، لطلاب الجامعات والمعاهد..وغيرهم، لتلقي التدريب على فنون العمل التحريري في الصحفية، بأشكالها المختلفة.
كالفراشات زهواً وبهاءً وحيوية وجموحاً.. وزفة ألوان، دخلن مبنى”السودان الحديث”: هويدا عبود، ولمياء ميرغني، وأميرة القاضي، ووجدان الجاك، وعلوية مختار، وناهد النور، ومنى خالد.. وأخريات، بخطاب رسمي لنيل مدة تدريبية في أقسامها المختلفة، حررها لهن أستاذ الأجيال ومؤسس كلية الخرطوم التطبيقية عبدالله محيي الدين الجنيد”، أو “عمي الجنيد”، كما يسميه طلاب وطالبات الكلية.
وكان “نصيبي”، من هذه الدفعة، في قسم الأخبار، وقد كنت أديره في الصحيفة، بعض فراشات بينهن “هويدا عبود“.
ولجتني هذه الفتاة بالحيوية والرحيق و”الفهم” العال، كما يولج النور مسام الليل. عرفتني وعرفتها. على هامش التدريب، عرفتني أعشق قراءة الرواية، وعرفتها امرأة تقرأ، بنهم، باتجاهات المعرفة المختلفة.
مددت جسراً للتواصل بيني وبينها حين أهديتها، رواية” شرق المتوسط” للروائي العربي الشهيرعبدالرحمن منيف، وكانت قد صدرت حديثاً.
ولما كنت مهووساً بالروائي البرازيلي جورج أمادو، طبقت الهدية، ثانياً، برواية ” فارس الرمال”.
التهمتهما سريعاً وتناقشنا، حتى صرنا جزءاً من “فرسان امادو” خفافيش الليل أشقياء الكاريبي.
من ناحيتها، بنت”مدماكا” على الجسر، فأهدتني رواية “الشك” للروائي والمؤلف الإنجليزي كولن ويلسون، وقد كانت تركب أعلى موجات هذا الكاتب المشغول بعوالم النفس ودهاليز المجتمع.. وقصص أسفل المدن والحواري، ورادفته بكتاب “اللامنتمي” لويلسون ذاته…وتوالت” المداميك” على الجسر.
على ذات هوامش التدريب، صارت تنمو خلايا الانتماء بيننا.. نتسج خيوطها الرفيعة، من حيث ندري ولا ندري. ومع كل صباح، نكتشف بعضنا بعضاً أكثر. فتحنا أبواباً ولم ندخلها، قط. “نفس التوارد في الخواطر”. ولكننا دخلنا ،سويا، حديقة الغناء، وغنينا بصوت واحد مع عبد الرحمن الريح :”مين علمك حب الجمال…يا قلبي هوي واستلمك…ألعلمك ظلمك…”.ومع الفنان سيف الجامعة والشاعر الصغير عمراً، آنذاك، “عاطف خيري”:” أي صوت راجيهو صوتك وأي شريان فيك وريدي… يا نديدي..”. حلمتنا على أجنحتها، عاليا، ثورة الغناء، التي فجرها الفنان مصطفى سيد أحمد، وكانت في أوجها، فغنينا بصوتها المبحوح: “حاجة فيك تقطع نفس خيل القصايد – هاشم صديق”.. و”لسه بيناتنا المسافة والعيون… واللهفة والخوف والسكون- صلاح حاج سعيد”.. و”لمحتك قلت بر امن وبديت احلم- عبدالقادر الكتيابي”.. ثم”حميد” وجنونه مع “نوره”…وقاسم ابوزيد وإبراهيم شمو ويحيى فضل الله وعبد العزيز مكاوي.. وآخرين شكلوا “دعامات”ثورة الغناء الراسخة للفنان مصطفى… لقد كنا جزءاً من ذلك المناخ الفني الشجي.
وكان المسرح على الساحة”نل”، والسينما “تحت الصفر”…وكانت ضروب الأدب والفن السوداني الأخرى قد تفرقت بين “مهارب” شتى!!
وتحكي “هويدا عبود” على الهامش، بسخريتها المحببة، أنا كوكتيل وشخصية قومية: جعلية جموعية شويحية ريافية.. كل السودان.
وتقول: جدي لوالدي، أصلا، من منطقة”عبدوداب”ريفي”ود حامد”، هاجر من هناك تاجراً متنقلًا بحماره بين ضفتي النيل، وفي رحلاته هذه تزوج من فتاة في أم درمان، وانتقل بها جنوباً، ليستقر به المقام، لاحقاً، في منطقة” التُرعة”، واحدة من أقدم وأعرق” الديوم “السودانية، على تخوم مدينة “الدويم”، ثم انتقل، من بعد، بأسرته إلى منطقة “الهَلبة”، التي تقع غرب”التُرعة”، فأنجب هناك والدي “محمد إبراهيم عبود” وإخونه وأخواته.
ودارت الحياة دوراتها، لينتقل والدها “إبراهيم عبود”، وهو عصامي موسوم بالكرم، إلى أم درمان، ليتزوج، من والدتها “حليمة على الصديق”، وكانت امرأة ظليلة، تنتمي إلى أسرة كبيرة جذورها مغروسة في بلدة “السليمانية” على الضفة الغربية للنيل الأبيض، ما يعرف بقرى الجموعية جنوب أم درمان.
وعلى الهامش، عرفتني”وليد”دارفور، ساقته أقدار الدراسة، وطموح الريف، ورياح الهامش إلى المدينة.
وعرفت بأنني أنتمي إلى قبيلة “القمر”، من بطونهم، التي تعيش في”دار قمر”، ومن أبرز المناطق فيها: “كتيلة وأم تكينة وخور شمَام وحَـرازة”، وتعرف، أيضاً، بالمنطقة الجنوبية الغربية لدارفور. وهي مناطق غنية بالأرض والماء والكلا.. وإنسان وثاب، كما هي نتفتح مباشرة صوب منابع بحر العرب، ثاني اكبر رافد للنيل الأبيض.
كادت “هويدا عبود” أن تسألني سؤال صديقي وزميلي “لقمان عبدالله” الاستنكاري: “كيف، يا هذا، عرفت أن بالخرطوم صحافة وصحفاً وعالماً يضج ويسعى حثيثا ليعيش”، ولكنها حبست السؤال في داخلها!
انتهى التدريب، ومضت هي لحال أكاديمياتها في الخرطوم التطبيقية، ومضيت أنا أطارد الخبر الصحافي، ويطاردني، لحد اللهث، وظل وما بيننا: “لا زاد ولا مدو انحسر”، ولكنه لم يصب بسوء التغذية، أبداً.
بعد عام ونيف، طوينا المسافة الطويلة بين”كتيلة وأم درمان”. لقد بلغنا الحد الأقصى من القبول المتبادل، في خضم مناسبة زواج الأخ الحبيب، الصحافي الضارب: جمال عبد القادر البدوي، والأخت العزيزة لمياء ميرغني، متعهما الله بالصحة والعافية، في حي ودنوباوي.
ولكن كان ذلك أسفل “الجبل”، ليبقى السؤال الصعب كيف الصعود إلى القمة، والدرب محفوف بالمخاطر.. بعادات ضارة وموروثات غير حميدة. مكبل بقيود وسلاسل ثقافية واجتماعية تمشي بلا أرجل ولا ساق…وهناك حواجز نفسية، وتلال أوهام ما انزل الله بها من سلطان…ولا يسلم الدرب من أمراض مستوطنة أقلها فتكاً، تلك الترجمة الخاطئة لغريزة الشعور بالتميز بيننا شعوباً وقبائل وعلائلات…بل أسراً، في بعض الأحيان.
قالت بعناد معهود فيها: اترك لي مهمة الصعود إلى القمة، فقط، كن مملوءاً بي وبما هو بيننا. وقد كان.
“اليتيم ما يوصوه على البكاء”. كنت أراها مثل”سيزيف” تحمل ما بيننا تتسلق ثم تسقط.. وتسقط منها بعض الأشياء، ولا تكترث… و”تدافر..وتعافر” إلى الأعلى، ثم تسقط. تشد الساعد، وتحاول مرة أخرى الصعود، هكذا إلى أن حملتي بالعلاقة إلى “القمة”، في يوم مشهود.
وأي قمة بلغتها مع امرأة جسورة.. وفيها رقة الماء. تسعة عشر عاماً، عمر زواجنا الميمون، ظلت كذلك: جسارة..ورقة. أضداد تتحالف فيها فتصعد منها شرارة تجذبني إليها أكثر.
مررنا، في هذه السنوات، بكثير من المطبات، بالطبع: باردة وساخنة، وكل المواسم، من صيف إلى خريف وما بينهما من فصول. ووقعت كبوات. تشاجرنا كثيراً، و”مرات بحردك وما بحمل براك”، ومع ذلك ظلت حياتنا الزوجية راكزة على أساس حب متين بيننا، وثقة مفتولة بعناية تملأ العين.. حياة زوجية نراها تستظل بشجرة وارفة بالتراحم والتوادد، والإحساس المتبادل.. وبالآخر.. وكانت حياة تمضي بخوف عليها من نوائب الدنيا ورزاياها، يصل حد الرعب… ثم كانت حياة أقرب إلينا من حبل الوريد. أعطتنا”هويدا عبود”، أنا وأبناءها البررة الأربعة: لنا 18 عاماً، ورؤى 15 عاماً، ومحمد 12 عاماً، وأحمد خمسة أعوام ، بإيثار وجلد، بكل ما تملك، وبكل قوة.. وشعور مرهف وحس رفيع… وعيون زرقاء اليمامة.
من أجلنا، كانت أول من تغادر النوم صباحاً، وآخر من تقبل عليه ليلاً. في المقابل لم نعطها من “زينة الحياة الدنيا”شيئا مذكورا. أكثر ما أعطيناها كانت وعوداً لم تتحقق. ظلت في نطاق”سيكون “و”سنفعل”.. أو هكذا أظن، إلى أن خطفها الموت، بالحادث المشؤوم… و”الموت ما بخبِر”، على رأي شعبي سديد.
كانت تحمل عني كل الأعباء، وكانت بارة، مثل: النيل نتدلق فينا، وفي أهلها، كانت”الاوبنين ليدر”، وملاذاً آمناً للجيران، في مجتمع أحياء سكناها في ضاحية “الفتيحاب”.
فقد كانت تعرف كيف تمسد لهم همومهم النافرة. ولن أنسى قصص وحكايات كانت بيننا، تتجدد تكسر رتابة الحياة السودانية. كنت كلما أدخل في المساء ولا أجدها أمامي، أسال عنها أبناءها: وين”عشة أم كبك”- وهي، كما يقال، امرأة ترتدي زيها، كيفما اتفق، وتنتعل حذاء من ماركة “الكبك”، في مشهد درامي، لتعمل، من بعد، بكد وجلد- فيضحكون، وتسمعنا هي من مكانها داخل المنزل، وتضحك ملء صوتها المبحوح، وروحها الطيبة، ثم تتوعدني على طريقتها: “اصبر لي”، فتتجدد الحياة في منزلنا المنهك، أيضاً، بمشاغل الحياة ولوازمها المعقدة، كسائر المنازل السودانية.
كانت هي كذلك فانتهت، ولكننا لم نغادرها. نراها في كل شيء: في الناس من حولنا، ووجوه الناس، وفي أماكن ارتدناها معاً، وفي كل شبر داخل منزلنا، وفي فوح عطرها المفضل”الجستتي”، وهو لم يبارح ردهات منزلنا بعد، وفي كل ما تركته من أشياء… وفي نعناعة شلتها في”اصيصة”، كانت تقطفها، مع كل صباح، لتصنع لنا منها الشاي المنعنع.
موتها مصيبة كبرى، وأمر جلل، وامتحان صعب، وليل طويل علينا، ولكنه أمر الله النافذ، إنه القهار الجبار، بيده كل شيء، نحن منه وإليه، هو من أعطى وهو من أخذ… و”كل نفس ذائقة الموت”. صدق الله العظيم.
هذا وقد حملت”لنا “بعض عقلها وبعض جسدها ودفعت بنفسها في الجامعة، و”رؤى ومحمد” استأنفا الدراسة في مدرستيهما، و”احمد” باشر الروضة، وواصلت أنا عملي.
مع ذلك، يدخل “أحمد” في الصباح الباكر في بكاء شديد، حتى يرقد الملح على خده، وينادي: (عايز ماما)، فيبكي الجميع، أبكي أنا صامداً، وأدخل معه في حوار صعب، أقول له الحقيقة المرة وأقدم له محفزات، فينسى ونواصل الحياة بقوة، وبما فينا من حزن وشعور بالضياع.. وببعض خيارات اجترحناها للمكابدة والمواصلة.
هي خيارات تتضاءل إمام خيار الموت، الذي هو واحد، فقط: القبول والتسليم به. ولكنها، أيضاً، خيارات تقع في باب الشيء أفضل من اللاشيء. لن نستطيع أن نقبض الحياة، فهي التي تمسك بتلابيبنا، وسننتهي وسنتوقف نحن، في يوم ما، لتمضي هي في دوراتها المعهودة.
” هويدا عبود”، الآن، في البرزخ ، لا مال ولا بنون، وإنما فترة انتقالية ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة.. فهي بإذن الله أقرب لله منا.
وهي هناك، نسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة لها، وأن يسكنها فسيح الجنات، وأن يلزمنا، الصبر وحسن العزاء في رحيلها الصدمة، وجزاء الإحسان لكل من شاركنا الأحزان بصدق، من الأهل والأصدقاء والزملاء والجيران من العاصمة والولايات.. ومن خارج السودان.