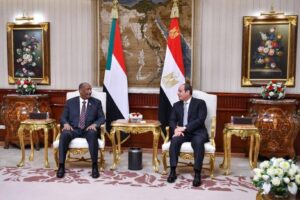حول اللياقة للحياة وبعض الكليشيهات الأدبية

الإهداء إلى راضي النماصي
تصبّحني كل يوم عبارة “صدر كتاب كذا وكذا”، وعشرات من صور هذه الأغلفة التي تعرفونها، تلتقطها كاميرا الجوال بجوار كأس قهوة (أسمّيها: كأس قهوة، وهذا الأمر له علاقة بذلك المدقق المعشش في تجاويف دماغي)، ودائماً يكون من الصعب الحصول على فهرس الكتاب ونبذة نزيهة عن فحواه أو العثور على مراجعة جادّة يمكنني أن أخمّن منها: هل يصلح هذا الكتاب للاقتناء أو لا؟ (أستثني هنا كتب المؤلفين الذين جازوا القنطرة، أو الذين أكون منجذباً إليهم في حالة مزاجي القرائي المؤقت)، ويصل إلي سؤال على رسالة خاصة في تويتر أو فيسبوك: ماذا أقرأ؟ أو: ما الحال المناسبة لصقل الإبداع؟ وسأشرع في التعامل مع هذا الاستفسار الأخير.

أتذكر الآن نقاشاً دار بيني وبين مجموعة من الكتّاب الشبّان (من أولئك الذين يلبسون الأطقم الضيقة جداً، ويتمتعون من المرونة بما يجعلهم يشعرون بالاستمتاع بذلك، بل بالذكاء الفائق، ويرمقونك بضيق حين تقاطعهم، وهم ليس لديهم أدنى قدرة على ملاحظة أنفسهم حين يقاطعونك)، وكان اثنان منهم يجادلانني في فكرة من قبيل: ما مكمن قوة الإبداع الخلاقة؟ (نعم، لا مشكلة لدى شاب لا يزال يحظى برعاية والديه، ويسافر للمتعة أو لجلب الشهادات، ويقرأ بعض كتب الدور الشامية والعراقية ونحوها، التي تغرق السوق بالترجَمات.. لا مشكلة لديه في أن يختبر لياقة ذهنك بأسئلة كبرى عن الكون والنفس والإبداع، وهو يريح ساقاً على ساق، وينظر إليك باستخفاف، منتشياً بأنه يحاصرك من جميع الجهات).. وكنت أرتجل إجابة على قدر حالي: إجابة شخص ناقص اللياقة، مثقل بالمسؤوليات، “شخص” فقط، لا هو مبدع، ولا أكاديمي شهير، ولا نجم من نجوم السوشال ميديا، ولا قارئ عظيم، ولا رجل وسيم، ولا محب للقهوة. كانت الإجابة: أرى أن قوة الإبداع (وأنا أقصد الإبداع الكتابي طبعاً، فلست تشكيلياً، ولا أفهم شيئاً في الموسيقا) تنشَطُ بين الذاكرة الضعيفة والقراءة السيئة؛ فالذاكرة النافذة والقراءة المتفحّصة تعوقان صاحبهما عن ممارسة الكتابة المُحْكَمة، ولذلك أظن أن كثيراً من النصوص العبقرية صيغت في غمرات إلهام اجتاحت كاتبها؛ واستطاعت أن تبعث الروح وتحيي العظام في جسدٍ من ذاكرة كليلة وقراءة كسيحة، لينتفض ويصبح خلقاً جديداً.
حدث هذا ذات صباح بارد، قبل ثلاثة أعوام تقريباً من الآن، وبعد نحو أربع سنوات من وفاة والدتي، التي فاضت روحها في دور سفلي كنت أستأجره في تلك إحدى العمائر، التي كان يمتلكها أيتام، يتصل بي وكيلهم من جوّاله النوكيا أو أتصل به من جوالي السامسونج لنناقش إصلاحاً في البلاط، أو عطلاً في الدينمو، أو كيفية تحصيل قيمة فاتورة الماء من جيراني الذين يسكنون الشقق العُليا.. وأرجو من القارئ ألاّ يعجل؛ لأنني سوف أبيّن له (حالاً) العلاقة بين ذكرى وفاة والدتي وبين هذه السطور: لقد كنت أظن، قبل وفاتها، أنّ الإبداع الجيّد يفرض نفسه ويحقق شروط بقائه، وأن القراءة الدقيقة والذاكرة الحديدية كفيلتان بتهيئتك لتفعيل موهبتك الكتابية الكامنة.. أمّا كيف توصّلت إلى هذه النتيجة (التي قلتُ قبل قليل إنني ارتجلتها أمام ذينك الشابين، وليس هذا تناقضاً)؛ فذلك كان انسراباً خفيّاً ما فتئ ينساب إلى قناعاتي شيئاً فشيئاً، مثلما يزحف الكُرْه كالثعبان إلى مكمنه في قلب المرأة التي يواصل معشوقها الوحيد في العالم ضربها مرة بعد مرة، طوال أعوام، حتى أصبحت ذات يوم، ووجدت أنها (ويا للدهشة) أزمعَتْ فِراقه إلى الأبد.
والآن: ما الضربات التي توجهها إلينا الحياة، وتكون كفيلة بتغيير نظرتنا الواثقة النقية إلى الفن والإبداع (لا أقصد بالطبع ذاك السؤال الكليشيهي التافه الذي يمكن أن تصدح به في أذنك قناة mbc fm، وأنت عائد من العمل مساءً تحديداً، فهذه الأسئلة قد تكون محرمة في عُرف الإذاعات في وقت الصباح، بل أقصد: ما الضربات التي توجهها إلينا الحياة المحسوسة التي يكون الأدب جزءاً منها وبها يتأثر، الحياة التي تكشف بوقائعها المتنوعة من محيط الأدب ومن خارجه: أخطاء قناعاتنا الأدبية الـمُشرِقة)؟
لقد كنت مولعاً دائماً، قبل وفاة أمي، بالاعتماد على ذاتي ووعيي، فيما يتعلق بقناعاتي الأدبيّة، فما يخيّل إليّ أنه هو الصواب، يظل صواباً غير قابل للدحض (لاحظ عبارة: غير قابل للدحض) حتى يأتي ما يدمغه.. وهذا الولع، الذي يمكن لأي قارئ في فلسفة الاستدلال في العالم المحسوس أن يسخر منه، كان يكتسب لديّ حصانة الدليل القطعي= عندما أدخل به إلى عالم الأدب.
كنت أرسل وعيي إلى الآثار الإبداعية، الآثار التي تتشكل من خلال وعيي نفسه لها، ليستجليها هذا الوعي، ثم أعود بها إلى وعيي الخاص ذاته (التكرار متعمّد)، ويكون نتاج وعيي من وعيي وبواسطة وعيي هو حكمي النهائي عليها ما لم تضرب ذلك كله صاعقة تحرقه وتقضي عليه، وكنت مقتنعاً بذلك شديدَ الإيمان به، كما أنا مقتنع الآن بأن الشمس ستظل تشرق إلى الأبد، ما لم تطلع من مغربها.
هكذا كنت (ولا أخفي عنك أنني أستغرب من استطاعتي صياغة هذا الاعتراف الشاق بهذه السلاسة، في نحو من 700 كلمة).. أما الآن فلا؛ لقد اتضح الممكن من المحال، فالقوانين الفلكية ستظل موجودة، حتى وُلد بنو آدم على هذه الأرض، بسبب أي آفة من الآفات الجينيّة، بلا عيون ولا قدرات حسابية، لكنني، على رغم تخلصي من المحال، أظلّ في حيرة من أمري، (بعد أن فقدت أعز أصدقائي قبل سنة واحدة، دون أعرف لذلك سبباً) والمـحارات تختلف عن المـُحالات؛ يحيّرني أني ممزّق بين خمسة عوالم مصطرعة متجاذبة، ومع ذلك يتحتّم على العقل الذي يتفاعل في دماغي الصغير أن يعرف ما يصدق من معطياتها وما يكذب، وأن يبرم الصلح بينها، ويحملها على التعاون والتفاني في عمَل مشترك (اصطلاح ركيك آخر)، وهذه العوالم هي: السمع، والبصر، والذاكرة، والخيال، والحُلْم.. ولأبدأ بهذا الخامس الأخير، متراجعاً منه إلى البقية:
تراودني أحلام شتّى (ليس في هذه العبارة السطحية فائدة؛ فهذا ما يحدث لمعظم البشر، لكن السياق يقتضيها)، على سبيل المثال: أرى أن زوجتي تضع طفلاً، وأني أحمله، وأزيل عنه المشيمة بظفري (كما ينبغي أن تُزال بالمشرط)، وأنه يتنفس، ثم أشك أنه مات، لأنه لم يستهلّ (الاستهلال لفظ عربيّ بليغ، يعني: بكاء الطفل غالباً. وهو في اصطلاح الفقهاء علامةٌ على حياة المولودِ نص عليها الشارِع الحكيم، وتتعلق بها جملة من الأحكام، كميراث الوليد والجناية عليه وتسميته وعقيقته، والعقيقة هي التميمة في الاصطلاح العرفي للّهجة المحليّة، نعم أُدرِك أن هذه أيضاً معلومة مبتذلة، ولكن من يدري؟ فالموادّ الفقهية آخذة في النضوب من الحياة، والتفاهة والجهل ينتشران، على نحو يبعثني على المخاطرة بتوضيحها بين قوسين، في تدوينة أو قصة أو ما تشاء أن تسمي به هذا الشيء الذي أنت تقرؤه الآن).. وأتململ في مضجعي، وأنقلب على جانب آخر، فأرى في منامي أيضاً أنني في بلاد بعيدة، في صحراء، وأني أدخل خيمة واسعة، فارهة، جميلة، مفروشة بأثاث بدويّ نفيس، وفجأة: تدخل عليّ فيها قِطعة من الجنّة، وتبزغ من الأرض زهور يعانق بعضها بعضاً.. وأستيقظ، فأتذكر قصيدة لعبدالرحمن شكري أحفظ بعض أبياتها بتحريفٍ، ويخيّل إليّ أني قرأتها قبل 25 عاماً في كتاب لمحمد غنيمي هلال، وأبحث عنها في الكتاب فلا أجدها، وأعود إلى ديوان عبدالرحمن شكري، فيخرج إليّ البيت على وجه صوابه، وفي أثناء ذلك أفتح مقطعاً من فيلم معادي المسيح، وإذا بمشهد قريب من وصف الحديقة في بيت القصيد، وأستمع في السيارة إلى قصة لبورخيس، يحلم فيها رجل بأنه في الجنة، ويصحو وفي يده وردة منها، وفي منتصف القصة التي تتلوها أدوس على المكابح بكل قوّتي؛ فهذا حادث مروريّ مريع، يتحول به الإسفلت إلى أرضية مسلخ، بسبب سوء تقدير فتىً يعتقد أنه أضبط من فيثاغورس ساموس وأمهر من مايكل شوماخر، وعند ولوجي مدخل البناية التي توجد فيها الشقة البسيطة التي أحرّر فيها البحوث والتقارير الصينية المترجمة= ألاقي العامل الذي يسبقنا جميعاً إلى الحضور وهو يعلّق على الحائط صورة وردة داكنة، على خلفية بنيّة باهتة، تشبه مجسّم الوردة الذي يشغل الدوّار في القرية التي أسكنها شمال غرب الرياض، والتي أويت إليها فراراً من الزحام، وأستقر على المقعد وأخلع معطفي، وألتفت إلى هاتفي الهواوي الجديد، هذه ثلاث رسائل sms لمكافآت فائتة (الصواب: مكالمات فائتة)، وفور أن أرفع السماعة أفهم الآتي: انقطعت الكهرباء بعد خروجي من البيت، وهو أمر معتاد جداً في هذه القرية، والمودم معطَّل، وانقطع إرسال برج الاتصال، ولذلك لم يستطع أحد أن يبلغني بالحدَث الذي كانت كل الإيماءات تحاول تحذيري منه منذ البداية: لقد قضم الباب الفولاذي إصبع ابنتك مرة أخرى..
هذه ليست مصادفات، بل هي الحياة، بكل تفاصيلها المزعجة التي أعيشها، وهكذا هو “العالم كما يحدث لي”.. والآن: كيف لي أن أشرح كل هذا، وأبيّن علاقته بالقراءة وتشكلات أجنّة الإبداع، لشابّ يجلس قبالتي باستخفاف، في مقهى مسرمك، على مقعد معدني أو بلاستيكي، يزعجني مرأى جذعه المضغوط كجذع الرجل الأخضر في قميص شادّ يكاد يتمزق عنه، وسروال داخلي شفاف ذي خيوط مربعة يظهر من وراء بنطاله الرمادي الهابط إلى أسفل حقويه، وحذاء صندل بساق وركبة مكشوفة يتظاهر فيهما بأنه لن يعبأ بالبرد ولو نفيناه إلى سيبيريا أو ألاسكا، إن الفتى غير مستعد للاستماع، لم يجرّب النوم مبكراً لمجرد محاولة التخلص من عذاب الإرهاق العائلي، مقتنع بأن مباهج الحياة مكبسلة في السفر وإحراز اللايكات، لا يأوي إلى الفراش متوجساً من هجوم الحرقان عليه وصعود جرعة الحليب إلى مريئه، يرى السيارة اختراعاً صُنِع للمباهاة والتحدي، وإخافة الصبيان، وقتل القطط والكلاب.
جهاز بالغ الكفاءة للاستهجان يسألني: ماذا أقرأ؟
“اقرأ سورة البقرة يا بُنيّ”.