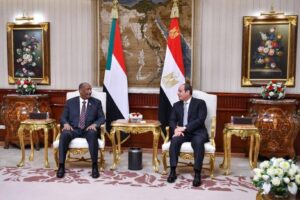الأولويات الانتقالية لثورة السودان-والباب (البجيب الريح)

قوة الشعب الأعزل:
في رائعته (الحرب والسلام) يروي (تولستوي) أنه عندما دخل (نابليون) موسكو بعد أن أخضع معظم أوربا لسلطانه- بما فيها إيطاليا مركز المسيحية وألمانيا مهد التنوير المسيحي- استغرب من كثرة الكنائس في موسكو وكأنه توجس شراً غامضاً بحسه النفاذ وحاسته الأمنية التي تشم رائحة المخاطر العسكرية. فكنائس موسكو لم تستقبل الجيش الغازي بأجراسها وصلواتها المرحبة، بل تحولت إلى مأوىً للجنود المهزومين وللمشردين والسكارى وصارت مخازن للمؤن والسلاح.
لم يأته رجال الدين مسلِمين للغازي المنتصر، كما توقع وكما فعلوا في بلدان أخرى اكتسحها نابليون. وكان توجس (نابليون) في محله. فقد أحرق رجال الدين الكنائس ومخازن المؤن وشاركهم في ذلك السكارى والمشردون والهائمون في الطرقات بلا مأوى والجنود المنهزمون والفارون من زحف (نابليون). اشتعلت موسكو كلها نيراناً في وجه الجيش الغازي واحترق حتى مبنى الكرملين حيث كان الامبراطور يتجهز لاستقبال علية القوم ليسلموا على الفاتح العظيم ويتبوؤا المراكز التي يجود بها عليهم.
قاد التدين الفطري، البعيد عن التسييس، وحب الوطن الصادق المجرد عن كل نزغ حزبي أو طائفي، جموع الشعب الروسي لتحديد الأولوية الوطنية الأهم وهي دحر الجيش الغازي لا الاستسلام له. لم يخطر ببال الامبراطور الفرنسي الغازي ولا الامبراطور الروسي المتقهقر أن الجيش الفاتح سينهزم – لا بقوة الجيش الروسي – ولكن بإيمان الشعب الموسكوفي وبسلامة فطرته وحبه لوطنه ولإدراكه لأولوياته الوطنية عندما يكون الوطن كله في مهب الريح. هذا الإيمان الجماهيري العارم لم يحترق مع الكنائس – مهد العبادة- ولم يتبخر مع زعيق المتدينين الأجوف الذي يصل إلى عنان السماء في السلم، ويتحول إلى شعارات خاوية حينما يتعلق الأمر بنهب قوت الدهماء والضحك عليهم.
إن الدرس المستفاد من ردة فعل المواطنين الروس البسطاء على هتك بلادهم هو أن تكامل الشعب والأرض هو صمام الأمان لبقاء أية دولة يتهددها خطر الزوال بسبب عبث أبنائها أو طمع أعدائها. ولن يكون أيٌ منهما بخير إذا تخبط الثوار أو قادتهم فضاعت أولوياتهم الثورية.
وبذات الأسلوب الذي تحدث عنه (تولستوي) قهر الشعب السوداني الأعزل نظاما قويا صلباً قام على الصخب الديني الذي يصم الآذان، أكثر منه على الوطنية الصادقة أو قيم العدالة والحكم الرشيد القائم على مخافة الله. لم تكن الثورة الجماهيرية ثورة يسار منظم أو فورة أحزاب تقليدية لها أتباع نمطيون. بل كانت ثورة كل شباب البلاد اليافع من كل حدب وصوب والذين حركتهم الفطرة السليمة تماما كما حركت أهل موسكو ضد جيش نابليون. فلأول مرة في تاريخ السودان صام مئات الآلاف من الشعب السوداني الأعزل شهر رمضان وصلوا العشاءين والتراويح في ساحة القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية لا يفرق بينهم حزب ولا لون ولا عرق ولا جهوية. وكان إجماعهم خالصا وصادقا لا تحزب فيه إلا للوطن والديار. ولذلك حينما دهمتهم جهات مسلحة حتى النخاع وطحنتهم بآلتها العسكرية في ليلة القدر من شهر رمضان الكريم ذلك العام استشهد أبناء الشعب الأعزل من مختلف الطبقات دون أن يزعم أي حزب أو فريق أنه هو من قدم الشهداء. بل إن الشباب السوداني الأعزل هو الذي قدم القرابين فداءً للوطن وللأمة كلها.
فالثورة إذن ثورة شعب لا ثورة حزب ولا فصيل ولا فئة. وتغول أية جهة أو جهات على الثورة سيضر بمسارها ويعيق وصولها لأهدافها الوطنية النبيلة. ومن هنا فإن الخطر الحقيقي على الثورة يتأتى من محاولة صرفها عن أولوياتها وقيمها.
وهنالك ثلاثة أبواب (تجيب الريح) كما يقول المثل السوداني ويجب سدها. والغريب أن الجهتين الأوليين متعارضتان فكراً ومتحدتان أسلوباً إلى حد كبير، وكلاهما يملك نخبةً معتبرةً من المثقفين الوالغين في علوم العصر الحديث في الإدارة والاقتصاد والمهن والعلوم المعرفية المعاصرة.
باب الريح الأول: الإسلام السياسي المخلوع
إن الإسلام السياسي الذي خلعته الثورة لن يستسلم للهزيمة. وهو واثق من قدرات منتسبيه وقدرات من يقفون خلفه من القوى الدولية الفاعلة في الغرب والشرق. وبسبب دعم هذه القوى بنى التنظيم استراتيجيته العالمية الطموحة على عدم فقدان أي رقعة من الأرض له فيها مصالح. بل والعمل على التوسع جغرافياً على حساب الشعوب الغافلة – وهم أكثر أهل الأرض بكل أسف.
ولهذا كلما كانت معالجات حكومة الثورة تقليدية ورتيبة وواهية وغير واعية بحجم ونوع التحدي الذي تواجهه، وكلما بقيت الثورة بلا أولويات واضحة، كلما غرقت حكومة الثورة في الوحل وأغرقت الوطن والشعب معها. فنظام (الإنقاذ) ليس هو نظام (عبود) أو نظام (نميري) رحمهما الله. لقد كان هذان النظامان نظامي حكمٍ سودانيين مرتبطين بالسودان وأهله أولاً وآخراً، أخطآ أم أصابا. ولذلك كان سقوطهما شأناً سودانياً داخلياً. أما بالنسبة لنظام (الإنقاذ) فقد أثبتت ثورة (هيلاري كلنتون) (الإسلامية) سنة 2011 ، والقدرات التنظيمية المستخدمة لإسقاط الرئيس الأمريكي الشعبوي (ترامب) بالضربة القاضية، أثبتت أن للإسلام السياسي يد طولى في قلب قيادة العالم الغربي. بل إن بوسع هذا التنظيم تحريك حلف الأطلسي بكل جبروته لتحقيق طموحاته لضرب مناوئيه. يتعين علينا أن ندرك بأنه لولا اختلاف ربابنة نظام (الإنقاذ) وزبانيته داخلياً لما سقط هذا النظام أبداً مهما طالت الاحتجاجات أو اتسعت.
إن الإسلام السياسي ما زال يملك من القوة ما يستطيع به تعطيل مسيرة الثورة بل وإجهاضها إن لم تصحُ من سباتها. ومع ذلك فللوطن جاذبيته وللحق نوره. وأكثر شباب الحركة الإسلامية وعقلائها من المؤمل والممكن أن يراجعوا أنفسهم ويلحقوا بركب الثورة إذا رأوا أن الثورة فعلاً تسير بمهنية وصدق في الطريق الوطني الصحيح، ولا تصادم عقائد أهل السودان وقيمهم العليا. فالوطن له حنين الأرض والطين. والحق قديم وله نوره وسحره وجاذبيته. وإلا لما وقف السكارى والمشردون الروس جنباً إلى جنب مع القساوسة وشتات الجنود المهزومين في وجه الامبراطور الجبار(نابليون) بعد أن انكسر الجيش الروسي النظامي وكادت الدولة الروسية أن تزول.
لقد ضيع (الإسلاميون) فرصة إقامة دولة الحكم الإسلامي الراشد في عصر الحداثة. فكوادرهم مؤهلة في الغرب أحسن تأهيل وشعاراتهم جاذبة, غير أن حب الدنيا تمكن من كل أفعالهم فقعد بهم وبالوطن والمواطنين. وبعد ثلاثين عاماً عجاف لم يشبعوا وأفقروا البلاد والعباد. وعليه فإن كل تهاون ثوري سيتحول إلى هوان وسيعيد النظام الفاسد بشكل أو آخر. كما أن عدم تحديد الأولويات الثورية والتنموية للوطن هو في الحقيقة ضعف وعجز سيعطل أي مكاسب مرجوة من الثورة. وفوق ذلك فإن كل معالجات تفرق الناس فهي تيه. والتائه لا يدري أيصل إلى شطٍ آمنٍ أم يهلك في لجة البحر أو الصحراء؟ ولنا في عدد من دول المنطقة عبرةٌ وعظة.
باب الريح الثاني: اليسار ومن والاه أو انبهر به
سعى (اليسار) في السودان لقطف ثمار كل ثورة شعبية لها جذور جماهيرية. وهو يستخدم ذات أسلوب خصومه من منظري الإسلام السياسي: الاستغفال والحشد الجماهيري والشعارات الطنانة وغيرها من الأساليب الغوغائية. وقد جرب اليسار هذا النهج تكراراً بدون تبصر فأضر بمسيرته وبالوطن وبشعبه. ولم يتفطن مفكروه لخطورة إعادة إنتاج خطيئتهم الساذجة. فبعيد ثورة أكتوبر 1964 تغول اليسار على (جبهة الهيئات) آنذاك وحاولوا إدخالها تحت عباءتهم فأفسدوا على أنفسهم وعلى الثورة وأمدوا الأحزاب التقليدية بجرعة الحياة بعد أن ذبلت. وأتاحوا لها وللإسلام السياسي فرصة الانقضاض عليهم فيما بعد بحادثة معهد المعلمين العالي والتي ينكر اليسار وقوعها أصلاً.
وبعد قيام ثورة مايو 1969، والتي شارك اليسار فيها بقوة، حاولوا جرها من مسارها الأقرب للقومية العربية إلى اليسار الأحمر فوقع انقلاب المرحوم/ هاشم العطا ورفاقه. وخسر الوطن بسبب هذا الانقلاب شبابا من خيرة ضباطه ومواطنيه وجنوده المخلصين رحمهم الله جميعاً وغفر لهم. كما جر اليسار ثورة مايو في أيامها الأولى لاتخاذ واحد من أفدح القرارات الاقتصادية الخاطئة في تاريخ بلادنا الحديث وهو قرار (المصادرة والتأميم) والذي ألحق بالاقتصاد السوداني ضررا كبيراً ومستداماً رغم ما بذل من جهود لتلافي الآثار الضارة لتلك القرارات المتسرعة.
إن أي محاولات لتحويل الثورة إلى ثورة فكرية تحاكم عقائد وأفكار أهل السودان بذريعة محاربة الإسلام السياسي فهي ستنتهي إلى قبض الريح حتى ولو هللت لها أوربا التائهة في انتظار هتلر جديد ،أو الغرب الانجلو- سكسوني الذي يتمثل في بريطانيا وأمريكا وكندا واستراليا ونيوزيلندا. وهذا الحلف أكثر تماسكاً من أوربا البلهاء ولكنه مثل فيروس الكورونا لا تُدرك له هوية ولا يكف شروره عن الخلق. إلهه الاقتصاد وكتابه المال وأهم قيمه الحرية الجنسية وقادته يلهثون وراء الرشاوى بعد أن وطنوها بأسماء عملٍ براقة كالعلاقات العامة ومكاتب المحاماة ووسائل الإعلام وكتاب الأعمدة والمنظمات (الخيرية) والإنسانية. ويعي الاسلام السياسي ذلك جيداً.
لم تفلح كل الكوارث التي مر بها الوطن السوداني الجريح في تدمير قيمه العظيمة الفياضة. فلا الإسلام السياسي بكل عنفوانه ودعائمه الغربية والعربية، ولا كل الفتن والمغريات المعاكسة انتزعت هذا الشعب من عقيدته السلسة والفطرية ولم ترد مسلما أو مسيحيا سودانيا عن عقيدته. كما أن التاريخ يثبت أن أهل السودان ما علاهم السيف حتى يصبحوا مسلمين أو طرقوا هم باب القوة لفرض دينهم المسيحي أو الإسلامي بالإكراه على غيرهم.
وستثبت الأيام أن محاولات ردهم عن دينهم وعقائدهم بمختلف الذرائع والأوهام الغربية والشرقية أو بدعاوى الحداثة ستتقطع أنفاسها ويهلك مروجوها قبل أن يروا ثمارها التي لن تأتي أبداً.
هذا اليقين لا يمنعنا من كلمة حق عن طواقم اليسار التي وليت أمر الناس (في أي عهد وطني مضى) فقد اتسموا بعفة اليد، والترفع عن سرقة المال العام. وقد كان من أوائل القرارات الموجهة لثورة مايو 1969(والتي كان اليسار متمكناً فيها في أيامها الأولى) قرار تحديد نوع المركبات المخصصة للحكام من قادة الثورة والوزراء. حيث تم يومها تحديد سيارات (الهلمان هنتر) للقيادات العليا للحكم وتقارن هذه السيارات اليوم ب(الكريسيدا) المنقرضة و(الكامري). (وعندما اختلفوا مع (نميري) رحمه الله كانوا يقولون عنه (راكب هنتر وعامل عنتر!). هذا الزهد اليساري واجب على كل حكامنا بالذات وأكثر حكام الأرض.
وللمفارقة عندما جاءت ثورة (الإنقاذ) (الإسلامية) لم تتبنَ نهج اليسار التقشفي، وكانوا أولى به. بل جعلوا الولاية مغنماً، والزكاة والضرائب مغرما وصار ولاة الأمر ومعاونوهم يتبارون في التباهي بركوب أحدث وأغلى موديلات السيارات الفارهة بينما يلتحف أبناء الشعب الثرى أياما وليالي ينتظرون وقود مركباتهم ويضطرون لشرب الشاي بحلوى (الدربس). ثم زاد الأمر سوءاً. وصدق رسول الله (ص) حين قال في الحديث المتفق عليه:
(لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب)
باب الريح الثالث: غياب أولويات الثورة وضعف الفاعلية لدى حكومة الثورة
إن الشعب الذي اتحد وأجمع على ثورة الجياع والمحرومين سنة 2019 لا يريد أن ينتهي به المطاف بعد الفترة الانتقالية وهو يردد المثل اليائس:
(أشبعتهم سباً وذهبوا بالإبل)
كانوا ينتظرون رؤية ثورية تجمع الشتات ، وتنير الطريق وحلولاً ثورية مبتكرة لقضاياهم الحيوية مع فاعلية في الإدارة والمعالجات الاقتصادية بالذات. كانوا يريدون محاكمات ومحاسبات حازمة وعادلة ومحكمة وتستند إلى الأدلة والبينات ترد الحقوق المنهوبة والضائعة بعدل وحسم وتطال كل من اغتال المال العام أو الحق العام أو الخاص.
حار الناس من وقوف حكومة الثورة عاجزة أمام الأولويات الثورية والمهام الكبرى الموكلة إليها وعلى رأسها كبح جماح الثورة المضادة والفاسدين من استنزاف الاقتصاد الوطني وحرمان الشعب من ضرورات الحياة الأولية. ويتعجب الكل من انشغال حكومتهم عن القضايا الحيوية بمحاكمات تظاهرية ذات طبيعة سياسية، بينما جرائم (الإنقاذ) ذات المردود المالي والتي تضرر منها ملايين المواطنين أفراداً وجماعات ومست لقمة عيشهم، مطمورة، وأموال الوطن المسروقة تستخدم لمحاربة ثورته. ومع كل الوهن والسلبية تغيب المبادرات الاستثمارية التنموية الخلاقة التي تعمل على إعادة مئات الآلاف ممن هاموا في الأرض وهجروا ديارهم وهم كارهون. لقد ترك أكثرهم ديارهم مكرهين. فمن تسنى له العيش في وطنه فهو لن يغادره طوعا ليعيش في مكان آخر (ولو كان هذا المكان جزءاً من وطنه العربي أو الإفريقي الكبير):
لو لم يجد في عشه ما يكرهُ ما غادر العصفور أبداً وكرهُ
لقد سمع الناس كثيراً عن قدرات الخبراء العالميين الأفذاذ الذين تمت الاستعانة بهم لإدارة الفترة الانتقالية. ويسمعون أيضا ًأن العسكريين(يفرملونهم). ولكن هذا المنطق معوج. فلم يسمع الناس باستراتيجية أو خطة أو مبادرة اقتصادية ثورية أو أي قرار حاسم اتخذه مجلس وزراء الثورة الموقر لنصرة شعارات الثوار وعطله العسكريون. ولم يطرح مجلس الوزراء الموقر أو وزير في وزارة مهمة مبادرة عامة تمثل خارطة طريق واضحة فعطلها العسكر أو المجلس العسكري.
وخطورة ضعف أداء الحكومة الانتقالية أنه بعينه هو الذريعة التي قادت لإسقاط التجربة الديمقراطية مرتين منذ الاستقلال. فالإنسان السوداني بطبعه يحب في قيادته القوة ويريد قيادةً صاحبة قرار وواثقة من نفسها. ولكن بعد أكثر من عام تعيش الثورة والثوار واقعاً عجيباً:
حكومة عالية التأهيل وضعيفة العطاء. وغير واضحة الموجهات. وعسكر لا يُطمأن إليهم ولكن لا غنىً عنهم للمرحلة. وغاية ما يخشاه الناس هو أن تكون حكومتهم تعمل على قتل الوقت حتى تنقضي الفترة الانتقالية وبعد ذلك (الله كريم) على الوطن والشعب. أما الخبراء الأجلاء فسيعودون لمنظماتهم الدولية المختلفة ومراكزهم المتميزة في العالم الأول.
وفي جميع الأحوال فإن الخوف هو أن تمهد رخاوة الحكم _دون وعي- لحكمٍ عسكريٍ ثالث بذريعة فشل المدنيين في إدارة وحفظ الوطن وشعبه من الضياع كما حدث في المرات السابقة.
مستشار قانوني وخبير تنمية مؤسسية