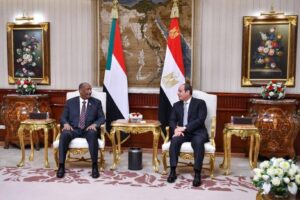نحو وطنٍ سودانيٍ بلا أطرافٍ مهمشة (1)

في البدء: لنسأل ربنا التوفيق حكاماً ومحكومين:
أبدأ مقالي هذا بالابتهال لله العلي القدير أن يكتب (التوفيق) لهذا الشعب الأبي وقياداته، ولهذا الوطن الشامخ وأبنائه للخروج من عنق الزجاجة إلى ساحة البناء الوطني والتنمية المستدامة ليودع سني يوسف (عليه السلام) والتي طالت واستطالت على هذا الشعب الأبي الصامد وهو في انتظار عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
فالتوفيق عزيز لا ينال في ركام خطايانا وتقصيرنا واغترارنا بما نستطيع أن نحيكه من دسائس ونحبكه ونفتريه من مكر، باسم الإسلام نفسه أحيانا، ولأجل المصالح الخاصة في أكثر الأحيان. وبفضل ما آتانا الله من تدبير مدعوم من جهات كثيرة تتربص بالوطن، فنحن قد نقلب الليل نهاراً والنهار ليلاً، ونغرق الشعب والوطن في بحار من الظلمات والخبال، تتخبط فيه فلا تصحو إلا على انبعاث الدجال، أو خروج الدابة. والتوفيق منحةٌ من الله نادرة لم يرد إلا مرة واحدة. بين كلمات القرآن الكريم التي تزيد على 77000 وذلك في قوله تعالى على لسان نبي الله (شعيب): ﴿وما توفيقي إلا بالله﴾: آية (88) سورة (هود).
ولعل الناس يذكرون كيف استهل الإمام الراحل الصادق المهدي -رحمه الله- عهده بعد انتهاء الفترة الانتقالية السابقة بوصف شريعة الإسلام بأنها (شريعة القطع والبتر) من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو بعلمه الديني الغزير يعلم أن (فاقطعوا أيديهما…) آية في كتاب الله. ربما -والله أعلم- أن كلمته الغليظة وغير الضرورية هذه قد نزعت منه التوفيق الإلهي فخلفه في قاعة الأمم المتحدة وعاد بدونه. فالله جل جلاله أغير على دينه من كل خلقه. ودينه يقيم الحدود والقصاص على الجناة وذلك حكمه إلى يوم الدين.
وفي الفترة الانتقالية الحالية استهل الخبير العلامة الدكتور حمدوك عهده بالجلوس على سرير (الأستاذ) محمود محمد طه إيذانا بتحول السودان على يدي حكومته (المؤقتة) لدين بديل لدين محمد صلى الله عليه وسلم وهو دين (الرسالة الثانية) للإسلام. كان الدكتور الهادئ الرصين في غنىً عن ذلك. فأستاذه (محمود) لم يعدمه البشير ولا دخل لنظام الإنقاذ في قضيته فهي ليست من مقتضيات الفترة الانتقالية بأي حالٍ من الأحوال. كما أن الخلل السلوكي لنظام الإنقاذ باسم الإسلام جُرمٌ ارتكبه أهله والإسلام بريءٌ منه. والفترة الانتقالية جاءت لتقتص من المخطئين لا لتدخل أهل السودان في دين جديد. فكل مسلم يؤمن بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم يعرف كيف أخطأ أهل الإنقاذ في حق أنفسهم وفي حق الإسلام الذي لا يخفى حتى على من يقدح البعض في دينه. فقد أوجز أبو العلاء المعري وأحسن حين قال :
سبِح وصلِ وطُف بمكة زائراً
سبعين لا سبعاً فلستَ بناسكِ
جهل الديانةَ من إذا عرضت له
أهواؤه لم يُلفَ بالمتماسك
وأجزم بأن ملايين المسلمين -بما فيهم شباب الحركة الاسلامية اليافعين – يبرؤون إلى الله مما ألحقته الإنقاذ من أذى بالإسلام والمسلمين دون مبرر سوى حب الدنيا وزخرفها الزائل. والمسلمون لن ينتهزوا الفرصة ليخلعوا قميص الإسلام الحق فيلقون الله غداً وقد تسربلوا بأديان ختمها الله بالإسلام أو اعتنقوا الرسالة الثانية ل(لأستاذ) محمود محمد طه، أو بأيٍ من الملل والنحل الحديثة التي وطنت بعضها المخابرات الغربية في الشرق المسلم بمسميات لماعة وباطنٍ سقيم يتجرد من كل خير إلا نهب الدنيا وانتهابها ولو بسفك الدماء المعصومة.
لعل الله سلب كلا الرجلين التوفيق فذهب حلمهما وضاع علمهما حتى في مجال تخصصهما المحض الذي نهلا منه في الغرب المتقدم. ثم اختار الله أحدهما لجواره الكريم وبقي الثاني يحرث في البحر ولا ندري ما ينتهي إليه حرثه. وكم لله من آيات في الأنفس والآفاق تمر علينا وقد لا نعتبر.
ليحترم بعضنا بعضاً ولنستمع لبعضنا البعض
يقول ابن عربي رضي الله عنه:
(لن تبلغ من الدين شيئاً حتى توقر جميع الخلائق ولا تحتقر مخلوقا ما دام الله قد صنعه)
وعن حسن الاستماع يقول:
(السماع منشأ الوجود فإن كل موجود يهتز)
فحسن الاستماع من أعظم المميزات- وخاصة لدى القادة والمتصدرين لحركة الحياة- لأن حسن الاستماع يعين على التقاط زبدة ما يقال. وبالمقابل فإن من أعظم الأدواء التي يبتلى بها الأفراد والأسر والجماعات والقبائل والشعوب تلك الحالة من التعجل في القول والإسراع في التخالف مما يجعل الكل يصرخ برأيه ووجهة نظره والآخر لا يكاد يسمع له لأنه يعد الاستماع للآخر ضعفاً، أو يمثل خطراً على رأيه السديد!!! ولهذا هجا أبو الطيب المتنبي- رحمه الله- الناس لما يعشقونه من الخلاف والاختلاف حتى على الخلاف نفسه:
تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم
إلا على شجبٍ والخلف في الشجبِ!
وشجب الغرابُ إذا ناح. والمشجب ما تعلق عليه الثياب أو غيرها من الأشياء. ومن عجائب اللهجة العامية السودانية أن أهلنا اختاروا لكلمة (الشجب) ومشتقاتها مرادفاً يشبه الشجب نفسه فسموا المشجب (المشلعيب) أو (الكابدلو)!!.
لقد تراكم لدينا منذ الاستقلال كم هائل من ثقافة (الهرج) المدمرة. صحيح أن الله تعالى أعطى بعض العجماوات قدراتٍ غير عادية للتفاهم والفهم المشترك عبر الصراخ المشترك الذي يصعب على البشر مجاراتها فيه. فالطيور عند صحوها وقبل نومها تحدث من الصراخ ما تكاد تتساقط منه فروع الأشجار. ولكنها مع كل هذا الضجيج تفهم بعضها بعضا ويستقر كلٌ منها في عشه مساءً ويغادره فجراً بانضباطٍ وقل أن يخطئه. وكذلك ملايين الأنعام العائدة من مراتعها وصغارها في انتظارها وملايين الأسماك في البحار والشواطئ وملايين الطيور البحرية تملأ الجو ضجيجا وتفهم ما تضج به.
أتذكرون فتنة مناهج (القراي) قبل أيام؟ إنها نموذج لصخب سوق السياسة. أما كان من الممكن تدارك الأمر منذ البداية بتشكيل لجنة مهنية صرفة من المختصين لمراجعة المناهج قبل اعتمادها ودون إضاعة الوقت والمال في طباعتها حتى نوفر جهود العراك للبناء؟ ومهما اختلفنا مع الرجل في أمر فكري وديني عظيم، فالمراجعة المحايدة والعلمية للمناهج المدرسية المقترحة كانت ستكون عملاً مؤسسياً راقياً وحصيفاً وتمكينا للرأي الصائب. ولنوفر الوقت والمال والجهود ونوفر خلافنا الفكري مع الرجل لمجال العقيدة والمعتقد حيث لا يبيع دينه إلا شقي.
والدرس المستفاد: لنتوافق على ألا نختلف لمجرد الانتصار للرأي. بل فقط إذا لم يكن من الخُلفِ بدٌ.
ثالثا: لنضع الأسس لمعالجة النزيف الحالي في مواردنا الطبيعية ولنخطط للمستقبل
لا يخطئ أحدنا فيظن أن رهاب الغنى المعاصر الذي أطغى بعض العباد – مسلمين وغير مسلمين- هو ثروة. هذا (زخرف) الحياة الدنيا وهو زخرف سريع الزوال ولا يغني من الجوع إذا عض عضةً إلهيةً مما يرسله الله لتأديب البشر حين يطغون وتبطرهم النعمة فتخرجهم عن مسار الأدب مع الله والرحمة بعباده.
لنعلم يا أبناء الوطن الغالي أن الثروة زرع وضرع وإنسان يحفظ هذه النعم وينميها وينتفع بها وينفع، ويشكر الله عليها ويحسن استخدامها فتزدهر. إذا انعدم الزرع والضرع فلن تطعم الناس الثورة التكنلوجية ولا البترول ولا الغاز ولا طاقة الرياح أو الشمس. وستموت أمم وشعوب وقبائل في أوج عظمتها وتقدمها كما انطمرت أمم تحت قصورها، وفنيت أمم سابقة خلفت آثاراً مذهلة يعجز العالم اليوم بكل تقدمه العلمي والتكنلوجي من أن يقارب إنجازاً مثلها، أو حتى يفهم لغز إنجازها.
ما نراه اليوم من عراك اخواننا العرب وغيرهم في الشرق والغرب ممن أبطرتهم الثروات الناضبة، وما نسمعه من ضجيج الإعلام بأنواعه المتكاثرة، سيخفت خفوت صوت الدود في شقوق الأحجار الصماء إذا انعدم الزرع والضرع أو شح. ويوم تزول أو تشح هذه الثروات الحيوية سيكون السودان وشعبه أكبر الخاسرين. فيومها سيرى الغارقون في أوهام الجدل السياسي الأجوف بعيونهم الفناء الجماعي لأهلهم وأنفسهم كما حدث في المجاعة الشهيرة سنة 1306 ه .
علينا اجتذاب أهلنا العرب الأثرياء من أحفاد المهاجرين والأنصار للاستثمار في الزرع والضرع والبنى التحتية بلا أجندة سياسية ولا مذهبية ولا تحالفات ولا صخب باسم العقيدة أو الدين. فلقد أكرمنا الله بأن عشنا مسيحيين ومسلمين بأعلى قيم التسامح ودعوة الخير والسلم الاجتماعي. فمن يرغب في الاستثمار في زرعنا وضرعنا وبنيتنا التحتية فعليه الانشغال بقضايا النماء والبناء وتوظيف اليد العاملة الوطنية من ملايين الشباب المقتدر والمتعطل. وحتى الأعمال الخيرية يجب ألا نسمح لها بأن تتحول إلى سم زعاف بتدنسها بأجندات غير الخير والبر.
ومن هنا أناشد السلطات الانتقالية -والمدنية خاصة- الانصراف لإحداث معجزة اقتصادية كما فعلت رواندا ودول أفريقية وآسيوية أقل منا من حيث الموارد ولكنها كانت أكثر تصميماً وعزما ووضعت لعملها استراتيجيات وخطط وبرامج حشدت لها الدعم الشعبي وتكاتف الناس. عرفوا واجباتهم واستوعبوها وخططوا لتحقيقها وكسبوا رضا السواد الأعظم من شعوبهم. فالعاجز من يترك العمل النافع ويعتلي المنابر. ولن يكون السودان بخير ما لم يصمت السياسيون ويعملون، فتقل المنابر وتزدهر الزروع والضروع وتهدر المصانع وتتوسع الموانئ والمطارات والطرق وتتزاحم فيها وسائل الإنتاج والمنتجات الصادرة.
وأقول لأبناء الوطن العزيز: يا أهلنا الكرام الغارقين في جدل بيزنطي لا ينتهي: نحن أغني الناس بما حبانا الله من ثروات. فقد حبا الله جل شأنه السودان بشعب كريم سمح مضيافٍ (يعزم على المافيش). وحبانا تبارك وتعالى بأرض بكرٍ معطاءة وماءٍ مبارك من السماء ، وبالنيلين والأنهار العديدة وما في جوف الأرض من أنهار. ومع ذلك لا يخفى علينا أن مواردنا الأساسية هذه في خطر: إنساننا وأرضنا وماؤنا وهواؤنا وثرواتنا الحيوانية والطبيعية وما تحت الأرض من ثروات: تكدسنا في المدن المتهالكة حيث يشح كل شيء إلا الجدل العقيم، والغازات السامة، وصفوف الخدمات والأسواق الهامشية، وكل ما يدمر البيئة ويفقد المياه الجوفية صلاحيتها للاستخدام الآدمي. (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) 41 سورة الروم.
ولنا بإذن الحي الدائم عودة