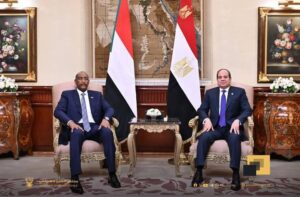عبد الله بولا: ذلك المواطن الممتاز الذي خلد


كم صعب أن تكتب شهادة شخصية عن إنسان كعبد الله بولا. فمثل بولا لا يقيم علاقة منفردة فقط مع تلامذته أو طلابه؛ بل تشتبك العلاقة وتتداخل بالبيوت، والأسر والأصحاب المشتركين، لتكتشف بعد قليل أن لبولا شهية اجتماعية لا قيود لها، ولا تحدها حدود.
عبد الله أحمد البشير، أو عبدالله بولا، أستاذي لمادة الفنون بمدرسة بحري الثانوية لعامين ١٩٧٦- ١٩٧٧، واحد من أهم القامات الفكرية والفلسفية والفنية بالسودان. تطورت علاقتي به منذ إضراب أو (دك) -كما يقال- حصة مادة الرسم أولاً، إلى حب للمادة بعد حوارات ممتعة بين طالب وأستاذه، كانت تبدأ من الفصل الدراسي بطرح الأسئلة الفلسفية الصعبة وقتها داخل أسوار المدرسة عن المادية والديالكتيك، لتخرج إلى العلاقة بين الفلسفة والفن والتشكيل والغناء والموسيقى، وتستمر عبر الأزقة والشوارع إلى منزلهم بالبيوت الحكومية الخاصة بالإداريين آنذاك بحي الأملاك بالخرطوم بحري، والتعرف على أهل بيتهم اللطيفين، جميلي المعشر. كانوا يقطنون هنالك في ذلك البيت الحكومي الذي كان مخصصاً للمرحوم والدهم أحمد البشير، المدرس والتربوي السابق بوزارة التربية والتعليم.
صرت أتعرف على أناس وبشر مختلفين زواراً ومقيمين، وأهل بيت نادري الصفات من إخوة وأخوات بولا، الذين يطلقون عليه داخل المنزل اسم “بابكر”، وصاروا ينادونني بـ “ود ناس أبوصلاح”. عندما بدأت علاقتي بهم؛ كانت قد سبقت ذلك خسارات مأساوية متلاحقة حسبما علمت. فقد غاب الأب والأم، والشقيق عمر، والشقيقة زينب، بنحو ترك أثره بادياً في الآخرين: عثمان، وأنور، وعلى الأصغر الذين رحلوا بالسنوات التي سبقت رحيل بولا.
بولا وبحكم شغف الأستاذ القادم إلى بيئة طلابية جديدة؛ كان يستعلم ويسمع عن الطلاب. حينها كنت ناشطاً بالجبهة الديمقراطية بالمدرسة وبالمكتب الطلابي للحزب الشيوعي. وأظن أنه سمع عني وقتذاك من قبل طلاب زملاء كانوا يترددون على مكتبه بحكم سيرته الثقافية والفنية.
أول ما رأيته رأيت شخصاً غريب الهيئة. رأيت رجلاً نحيفاً، طويلاً، كثيف الشعر، يلبس بنطالاً أسود اللون من النوع الذي كان يطلق عليه الشارلستون، ويرتدي قميصاً أبيضاً بجيوب بالجنبتين ولياقة عريضة مميزة، قميصاً يكاد يكون ضيقاً على ذات مقاس الجزء العلوي لجسم بولا. قلت في نفسي وأنا أشاهده من مسافة عن بعد، وهو يقطع ميدان كرة السلة المتوسط للمدرسة، يا له من شخص غريب المظهر يغري بالتعرف عليه وعلى عالمه. وكان أن سألته في تجمع بحوش المدرسة، ومعي عدد من الزملاء عن سبب النظارة ذات الإطار الطبي التي يلبسها دون زجاج.
جاءت إجابته غريبة وقتها، وبصوته العميق الواثق الذي لا يستعجل الكلام، بل يكاد ينتقي كل كلمة يقولها بعناية فائقة، إنه غير معني بالوظيفة الطبية الطبيعية لها، بل بما وراء ذلك. وذكر لي الوظيفة الجمالية للإطار في علاقته بطول وجهه، أي إن الفريم ربما يحارب نحافة وطول الوجه. كل ذلك فهمت فيما بعد أنه لا يصدر هكذا اعتباطاً بل تعبيراً عن أراء نقدية في المستعملات والمحيط بوعي تشكيلي يفهم الحياة كظاهرة تشكيلية.
أما بالنسبة للقمصان؛ فقد علمت فيما بعد أنه وعدد من أصدقائه كانوا يفصلونها بسوق بحري قرب محل العدني برسوم توضيحية مسبقة، لدى الترزي الحداثي الأشهر وقتها للباحثين عن الموضة كاميليو. لم يكن صديقاً لي فقط، بل صديقاً لمجموعة من طلابه، وأذكر منهم: طارق أبو سمرة، وكمال العاقب، والمرحومين عماد الدين حسن و عوض القاضي، كما كان بذات العلاقة بهشام المجمر وعاطف كروم ومحمد محمود راجي من الدفعات المتقدمة علينا. ومن دفعتنا: الفاتح حاج التوم، وهشام عمر النور، وعادل محمد عثمان، وكمال الزبير.
أذكر أن أول حوار فردي لي معه حول جدوى التشكيل بواسطة البشر ومقارنته بتشكيل الطبيعة؛ كنت مغرماً بالطبيعة والتأمل في تلك السن، فأذهب كلما ضاق صدري بمقاعد الدراسة إلى حديقة عبود غير البعيدة من المدرسة، وأتجول ببصري أتفقد محتوياتها من الزهور والورود، وأقضي جل الوقت تحت تعريشة للبوابة الجنوبية أتفرج على أشجار عنب متسلقة يابسة، تصنع يصنع بدورها أشكالاً متنوعة في غاية التعقيد من العنكبوت الذي كنت أتابع تكويناته بدقة متناهية، وأتابعه يوماً بعد يوم في انسحابات متكررة من الدروس.
عندما جرى حوارنا عن قدرات الطبيعة على التشكيل الطبيعي؛ اقترحت عليه الذهاب، وقلت له: “تعال نقارن بين صيدي، وما تقول عن الإنسان الخلاق”. نعم كنت جريئاً منذ نعومة أظافري مع كل من يكبرني سناً، خاصة أساتذتي، أقول ما أعتقده دون خوف ولكن بأدب، ربما كانت أولى محاولاتي في الرسم الإيضاحي هي رسمة كاريكاتورية بالطباشير على السبورة، وأنا بعد في السنة الثانية أولية أو ابتدائي، لرئيس وزرائنا الأسبق، إسماعيل الأزهري، وهو يمد بطنه (كرشه) بطريقة كلفتني عقوبة جلد لن أنساها من الناظر الاتحادي المتطرف وقتها، الأستاذ حسن عبد القادر (عليه الرحمة)، عندما دخل الفصل ورأى ما رأى، وسأل عمن يكون هذا، فوقفت ورديت عليه دون وجل او تردد بأنه اسماعيل الأزهري، ولم أدر ما ينتظرني.
الآن مع بولا أحاول جاهداً بمحدودية معلوماتي وقدراتي آنذاك أن أدافع عن قدرات الطبيعة الخلاقة التي كنت أظن أنها تتفوق أحياناً علي قدرات التعبير بالأشكال عند الإنسان، وما ترفده من دلالات ومدلولات. هزمني بالطبع أستاذي بمنطقه، ورفدني بمعلوماته عن قدرات الإنسان الخلاقة غير المكتشفة، وتحداني بأنني مثلاً أستطيع الرسم غير الايضاحي ، ولكنني أهاب التجربة فقط. دخلت التحدي معه أو التجريب قل، وبدأت بعدها بالرسم تدريجياً، ومن ثم وجدت نفسي مقرباً جداً له، ضمن أعداد من خلصائه من طلاب سابقين، يرتبطون به منذ المعهد وحنتوب الثانوية كمحطات مرت بها سيرته التدريسية. تعرفت على علاء الدين الجزولي الذي كان وقتها قد تم فصله مع هاشم محمد صالح من كلية الفنون، والذي كان بالمعتقل السياسي وقتها، وقد سمعنا عنه كنابغة من بولا.
بولا كان -وعندما يمدح قدرات أحد خلصائه خاصة هاشم محمد صالح وحسن موسى- يجعلك متشوقاً للقائهم، وتعرفت من ثم على بشرى الفاضل الذي كان بولا يكن له محبة ووداً ليس بعده ود، هو ومجموعة من طلاب بحنتوب لهم ذكريات وفتوحات من الأنشطة الثقافية هناك، يستطيع غيري منهم الكتابة عنها، خاصة جمعية طلائع الهدهد. وأظنه الدكتور النور حمد، أحد المقربين له من تلامذته، والذي لم ألتقه إلا مؤخراً في السنوات العشرة الأخيرة بالدوحة، ونقلت تلمذتنا المشتركة لبولا، وإن كانت بمراحل مختلفة لدرجات أعلى وثقة أقوى.
بشرى الفاضل أول ما التقيته -بعد أن سمعت عنه من بولا- بمحل لنحات ببحري اسمه سيف، لأكتشف بعدها سكنه لفترة بغرفة نائية صغيرة بمنزل أسرة بولا. بعدها صار -وبحكم ترددي على البيت- تعارفاً بيني وبين الماحي، وفتح الرحمن باردوس، وحسن موسى، ثم مجتمع اليسار الثقافي بكافة تياراته، لما يتمتع به من أخلاق اجتماعية عالية ونوعية وطول بال عجيب غريب. بدأت أخرج معهم وأشارك في مناسبات الكليات في الأعياد الفضية كشاعر، أكتب وقتها القصيدة السياسية المتمردة، وأخلق علاقات ممتدة مع طلاب الجامعات عبر المشاركات التي أضفت لها بعد قليل المشاركة في المعارض التشكيلية الجماعية.
بولا كان إنساناً بسيطاً متواضعاً يحب البسطاء والكادحين وغمار الناس. كنّا أحياناً نكون في الطريق إلى إحدى المناسبات، فيلاقي أحدهم، ويكون له رأي آخر، أو يريد مناقشة بولا في أمر ثقافي ما، فيعطيه بولا كل الوقت والمحبة حتى يصل الشخص إلى نقطة التقاء معه. بالدرجة نفسها كم سيكون المرء محظوظاً إذا ما حضر لبولا حواراً فلسفياً وثقافياً مع أحدهم، خاصة لو كان رجلاً في قامة الشاعر الراحل الدكتور محمد عبد الحي. نعم أتاح لي بولا ذلك بأن ذهبنا من بيتهم، وخرجنا نقصد بأقدامنا جامعة الخرطوم عبر جسر الحديد ببحري، لأكتشف بعد وصولنا إلى هناك وتحلق أعداد كبيرة من الطلاب والأساتذة حوله؛ أننا في منتدى الفلاسفة لحضور مناظرة فلسفية بين بولا وعبد الحي.
أتذكر أننا خلعنا ووضعنا أحذيتنا خارج القاعة، وجلسنا أرضاً نستمع إلى تلك المناظرة الرفيعة، والتى تناولت -كمحور من محاورها- الثقافة المادية، وأثرها على القاموس الشعري. عبد الحى للحق؛ واجه حملات شرسة وقتها من منتسبي اليسار، بسبب اتهامات له بكتابة القصيدة (التهويمية)، وإعمال الغرابة في مكون قصيدته بغرض الانفصال من المتلقي لا الاتصال به. وذلك أعتقد أنه لم يكن دقيقاً كما اطلعنا من بعد بمجلة (حروف) أواخر الثمانينيات، والتى نظمت وخصصت عدداً خاصاً بعبد الحي، تحدث فيه المرحوم والده عن أن محمداً تجول وسافر معه وهو طفل إلى أنحاء عديدة من السودان، خاصة الجنوب، ورأى وشاهد الفهد والأسد والأصلة وكيمياء الطبيعة الفذة، وأن كلما تمثل واستيقظ فيما بعد من مفردات بقاموس قصيدته المفارقة قد جاء من هناك.
نتيجة لتلك الليلة وعلاقة إبداعية نشأت بين طالب الثانوي آنذاك وثلة من محبي بولا من طلاب جامعة الخرطوم، بدأت استضافاتي الشعرية بالمنتدى وغيره. فبتشجيع من بولا أصبحت آنداك أحد الشعراء الشباب المشاركين في القراءات الشعرية بالجامعات، وليالي المناسبات الثقافية للمقاومة السياسية لنظام مايو. أذكر أن من نعم بولا علينا في تلك الأيام، وبحكم علاقته الوثيقة للكادر الشيوعي الثقافي المختفي أيامها الدكتور عبدالله علي إبراهيم؛ أننا تمكنا من قراءة عدد من الأعمال الفنية والفكرية المهمة له بعد تسريبها من بولا، وكان من أهمها قراءة مسرحية (السكة حديد قربت المسافات)، وكذلك (نحو حساسية شيوعية). بولا كان يتحدث بشيء من الإعجاب عن القدرات الفائقة لعبدالله في صناعة الجملة، وتفوق التعبير والأفكار، مما سهل علي فيما بعد، وعندما تعرفت على عبدالله علي إبراهيم تتبع مساهماته بشغف واهتمام وتواصل أحياناً بيننا، وفرته اهتمامات مشتركة في التوثيق، خاصة عندما قصدنا ذات عصرية ماطرة منزل الأستاذ الراحل كامل محجوب بحي الرياض بالخرطوم، خلف بقالة سعود، وسرد الرجل بأريحية قصة الإضراب الأشهر للمزارعين بميدان عبد المنعم.
بولا كذلك كان ملماً محيطاً عَلِيماً بالأنساب وآدابها، وكان شديد الاعتزاز ببربر وأهل بربر وشعرائها من جدوده وجداته الذين يحفظ لهم من الشعر ما يحفظ، ولم يكن ذلك إلا جزءاً من معرفة ضخمة بالشعر الشعبي وما ورائياته من بلاغة وجماليات آسرة من الحردلو وشعر البطانة والهمباتة، إلى شعر الحقيبة وفرط إعجابه بشعر أبوصلاح. ولبولا كانت علاقات واسعة بكل أطياف الوسط الثقافي والفني، فقد كان يجمع أحياناً كما لاحظنا بين بالمتناقضين كالمجذوب وعبد الله البشير، فهو قد يحتفظ برأي نقدي واضح عن أحدهم، ولكنه لا يخلط ذلك بالعلاقة الشخصية. سعة البال والصدر وخاصية التواضع؛ خواص تميز بها بولا حسب متابعاتي لسيرته في كل الاوقات. فهو ومنذ تعيينه معيداً بالمعهد الفني بكلية الفنون بأواخر الستينيات حتى فصله منه، كان يرى المستقبل في إجادة خلق مجتمع مستنير من التلاميذ والطلاب، بوصفهم الناقلين لكل ذلك فيما بعد لمحيطاتهم وتجاربهم القادمة، وذلك ما أستشعرته على المستوى الشخصي في تجربتي مع طلابي وطالباتي بجامعة الخرطوم.
كان قد عرفنا على محمد الأمين، ووردي، ومحجوب شريف، وأسماء لامعة في سماء الإبداع، كان صديقاً مقرباً من محمود محمد طه عبر حوارات يشهد لها الجميع. فعندما سافر إلى باريس كان الكاسيت أحد وسائل التواصل لتبادل الرسائل الشخصية، وكم من مرة بعث برسائله عبر الكاسيت لمحمد الأمين الذي كان بولا أحد العالمين الكبار بتجربته الموسيقية والغنائية والمستعدين للحديث عنها لأيام وليال. عندما كتب بولا مقالاته المتسلسلة بصحيفة (الأيام) بصفحة فنون التي كان يحررها حسن موسى؛ انفتح عالم من الأفكار النقدية الجسورة التي عرت وحللت سياسات التجهيل المتعمد بمناهجنا الدراسية، وغربتها عن العقل الإبداعي، والرغبة في تحسين الصفات المعلوماتية والمعرفية لدى جماهير الدارسين. كان بولا أشرس من وجه حملة نقدية في صندوق بريد وعنوان مؤسسة التعليم التي أطلق عليها مؤسسة التعتيم. نعم حرضنا عبر مقالات مصرع الإنسان الممتاز على الاختلاف والتجاوز والتمرد على مؤسسة (التعتيم) والكشف عن حيلها وألاعيبها، في تحويل قدرات المتلقين من قدرات نقد إلى قدرات نقل.
جعل الرسم محبباً لي؛ فتطورت فيه بالنشر في صحيفة (الأيام)، ونحن بعد ببحري الثانوية، ومن ثم في بعض أعداد مجلة الثقافة السودانية، ووجدت فيه لفترة منفذاً إبداعياً لم اكتشفه، ولكن؛ فإن من أهم الدروس البولاوية لي في هذا الخصوص كان تمهيد الطريق لأفكار ترسخت عندي في وقتها للسفر لدراسة السينما. بولا صار مدرسة لنا ببديع معارفه، وثقافته المدهشة، وتحريضه لك على التفكير النقدي وإعادة تفتيش المسلمات. فاجأنا بعد سفر حسن موسى بنية السفر إلى فرنسا، فودعناه أجمل وداع بجلسة أحياها صديقه وصديقنا فيما بعد محمد الأمين، وجمعت تلك الليلة جملة من الأصدقاء والمحبين له وسافر، وكان يرسل أخباره لنا تباعاً بنحو يشيه كتابة اليوميات والصعوبات التي واجهها ببداية إقامته، وأذكر منها ضياع جواز سفره.
غادرت بعد الثانوية إلى موسكو لدراسة السينما. ست سنوات بموسكو تبادلنا الرسائل الكثيرة الممتعة، والتي كانت تشبه أدب كتابة اليوميات. ويا لحزني بعدم الاحتفاظ برسائله بموسكو، والتي كانت تتميز بكتابتها بقلم حبر سائل بلون أخضر وخط بالغ الندرة من حيث الجمال والأناقة. كان بالإمكان لتلك المكاتبات البديعة أن تشكل الآن كتاباً ضخماً بما حوته من أفكار وجماليات في التعبير والبلاغة. ولكن ضاعت مع الزمن وحسن الظن بقدراتي على حفظ المواد وبقاء شخصياتها إلى الأبد. المرحلة الثانية؛ كانت في علاقتي به بعد عودتنا بعد الانتفاضة، ولقاءاتنا اليومية بدار أساتذة جامعة الخرطوم. وجاء سفرنا معاً بطائرة واحدة إلى ليبيا أواخر عام ٨٦. نزلنا في طرابلس وتوجه بولا بطائرة أخرى إلى سبها، حيث كان قد تعاقد معه مركز الدراسات الأفريقية هناك، وتوجهت أنا إلى بنغازي، حيث تعاقدت معي كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة قاريونس.
عندما زرت بولا في سبها ذات اجازة شتوية وجدت تلك المدينة الصحراوية ذات الرمال الكثيفة والبرد القارس تحتوي على تمثيل كبير من السودانيين و كان صديقنا التشكيلي علاء الدين الحزولي قد وصل الى هناك بتوسط من بولا وكنت استمتع بسماع علاء الدين الساخر الكبير وهو يسرد ويقص على حكايات ووقائع بولا النادرة. هنا لا بد من الاشارة الى ان بامكان اصدقاء بولا تخصيص مؤلف خاص بنوادر بولا الطريفة التي لا تحصى ولا تعد. في تلك الزيارة القصيرة لسبها بالطبع اكتشفت ان ذلك المغناطيس البشري بولا يجذب حوله اعدادا من السودانيين الذين ليسوا فقط من اساتذة الجامعة ولكن البشر السودانين الاعتياديين وان السياسة صارت عنده موضوعا مركزيا في اجتماعياته وان مقاومة ومصارعة و نظام الانقاذ واخباره وتحليلات ما يسلكه اصبح الموضوع الاثير لديه وكانت وقتها نجاة قد قدمت مع البنات فاطمة وعزة بينما نوار الصغيرة ذات الشهور انذاك مكان الاهتمام – نوار وعندما وضعتها نجاة بشقة بري اختار لها الاسم الياس فتح الرحمن. كنا تخرج ونزور في تلك الايام العديد من السودانيين واذكر اننا كنا وعندما نخرج الى الشارع كانت الناس تعرفه و تتقادم نحوه او تناديه عن بعد ملقية عليه تحية السلام بالدكتور، و كانت ثمة شخصيات مقربة منهم اليه كجبريل موسي فني مختبرات كلية العلوم هناك و بجامعة الخرطوم. واظن اننا زرنا الجامعة سويا ولكني كنت اذهب معه الى مركز الدراسات الافريقية حيث التقيت هناك بالدكتور الراحل خالد عبد المجيد استاذ اللغة الفرنسية والذي صار زميلنا فيما بعد بجامعة قاريونس- واذكر ايضا ان بولا كان يعمل على بحث وقتها عن الشاعر والرئيس السنغالي الاسبق سنجور وافريقانيته او زنوجيته négritude و المارتنيكي ايميه سيزير وكنت اقرا معه واسمع نقديانه لللتيار من وجهة نظر ماركسية قبل ان اتعرف على هجوم عثمان ساميين ونقده اللازع للتيارالذي كان قد نشآ بالاصل بنيويورك عام ١٩١٩ وجاء كتعبير عن احتجاجات الملونيين على سوء اوضاع علاقتهم بالبيض. بولا وسامبين وغيرهم من ماركسيين كانوا يتطلقون في موقفهم النقدي من ان الزنوجيين اسسوا احتجاجاتهم على اساس تفرقة اللون ولم يقراوا المحتوي الاقتصادي والسياسي للتفرقة فخدموا بالتالي العنصرية المضادة اكثر من فضح نظام الاستغلال الاقتصادي والثقافي المذل لهم. اذكر وقتها فعلا انني سمعت منه بوجود مصطفى ادم الصديق و المقرب ايضا منذ جامعة الخرطوم لبولا وحسن موسى وبشرى وهاشم و محمد الواثق والدومة استاذ الفرنسية و زميله محمد احمد بحكم زمالتهما لنجاة وقد انتقلا فيما بعد بجامعتنا ببنغازي للعمل.
زيارات مني إلى سبها، وقدوم لبولا إلى بنغازي، وإقامات مشتركة، ونقاشات، وتداخل أسري عجيب بين أسرتينا منذ ميلاد فاطمة وعزة ونوار. كان بولا وأسرته جزءاً من مناسبة زواجي، ومتابعة أسرية بيننا وبينه والزوجة المحبة المخلصة نجاة، وإقامتهما معنا، والبنات، حتى غادروا عائدين إلى فرنسا، وغادرت أنا إلى موسكو مرة أخرى للتحضير.

انقطعنا لسنوات، لأزورهم بباريس عند حضوري مرتين إلى معهد العالم العربي للسينما. زارني بالفندق، وخرجنا لنقضي الساعات والساعات على المقاعد الخارجية لساحة متحف اللوفر الفرنسي، وكانت تتعلق بموضوعات شتى، أساسها كان عن أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كان بولا مهتماً بمعرفة تفسيراتي لها كشاهد مقيم وباعتباري، مراقباً لتقلبات الأحوال به إبان إقامتي هناك. زرته أيامها بالبيت، قابلت الأسرة، وحضر معي إلى معهد العالم العربي حيث شاهدنا فيلم (طريق السعادة) للمخرج عبد الرحمن سيسيكو السنغالي الموريتاني، الذي زاملني بمعهد السينما بموسكو، وفاز الفيلم في ذلك اليوم بذهبية المهرجان، وهناننا وبولا سيسيكو بسعادة وفرح غامر. تحدث معه بولا بالفرنسية لبعض الوقت، بولا كان يسألني عن السينما والسينما الأفريقية التي كانت رسالتي عنها، واستمع لتسجيل صوتي نادر دار بيني وبين المخرج السنغالي عثمان سامبين، أعجب بأسلوب الحوار، وأعاد ترجمة جزء منه شفاهة. التقينا بعدها بالسودان في معرض تشكيلي بالمركز الثقافي الفرنسي، واتحاد الكتاب، وكان قد أصابه المرض وتمكن تقريباً من ذاكرته.
وداعاً أستاذي وصديقي الكبير بابكر احمد البشير، او عبد الله بولا .. ذلك المواطن الممتاز
wagdik@yahoo.com