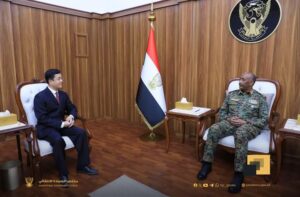نزار قباني .. شاهد من الزمن الجميل (2) اللؤلؤ السوداني الأسود هو الأعلى والأحلى والأكثر إثارة

الأحد, 15 أغسطس, 2021
وعدت بأن أواصلَ الكتابةَ عن الرائع المُبدع والراحل المُقيم نزار قبّاني في حلقة أُولى، وهأنذا المفتون بذلك الصوت المُتفرّد أبحثُ وأنقّبُ في الوسائط الإلكترونيّةِ، حيث عثرتُ على رسالة بعث بها الدكتور الصديق إسماعيل حاج موسى عندما كان وزيرًا للثّقافة في السبعينيات والثمانينيات إلى الزميل الصحفي ضياء الدين بلال الذي نشرها بصحيفة «السوداني» بتاريخ 30/6/2014 تحت عناوين: «نزار قباني يتعرّف على شعره، والنيل واللؤلؤ في السودان، وكان نزار بحق شاهدًا من الزمن الجميل».
يقول نزار: نصف مجدي محفور على منبر (لويس هول) و(الشابل) في الجامعة الأمريكيّة في بيروت، والنصف الآخر مُعلق على أشجار النخيل في بغداد، ومنقوش على مياه النيلَين الأزرق والأبيض في الخرطوم، طبعًا هناك مدن عربيّة أخرى تحتفي بالشعر وتلوح له بالمناديل، لكن بيروت وبغداد والخرطوم تتنفس الشعر وتلبسه وتتكحّل به، إن قراءتي الشعريّة في السودان كانت حفلة ألعاب ناريّة على أرض من الرماد الساخن.
في (دار الثقافة) في أرض أم درمان، كان السودانيون يجلسون كالعصافير على غصون الشجر، وسطوح المنازل، ويضيئون الليل بجلابياتهم البيضاء، وعيونهم التي تختزن كل طفولة الدنيا وطيبتها، هذا الذي يحدث لي ولشعري في السودان شيء خرافي، شيء لم يحدث في الحلم ولا في الأساطير، شيء يشرّفني ويُسعدني ويبكيني، أنا أبكي دائمًا حين يتحوّل الشعر إلى معبد والناس إلى مُصلين، أبكي دائمًا حين لا يجد الناس مكانًا يجلسون فيه، فيجلسون على أهداب عيوني، أبكي دائمًا حين تختلط حدودي بحدود الناس، فلا أكاد أعرف من منا الشاعر ومن منا المُستمع، أبكي دائمًا حين يصبح الناس جزءًا من أوراقي، جزءًا من صوتي، جزءًا من ثيابي، أبكي لأن مدينة عربيّة، مدينة واحدة على الأقل لا تزال بخير، والسودان بألف خير، لأنه يفتح للشعر ذراعَيه، كما تفتح شجرة التين الكبيرة ذراعَيها لأفواج العصافير الربيعيّة المولد.
السودان ينتظر الشعر كما تنتظر الحلوة على النافذة فارس أحلامها، يأتي على صهوة جواده حاملًا لها قوارير العطر وأطواق الياسمين، ومكاتيب الغرام، السودان يجلس أمام الشعر كما تجلس الأم أمام سرير طفلها تغمر خديه بالقبلات وتطعمه حلاوة اللوز والسكر، السودان يلبس للشعر أجمل ما عنده من الثياب، ويذهب للقاء الشعر كما يذهب العاشقون إلى موعد غرام.
السودان بألف خير، لأنه ربط قدره بالشعر، بالكلمات الجميلة، الكلمات جنِّيات رائعات الفتنة، يخرجن مرة من عتمة الظنون، ومرة من عتمة الدفاتر، الكلمات طيور بحرية تخترق زرقة السماء دون تأشيرة، ودون جواز سفر، لم أكن أعرف – قبل أن أزور السودان – أي طاقة على السفر والرحيل تملك الكلمات، ولم أكن أتصوّر قدرتها الهائلة على الحركة والتوالد والإخصاب، لم أكن أتخيل أن كلمة تكتب بالقلم الرصاص على ورقة منسية قادرة على تنوير مدينة بأكملها، على تطريزها بالأخضر والأحمر، وتغطية سمائها بالعصافير.
أشعر بالزهو والكبرياء حين أرى حروفي التي نثرتها في الريح قبل عشرين عامًا تورق وتُزهر على ضفاف النيلَين الأزرق والأبيض.
هذا الذي يحدث لي ولشعري في السودان شيء لا يصدّق، مفاجأة المفاجآت لي كانت الإنسان السوداني، الإنسان في السودان حادثة شعريّة فريدة لا تتكرّر، ظاهرة غير طبيعيّة، خارقة من الخوارق التي تحدث كل عشرة آلاف سنة مرة واحدة، الإنسان السوداني هو الوارث الشرعي الباقي لتراثنا الشعري، هو الولد الشاطر الذي لا يزال يحتفظ دون سائر الإخوة بمصباح الشعر في غرفة نومه، كل سوداني عرفته كان شاعرًا أو راوية شعر، ففي السودان إما أن تكون شاعرًا أو أن تكون عاطلًا عن العمل، فالشعر في السودان هو جواز السفر الذي يسمح لك بدخول المُجتمع ويمنحك الجنسية السودانيّة.
الإنسان السوداني هو الولد الأصفى والأنقى والأطهر الذي لم يبع ثياب أبيه ومكتبته ليشتري بثمنها زجاجة خمر، أو سيارة أمريكية، هو الإنسان العربي الوحيد الذي لم يتشوّه من الداخل ولم يبع تاريخه، هأنذا مرة أخرى في السودان، أتعمّد بمائه، وأتكحّل بليله، وأسترجع حبًا قديمًا لا يزال يشتعل كقوس قزح في دورتي الدمويّة.
عرفت في حياتي وفي رحلاتي كل أنواع اللآلئ البحريّة، عرفت اللؤلؤ الأبيض، واللؤلؤ الرمادي، وعرفت اللؤلؤ الأخضر، اللؤلؤ الوردي، وعرفت الأوروبي والآسيوي، واللؤلؤ الذي يوزن بالقيراط، واللؤلؤ الذي يوزن بالقصائد والدموع، واللؤلؤ الذي يتدلى على صدور الكواكب.الحب السوداني ليس جديدًا عليّ، فهو يشتعل كالشطة الحمراء على ضفاف فمي، ويتساقط كثمار المانجو على بوابة قلبي، ويسافر كرمح إفريقي بين عنقي وخاصرتي، هذا الحب السوداني لا أناقشه، ولا أحتجّ عليه، لأنه صار أكبر من احتجاجي، وأكبر مني، صار وشمًا على غِلاف القلب لا يُغسل ولا يُمسح.
نزار – عليه رحمة الله – قد نتفق معه ونختلف في بعض المواقف والقضايا ولكننا لا نختلف على قدرته العالية بالرسم بالكلمات، فهو من القلائل الذين أثروا قاموسنا اللغوي بمفردات فريدة وجميلة ومبهرة.
ماذا لو أنك يا رفيق العمر، قد أخبرتني أني انتهى أمري لديك، فجميع ما وشوشتني، أيام كنت تحبني، أنكرته أصلًا كما أنكرتني، ودعوت سيدة إليك، وأهنتني، من بعد ما كنت الضياء بناظريك.
ستردد القصص التي أسمعتني، ولسوف تخبرها بما أخبرتني، وسترفع الكأس التي جرعتني، كأسًا بها سممتني، حتى إذا عادت إليك لترود موعدها الهني، أخبرتها أن الرفاق أتوا إليك.