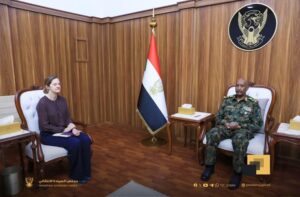النور.. ثورة في موسيقى أهل السودان


كان صبحاً مأسوياً، شهدناه ونحن مكدسون في الحافلات المسرعة، في طريقنا إلى المدارس، نسترق النظر، من خلال نوافذها الحديدية، والحادث المروري، لا يزال يعشش بأطرافه، ثقيلاً على الأفئدة، راسماً بشاعته، على الأسفلت والتراب، متجمداً في موقعه بشارع المعونة، عند مدخل الحلفاية، قبيل (مزارع جدو) بقليل.
شهدنا ما تبقى، من حطام بص ابورجيلة، وفي الطرف الآخر من المشهد، عربة (بوكس) ركاب، قد تحولت إلى ما يشبه رسماً سريالياً، تدرك منذ اللحظة الأولى، بأن لم يبق فيها أحد من ركابها، على قيد الحياة. كانوا شباباً في مطلع حياتهم، كانوا أعضاء الفرقة التي صحبت (النور الجيلاني)، في أوائل عهد صعود نجمه، ولآخر مرة في حياتهم، وحياته، في حفل في الليلة السابقة، وكان هو قد غادر الحفل، على غير عادته، في صحبة صديق، في سيارة خاصة، فالتقي البص بالبوكس، مع بواكير الصباح، في حدبة الشارع، وكان قضاءً محتوما.
هجر النور الغناء، عقب تلك الحادثة، اختفى تماماً، عن الساحة، كان يحتاج وقتاً، ليتمكن من استيعاب هذه الجرعة العالية من الحزن، ابتعد عن بقعة الضوء، لزمن طويل، حتى سمع المغني يردد ذات يوم:
حبيبي الدنيا يوم بتروح
لا بدوم لا فرح لا نوح
غداً نصبح حطام أحلام
وتزورنا الرياح في الدوح
فليه قلبك تزيدو جروح
ثم لم تلبث الحياة، أن عادت إلى طبيعتها الأولى، ومضت عجلة النسيان في مسيرها، تطوي وتنشر، سِيَر الأقدمين والمحدثين، واستهلكت ذاكرة الخلق، شؤون العيش وساس يسوس، وعادت الحافلات، إلى سيرتها وتسارعها، واللواري عادت تحمل الخضر، من ابوحليمة، والفكي هاشم والسروراب، والكدرو، عادت تزحف فرحة، كعادتها كل صباح، وعاد بص ابورجيلة (الاكسبريس)، يمر بنفس نقطة الموت، لا يأس على الذي تولى، يمضي مسرعاً، يحمل المنهكين، المتعبين، المثقلين بأعباء النضال، كل مساء، إلى الخوجلاب، دون أن يتوقف في فضاء شمبات، ولو للمحة، يأخذهم إلى مناحٍ وضواحٍ، ساكنة مستسلمة لأقدارها، ترقد هنالك في شمال بحري، بعيداً عن أضواء المدن. عاد النور، بعد سنوات، مغتسلاً من أحزانه، بفريق جديد كل الجدة، وغناء أشد جدة، لا يهم من يحل مكان من، فبصمة النور واحدة لا تتغير، ولا تقبل التقليد، عاد النور، ورنة أسى تصبغ صوته، حتى تبدد، وجفت حنجرته.
لغناء المدينة، والذي هو في أصله ومنتهاه، غناء للحبيبة، مكان أثير في أنفسنا، أحب شاعرٌ كسلا لأجلها، فتمنيت أن اكون كسلاوياً، وأحب أرض المحنةِ آخر، وكاد أن يهجر بلاد المحنة، وأغرته نزوة أن (يسيب) مدني، حتى يسكن بقربها، وما فعل، ولكنه هاجر عوضاً، إلى مدن غريبة، كئيبة، يحلم فيها بالمال .
وغنينا مع غريد الغرب، للتي تسكن بارا، وغيرها كثيرات، ملهمات، وهن نسوة من السودان، مشلخات ومرهاوات، مصونات بالعزة والصوارم. ولكن للتي تسكن الكدرو، شدو لا يشبه أي شدو غيره، لا قبله ولا بعده، فلا اللحن ينتمي لغير الجاز، والتمتم في أدق تفاصيله، هو لحن لا يشبه أي لحن آخر، مما عهدنا، فهو من فئة الألحان المعدية، ما ان يدركك منه رذاذ، حتى لا تقدر على خلعه عن عقلك، وستظل تحت رحمته، مقيد في أسره، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، هي أغنية قدرية، لامرأة من مدينة، بل قل قرية في ذلك الزمان، إسمها الكدرو، تخلد جمالها في أغنية، قطعة فنية، تتجاذبها قدرة الفرح، وطاقة الحزن التي تشف عما يحويه، أغنية تحتفل حتى بالقنوط، وتسرف في التذكير بأقدار الإنسان، بل عبثيتها، فلا تملك إلا أن تسلك هذا الدرب الصوفي، الذي تصفه القصيدة، يحملها صوته، مختلطاً، بالكورال، والمندلين، والإيقاعات، التي لا تمل من الطرق، والنحاس الذي يلازمها، حتى حدود الأبدية، تحمل الشعر الذي يعتني بحقائق الحياة، دون خوف ولا وجل، ولا ذرة من ندم. والنور لا يشبه أحداً، في ارتداء شعره، وأزيائه وقبعاته، والحرية التي تستشعرها، في طريقة أدائه، والنور متفرد في إيقاعاته، وفي جملة الآلات التي تصحبه، قد تكون ثمة علاقة ما، بين الجيتار والباص والدرمز، وآلات النفخ النحاسية، وقد يكون المندلين، زائراً غريباً على الجمع، ولكنه في موسيقى النور، يصنع علاقة يعرفها وحده، مع أسر الآلات الأخرى، لا يسبب نشازاً، ولا يخرج عن طوق الهارمونية، وإن تعمد ذلك.
الأغنية السودانية عند النور تؤكد أفريقيتها، مراراً، مادالينا، القدامنا ما انت، جوبا، تعمر بالجالوة والاسكيستا، بيد أن كلماتها عربية، مثلما يغني ساليف كيتا، مانيو ديبانقو ويوسو ندور و فيلا كوتي، بلغات أوروبية، ولغات أفريقية بحتة، بينما تظل أغانيهم، أفريقية في نخاعهاً. أغنية النور، مائدة حافلة دسمة، لكل ذي مذاق، فيها ما يطيب له.يظل النور ثورة، في موسيقى أهل السودان، بيد أننا لم ندرك حجم تلك الثورة بعد.