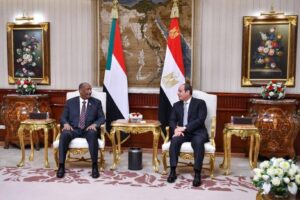العربية في يومها العالمي: مأتم أم عيد …؟ دورنا في إحياء نيرانها

مدخل:
ما أطيب قول شاعرُ النيل حافظ إبراهيم عندما أشار إلى جلال وبهاء لغة الضاد:
وَسِعْتُ كِتابَ اللَهِ لَفظاً وَغايَةً وَما ضِقْتُ عَن آيٍ بِهِ وَعِظاتِ
أَنا البَحرُ في أَحشائِهِ الدُرُّ كامِنٌ فَهَل سَأَلوا الغَوّاصَ عَن صَدَفاتي
العربية … مضمخة بدم الذئب أم طائحة بالجبّ؟
كلمٌ أغرّ وصوتٌ أبرّ، في لحنها ونغمها، وقعها ونبرها، لغة القرآن ووحي الإنسان، هالة من نور ودرر من سرور، لكن هل من داعٍ للسرور وللافتخار وحتى للغرور؟ لغتنا العربية يا سادتي في عيدها العالمي أو لنقل في مأتمها العالمي في محنة وأيّ محنة، بمخمصة وأيّ مخمصة، أوضعناها في جُبّ يوسف الأمين، في صحراء بوادٍ غير ذي زرع؟ وهل تهافت عليها أبناؤها ليقضوا وينقضّوا عليها، أم أنها لفظت أنفاسها الأخيرة بين أنياب الذئب؟ وكأنما يا إخوتي قد جئنا بقميصيها، مضمخ بدم كذبٍ، في حضرة أبوها الساميّ يعقوب، متصافقين ومعلنين موتتها الأبديّة؟! لكنها كما يوسف، سترى برهان ربّها بعمل أهلها والحادبين عليها،بالدأب والمثابرة الحقّة، وسيرى جميعنا – إن عملنا بنكران ذات – أن أحد عشر كوكبا والشمس سيخرّون لها ساجدين.
لغتنا الضاديّة الساميّة، رغم جمالها وألقها، لسانها وفصاحتها، حلاوتها وشهدها، غزارتها وإرثها التليد، الذي لا يزال يتدفق منذ أكثر من أربعة عشر قرن ونيّف مدرارًا كالسلسبيل، هي الآن بغرفة الإنعاش المكثف! أرانا نحتفل في الثامن عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) بيومها هذا ونفتخر ونقول ملئ أشداقنا أنها صارت – يا إلهي – لغة الفيفا ومسي ونيمار وليفندوفسكي، بل ذهبنا إلى أبعد من ذلك لنطلق عليها لسان الأمم المتحدة – أم هي في الأصل الأمم اللامتحدة. من جهة أخرى هل يدعو الراهن في محنتها العالمية هذه بربكم للاحتفاء والاحتفال؟ وهل يدعو حالها الآنيّ للغبطة والسرور؟ أم يدعو أغلب الظنّ للندب والبكاء، وللنحيب والمكاء؟ أين هي بربكم من محلها في الإعراب؟ هذه اللغة كانت يومًا ما لغة العلم والفن والحضارة، لسان الشعر والأدب والفلسفة، صوت الحق والأذان والأديان، نداء المعارف الإلهية وصدى الحقائق الكونية، بحر بمداد لا ينفد ولا ينضب، ولو جئنا بمثله مددا! دعوني أطرح التساؤلات الآتية: أنبكي على أطلال أندلس مفقود كانت فيه هي سيدة المكان والزمان؟ لقد صار فعلنا فيها ولها مبني للمجهول، فاعلنا غائب ومفعولنا لا مكان له من الإعراب وحتى بيننا نحن الأعراب.
أنندب حظنا العاثر على أطلال جامعات النور في طليطلة والبندقية وحتى في أقصى جنوب فرنسا حينما كان “الكتاب” في الطب لابن سيناء يلقن كمرجع من المراجع الأساسية بلغة الضاد. أنبكي على هوامش الطرقات الضيقة بين الحارات والحانات كما شعراء التربادور، (الشعراء الجوّالون) ونحث خطانا حثًّا في أزقة غرناطة وبلد الوليد لنقول هاهنا عاش ابن زيدون وهاهناك أشعرت ولادة بنت المستكفي ووقتئذ دندن زرياب بعوده الرنان تحت أشجار الصفاف والقرنفل، نسرد ونقص القصص لأحفادنا وأحفاد أحفادنا أن كل هذه الدرر راحت بلا رجعة وانتقلت بفضل العرب والعربية إلى كل أنحاء أوروبا دونما تنتقل إلى أصلها في وصحن مملكة الأمويين، راحت نعم بلا رجعة ليستنير بنورها أبناء الغرب وأحفاد موليير وجوته وفكتور هيجو، وانطلقوا لا يلوون على شئ عبر لغتنا التي نحتفي بها، إلى آفاق العالمية وبلغوا بها عصر النهضة والتنوير، حلّقوا على براقها إلى عطارد العلم ومشترى المعرفة، نعم بلغتنا العربية نحن الأعراب، فأين هم الآن وأين نحن، وأين لغاتهم في دور العلم والمعارف وبالجامعات الشامخات، وأين لغتنا العربية بينها؟ هل تقدِّرون يا سادتي الخسارة المعنوية، التاريخية الجسيمة في هذا الفقدان المبين، وهل تحسبون الفارق المعرفي والمخزون العلمي بين ألسنتهم وألسنتا؟ هي بلا جدال، وحدث ولا حرج، سنين ضوئية ويا حادي العيسِ عجل وصلنا كما غناها صباح فخري، عندما صدح ب “لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت في الدجى الإبل” بلسان الشاعر المنسي أبو الحسن محمد بن القاسم. وهذا المشهد المبكي المحزن، والذي تنزف من وطأته الدموع، يذكرني بالخروج من الأندلس كما حاكتها ريشة الأديبة رضوى عاشور في ثلاثية غرناطة وكما سردت وقائعها في مقال سابق بعنوان: “ثلاثية غرناطة والأندلس المفقود”. ولغتنا العربية بحق وحقيقة أندلس مفقود. في ساعة الخروج والهروب تلك، خوفًا من ملوك القشتاليين، وقف أحد ملوك قرناطة على تل وبكى فصاحت بهِ أمّه: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟! وأنا أقول أما آن لنا نحن العرب أن نترجل، ونترك البكاء على الأطلال ونصنع فيفا العربية الخالصة وأممها المتحدة التي توحّدنا نحن العرب، ومن نسى قديمه راح، أي ضاع، وإن نسينا أربعة عشر قرنا من الحضارة المتعلقة بلغة الوحي والتنزيل، لرحنا، وبالأصل نحن رُحنا سلفًا في عداد الغابرين، إلا أن يشاء ربي.
تلك أسئلة ملحّة تدور منذ زمن طويل بخاطري وأنا أرى أنّ أهلها هجروها، تركوها وأهملوها، نعم، أضاعوها بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان. أين نحن من أبناء لغة العم جوته حيث أسس الألمان للغتهم المعاهد العليا والمؤسسات الخارقة للعادة، والمجامع الجادة الحقيقية، والمؤسسات العلمية التي تطور فيها في كل لمحة ونفس، كل ذلك لكي يحفظوا أسرارها وأسفارها، يصونوا ثرواتها وحضارتها، لأنهم يدكون أيما إدراك أن الألمانية إن ضاعت، ضاع كل ما عندهم، وصاروا كالأخرس، أو كقوله تعالى “صم بكم عمي فهم لا يعقلون” وهذا هو حالنا اليوم يا إخوتي، فلنفق من سباتنا ونومنا العميق ونترك الحكايات والقصص البالية وأساطير الأولين، فقد حان الوقت للعمل الجاد ونكران الذات فالقضية حتمًا مصيريّة، وهي بلا شكّ، قضية حياة أو موت، فماذا نريد وننشد؟ الحياة للساننا أم الموت له؟ لا ينبغي علينا أن نقبع متقوقعين في ماضينا قائلين أنّ فارس وأوروبا وكل أنحاء العالم كانت تُكنُّ للغة العربية أجلّ الاحترام، وأنها ولدت لبيد وعنترة بن شداد وأبو الطيب المتنبئ وامرؤ القيس، وكتب بها شعراء وأدباء فارس والأتراك وغيرهم. ولو رجعنا في سيرة حافظ الشيرازي، على سبيل المثال، هذا الذي أتقن لغة غيره، وعدنا في ذلك إلى أشعاره الخالدة لوجدناها بيّنة جليّة، سلسلة ونديّة، وهاكم ترجمة إحدى قصائده والتي تكتظ بالمفردات العربية (ترجمة):
ألا يا أيُّها الساقي أدِرْ كاساً وناولْهَا*
لشفاهٍ عَطشتْ لطاسةٍ مَدَحُوها
فإنَّ العِشْقَ بَدا لي سَهْلاً
ولكنْ زلَّتْ قَدَمي على طُرقِهِ الْمُشكِلَة
فالمقارنة بين عمل الألمان الدؤوب في تأسيس مناهج عظيمة لتعليم لغتهم للناطقين بها أو للناطقين بغيرها جد صعبة يا أخوتي. لماذا لم يجتمع العرب قاطبة ليأسسوا ولو مركزًا واحدًا لتعليم لغتهم، ولماذا لم نجتهد لنعلمها لأبنائنا عبر منهجيات حديثة، عصرية وناجعة. للأسف تركنا كل ذلك ووصرنا نتبارى في صنع المنافسات بكل أشكالها وألوانها، نستجلب التقنيات من الخارج، يعني نستهلكها ولا ننتجها، فتدرس بجامعاتنا لغاتهم الأجنبية وعلومهما لأنها، كما يزعم البعض، في الشكل والمظهر تجبر الآخرين لاحترام من يمتلك نواصيها وأرسانها.
بالعكس أين معهد اللغة العربية، في نيويورك، باريس، برلين أو مدريد، معهد لأمّة متحدة يمكن أن يقصده الناس راجلين إليه من كل صوب وحدب. يتثنى فيه لأبنائنا من أن يتعلموا فيه لسان حالهم ولغة أهلهم، فقد ضاعوا وضاعت معهم لغتنا العربية في دهاليز أوروبا وصاروا غريبيّ الوجه واليد واللسان. كنت أتمنى أن نجد في عواصم العالم المذكورة أعلاه ومن قبل في عواصمنا أولًا، معاهدا ومؤسسات تدرّس فيها اللغة العربية لأبنائها وللأجانب – على نسق معهد جوته الألماني. أراني أبحث عنها في كل مكان لكن دون جدوى. والاجتهادات الفردية في الشأن طيبة لكن وكما يقول المثل الألماني: يدٌ واحدة ليس باستطاعتها أن تصفّق!
كل ذلك يؤلمني يا اخوتي وأنا كرّست نفسي، ذلك منذ أن وطأت قدميّ أرض أوروبا، لدراسة اللغات، العربية منها والغربية لكن جهدي نقطة في محيط بلا شطء ولا أريد أن أكابر أو أفتخر لكني، مثلكم تمامًا مكبول اليدين، ولو كان عندي من المال والسلطة ما عند الآخرين لشرعت في مشروع بناء اللغة دون أدنى شك، لكن أظل قابعًا في ركني لا أحرك ساكنًا، وفيه أصارع لوحدي بأضعف الإيمان، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، و “ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السُّفُنُ”. لعمري إنّ هذه القصيدة وكأنها فُصِّلت لجسد العربية، فيها من العبر والجمال والصور البليغة والخيال، ما يؤكد عظمة هذه اللغة وما يجبرنا بحق وحقيقة أن نحارب من أجلها ونذلل الصعاب لرفع شأنها وشأوها. فالقصيدة بعنوان ما كل ما يتمنى المرء يدركه بلسان شاعر العرب الفذ أبو الطيب المتنبئ، الذي احتفى به شعراء الغرب وشهدوا لصناعته بالعبقرية، وقد تحدث الشاعر الألماني جوته عن ذلك في غير مقال واختزل من تعابيره وصوره وافتتن به كما افتتن بلسان الوحي المبين، حتى قال ذات ليلة “إني أؤمن بتلكم الليلة التي أنزل الله فيها القرآن على عبده محمد”. وإليكم قصيدة المتنبئ:
ما كل ما يتمنى المرء يدركه:
بِمَ التّعَلّلُ لا أهْلٌ وَلا وَطَنُ
وَلا نَديمٌ وَلا كأسٌ وَلا سَكَنُ
أُريدُ مِنْ زَمَني ذا أنْ يُبَلّغَني
مَا لَيسَ يبْلُغُهُ من نَفسِهِ الزّمَنُ
لا تَلْقَ دَهْرَكَ إلاّ غَيرَ مُكتَرِثٍ
ما دامَ يَصْحَبُ فيهِ رُوحَكَ البَدنُ
فَمَا يُديمُ سُرُورٌ ما سُرِرْتَ بِهِ
وَلا يَرُدّ عَلَيكَ الفَائِتَ الحَزَنُ
مِمّا أضَرّ بأهْلِ العِشْقِ أنّهُمُ
هَوَوا وَمَا عَرَفُوا الدّنْيَا وَما فطِنوا
تَفنى عُيُونُهُمُ دَمْعاً وَأنْفُسُهُمْ
في إثْرِ كُلّ قَبيحٍ وَجهُهُ حَسَنُ
تَحَمّلُوا حَمَلَتْكُمْ كلُّ ناجِيَةٍ
فكُلُّ بَينٍ عَليّ اليَوْمَ مُؤتَمَنُ
ما في هَوَادِجِكم من مُهجتي عِوَضٌ
إنْ مُتُّ شَوْقاً وَلا فيها لهَا ثَمَنُ
يَا مَنْ نُعيتُ على بُعْدٍ بمَجْلِسِهِ
كُلٌّ بمَا زَعَمَ النّاعونَ مُرْتَهَنُ
كمْ قد قُتِلتُ وكم قد متُّ عندَكُمُ
ثمّ انتَفَضْتُ فزالَ القَبرُ وَالكَفَنُ
قد كانَ شاهَدَ دَفني قَبلَ قولهِمِ
جَماعَةٌ ثمّ ماتُوا قبلَ مَن دَفَنوا
مَا كلُّ ما يَتَمَنّى المَرْءُ يُدْرِكُهُ
تجرِي الرّياحُ بمَا لا تَشتَهي السّفُنُ
رَأيتُكُم لا يَصُونُ العِرْضَ جارُكمُ
وَلا يَدِرُّ على مَرْعاكُمُ اللّبَنُ
جَزاءُ كُلّ قَرِيبٍ مِنكُمُ مَلَلٌ
وَحَظُّ كُلّ مُحِبٍّ منكُمُ ضَغَنُ
وَتَغضَبُونَ على مَنْ نَالَ رِفْدَكُمُ
حتى يُعاقِبَهُ التّنغيصُ وَالمِنَنُ
فَغَادَرَ الهَجْرُ ما بَيني وَبينَكُمُ
يَهماءَ تكذِبُ فيها العَينُ
وَالأُذُنُ تَحْبُو الرّوَاسِمُ مِن بَعدِ الرّسيمِ بهَا
وَتَسألُ الأرْضَ عن أخفافِها الثَّفِنُ
إنّي أُصَاحِبُ حِلمي وَهْوَ بي كَرَمٌ
وَلا أُصاحِبُ حِلمي وَهوَ بي جُبُنُ
وَلا أُقيمُ على مَالٍ أذِلُّ بِهِ
وَلا ألَذُّ بِمَا عِرْضِي بِهِ دَرِنُ
سَهِرْتُ بَعد رَحيلي وَحشَةً لكُمُ
ثمّ استَمَرّ مريري وَارْعَوَى الوَسَنُ
وَإنْ بُلِيتُ بوُدٍّ مِثْلِ وُدّكُمُ
فإنّني بفِراقٍ مِثْلِهِ قَمِنُ
أبْلى الأجِلّةَ مُهْري عِندَ غَيرِكُمُ
وَبُدِّلَ العُذْرُ بالفُسطاطِ وَالرّسَنُ
عندَ الهُمامِ أبي المِسكِ الذي غرِقَتْ
في جُودِهِ مُضَرُ الحَمراءِ وَاليَمَنُ
وَإنْ تأخّرَ عَنّي بَعضُ مَوْعِدِهِ
فَمَا تَأخَّرُ آمَالي وَلا تَهِنُ
هُوَ الوَفيُّ وَلَكِنّي ذَكَرْتُ لَهُ
مَوَدّةً فَهْوَ يَبْلُوهَا وَيَمْتَحِنُ
الفروق الجوهرية بين مفاهيم الشرق والغرب:
دعوني أتطرف على سبيل المرور لجوته الشاعر الألماني وعلاقته بالعربية: لقد كان القرآن – إلى جانب الإنجيل – أقرب كتاب مقدَّس إلى روحه من بين جميع الكتب المقدَّسة. في عام 1771، حثَّه العالم هيردر على التعامل بشكل مكثَّف مع كتاب المسلمين المقدَّس. وإلى جانب إعجابه بلغة القرآن القوية – التي قال إنَّها الإلهام الأعلى الذي شكَّل البلاغة الشعرية في النصوص المقدسة – فقد سهَّل عليه الوصول إلى القرآن عنصرٌ حاسم، هو: توافق تعاليم الإسلام الرئيسية مع مشاعر وآراء الشاعر الدينية. كان رفض غوته بالمعجزات كفيلًا بارتباطه بالدين الإسلامي، بالإضافة إلى إيمانه بعقيدة التوحيد ووحدانية الله وقناعته بتجلي الله في الطبيعة.
ذلك يقودنا للمفاهيم الجوهرية بين الشرق والغرب كما ذكرها الباحث د. فالح بن شبيب العجمي في شأن التفكير بين الشرق والغرب، قائلاً الآتي: “توجد بالتأكيد تراكمات من تصورات مفهومي «الحرية» و«الحقيقة» المختلفة كليا في الشرق عنها في الغرب، وتطورت في ضوء ما توصلت إليه كل من الكتلتين بشأن تتبع مصادر الانعتاق من القيود من جهة، واليقين عند الإنسان المرتبط بتصور الكون وعلاقاته به في كل الأزمان، ودوافع سلوك الإنسان نحو بعض المسلمات اليقينية؛ انطلاقا من العقل البدائي، ثم الميتافيزيقي، وأخيرا التجريبي.
بالنسبة للشرق القديم كانت هناك محاولات من مفكريه بالتزام كلام الأنبياء والحكماء، وكل ما يعتقد بأن الميتافيزيقا تفرضه بوصفه إطارا لحرية الفرد، وبقيت تلك القيود مفروضة بشدة في كل الحقب المختلفة من حياة شعوب الشرق. كما أنهم، فيما يخص أطر الحقيقة، خائفون من تبني نظريات بأي شأن مهم من شؤون حياتهم ومستقبلهم؛ ومن أجل ذلك كانوا كلما تقادمت بهم العصور، ونسوا تعليمات السماء، أو تقادمت عليهم، ولم تعد تلبي حاجات عصرهم، التفوا حول نبي جديد، أو حكيم يفسر لهم أمور الكون من جديد، ويطمئنهم بأن مستقبلهم بخير.”
دور الفلسفة في التنوير:
ويسترسل الباحث قائلًا: “أما في الغرب، الذي يمكن اعتبار أولى مراحله الفكرية المستقلة ما توصل إليه فلاسفة العقل في مرحلة التنوير، من أن حرية الإنسان مطلب مستقل بحد ذاته، وأن الانتقاص منها مثل الاعتداء على جسد الإنسان فيزيائيا؛ كما أن هناك علاقة وطيدة بين الاهتمام بالمعرفة وتطور آليات العقل البشري. فقد التزم كانط في «نقد العقل المحض» ببناء نظرية للمعرفة؛ تبين ما يجب أن تكون عليه بنية الشخص العارف وطبيعة الشيء المعروف، حتى تأمن موضوعية المشروع الفيزيائي، منذ كوبرنيكوس وغاليلي، وصولا إلى نيوتن ولافوازييه. هذه النظرية أدت – كما هو معروف – إلى إبراز شرعية المعرفة العلمية، ووهم المعرفة الميتافيزيقية، المعرفة التي تطمح في الوصول إلى المطلق. فقد حدد الوضع الميتافيزيقي للعلم، والوضع العلمي للميتافيزيقا؛ وهو في هذا عرض مسألة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنطق، أي بمصداقية الأحكام التركيبية القبْلية. فالحكم بأن لكل حدث سببا يحدث، حكم قبْلي لا يرتكز إلى التجربة. فنحن لا ندرك الأحداث التي سوف نختبرها، لكننا واثقون سلفا من خضوعها لقانون السببية الذي لا يستمد من تصور الحدث.
وقد كان كانط ينظر إلى العقل البشري المنظم للتجربة الحياتية والمشرع للطبيعة، ليس على أساس المبادئ الفطرية التي أقرها ديكارت من قبل، بل بوصفه هو نفسه جملة من القوالب القبْلية (صورتا الزمان والمكان والمقولات) التي هي مكونة من قوالب فارغة تملؤها الحدوس الحسية، فتحول إلى معرفة، هذه الحدوس التي تظل عمياء من دون تلك القوالب، حسب تعبيره.”
أهمية الفكر وحرية الرأي في تقدم الأمم:
إن الفكر وحرية الرأي والبحث العلمي والاجتهاد في كل المجالات هي الألف والياء في نجاح، رقي وتفوق الأمم. وفيما يخص اللغة العربية لماذا لا نحارب بكل هذه السبل من أجلها؟ لماذا لا نصارع الزمن والوقت لإنقاذها من الاندثار؟ لإحيائها في قلوب كبدات أفلاذنا؟ أتنقصنا الموارد البشرية أو الماديّة أم تنقصنا العزيمة والجرأة في انجاز الأعمال المستعصية؟ لماذا لا نثابر في كل بلد عربي من المحيط إلى الخليج حتى تتحقق هذه الأمنية التي صارت ملحّة للغاية في زمن نرى فيه تقدم اللغات الأوروبية وحتى الآسيوية الصاروخي. للأسف صار الناس يعلمون أبناءهم اللغة الصينية واليابانية والروسية، ناسين لغتهم الأم، وغدونا في بيوتنا نأتي بمن يعلم أبناءنا لغاتهم الأعجمية، فصار أبناؤنا يجيدون تلك اللغات – لا سيما أبناء الطبقة الأرستقراطية من أولئك الذين ينفقون الملايين في تعليم أبنائهم ولا ضير ولا حقد ولا ضغينة، فكل نفس بما كسبت رهينة والله يعطي الملك والمال لمن يشاء وينزعه ممن يشاء، على أيّة حال صار أبناء العرب يتحدثون الإنجليزية والفرنسية والاسبانية والصينية بطلاقة تاركين لغتهم الأم، كل ذلك من أجل البزنس والتواصل في عهد العولمة مع العالم الخارجي، وأين عالمنا الداخلي، أليسه مهم، أليس من الأهمية أن نعلم أبناءنا الفصاحة حتى في خلال يومهم، الغريب أن معجم الطفل العربي بدائي للغاية مقارنة بمعجم الطفل الغربي أو الآسيوي، أقصد في تسمية الأشياء وفي البلاغة والخطابة. شاهدوا سي إن إن وشاهدوا قنواتنا العربية ستعرفون الفرق بأنفسكم.
يا حسرتاه على يوم لغتي:
فيا حسرتاه على لغتنا التي نحتفي بها اليوم عالميًا صارت الآن في عداد اللغات الغابرة علميًا، أدبيًا، ثقافيًا إذ لا يهتم بها أهل الغرب كما كانت الحال من قبل، فأين الترجمات من العربية اللهم إلا بضع الروايات. ولماذا يهتمون بها، لأن الأمّة العربية أمّة استهلاكيّة تتوكأ على نجاحات الأمم الأخرى، وهذه هي العلة في هجرها من قبل أهل الغرب. ولتوضيح الأمر، نجد أن العرب، وإن كان بعضهم لبعض ظهيرًا، من المحيط إلى الخليج، لا ينتجون علميًا من الكتب إلا نسبة خمسة بالمائة مما تنتجه اسبانيا، نعم، النسبة خمسة بالمئة، مقارنة بالمنتوج الفكري لإسبانيا؛ ذلك فقط على سبيل المثال والقائمة طويلة. هذه الشأن يذكرني بقصص الأمم الغابرة، التي فقدت كل شيء. واليوم صارت لغات الغرب هي لغات العلم والاتصال والمصطلحات العلمية ولغة الأغراض الخاصة والعامة.
ولو أردنا أن نحيي لغتنا لفعلنا مثل ما فعلت إسرائيل. لنشاهد كيف استطاعوا أن يحيوا عظام لغتهم وهي رميم. يدرسون بها في الجامعات، يكتبون بها الأوراق العلمية، يفعلون بها ما يشاؤون وفوق هذا وذلك يجيدون اللغات الغربية. لذلك فتعلم اللغة الأم بطريقة بيداغوجية عصرية وحديثة مع تعلم اللغات الأخرى شيء طيب ومحمود، ويا ليتنا نقتفي أثر مناهجهم لنرى كيف يحسنون القول والفعل ويتبعون أحسنه. متى نعزف يا سادتي عن قول “قام زيدٌ” قعدَ زيدٌ” وأنّ هذا الأخير، زيد مبني للمجهول. عن أي مجهول بربكم نتحدث، فما جاءنا من علمائنا من العلوم كالنحو وغيره من درر لم نستطع أن نطور فيه شيئًا أو حتى أن نزد عليه المعاصرون. وهذه هي الحال في كل المجالات، في الدين والشعر والأدب والعلوم. نحن يا سادتي أمّة تعشق التكرار وتمجد الإبزار وتموت وراء الهزار. فلنفق فالوقت كالسيف إن نقتله قتلنا.
خاتمة:
دعونا يا سادتي نشارك الدنيا أجمع في المنظومة العالمية بإنسانيتنا وعلمنا ورقينا ونترك نعرات الدين والقبلية والتعصب خلف ظهورنا، فإننا لا نخلد على وجه هذه المستديرة، فلنترك لأحفادنا إرثا ولغة وحضارة يعتزون بها حتى يقولون: لقد أجتهد أجدادنا وأبلوا بلاءً حسنا فلهم منا كل التقدير. فالحرية والسلام والعدالة هي الحل. ولكل مجتهد نصيب.
Mohamed@Badawi.de