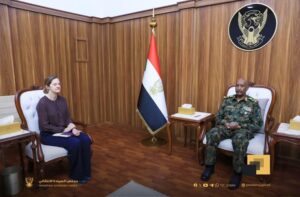اتفاق سلام جوبا .. قراءة نقدية *

استبشر الشعب السوداني خيرا بثورته المجيدة في ديسمبر 2019، واحتفى ايما احتفال بشعارها الداوي “حرية وسلام وعدالة” حالما أن يتنزل عليه ذلك الشعار بردا وسلاما. ومضت مسيرة الفترة الانتقالية بعد توقيع الوثيقة الدستورية بين المكونين المدني والعسكري، تتلاطمها أمواج عاتية من المعيقات، من أعدائها والمتربصون بها من نظام الإنقاذ المأفون، مدنيين وعسكريين وبكثير من الأسف من بعض حاضنتها السياسية في قوى الحرية والتغيير. وكانت فاتورة تلك المعوقات ما ندفعه اليوم من ثمن باهظ، إذ سرعان ما تبدل حال الانتقال المتعثر إلى حال وواقع آخر أكثر قتامة وبؤسا من ليل الإنقاذ البهيم، بقيام انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 المشؤوم، والأكيد أن لكل الأطراف المشاركة في إدارة الفترة الانتقالية سهما مقدرا في ذلك المآل.
مثّل تحقيق السلام العادل وإيقاف الحرب في كل مناطق النزاع قضايا مركزية وجوهرية للثورة، وما أهزوجة “يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور” التي تغنى وهتف بها الثوار في هبتهم الشامخة إلا تأكيدًا لذلك، حيث نصت الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية بأن يكون “العمل الجاد لإحلال السلام” أهم الأولويات الأساسية الواجب تنفيذها خلال الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية، وذلك في سعي لمعالجة الغبن السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي لحق بمناطق الحروب، بإزالة أسباب التهميش ووقف النزوح الاضطراري والتهجير القسري وللتكلفة الباهظة لاستمرار الحرب من زيادة في عدد الضحايا ودمار للبني التحتية وتعطل عجلة الإنتاج. وتجدر الإشارة إلى أنه ونتيجة للحرب وحسب تقريرا للأمم المتحدة بلغ عدد الضحايا نحو ثلاثمائة ألف قتيل، بينما أشارت تقارير حكومية (الإنقاذ) أن عدد القتلى لم يتجاوز عشرة آلاف قتيل، كما بلغ عدد النازحين في معسكرات التهجير نحو 2.5 مليون نازح، كما أشارت إحدى الدراسات أن حجم الانفاق على حرب دارفور منذ بدأ الحرب في عام 2007 بلغ أكثر من 41 مليار دولار، تحملت حكومة الإنقاذ منها نحو 24 مليار دولار، والمجتمع الدولي نحو 17 مليار صرفت على قوات اليوناميد.
انطلقت مفاوضات السلام مع حركات الكفاح المسلح في مدينة جوبا، وتمخض عنها توقيع “اتفاق سلام جوبا” في 31 أغسطس 2020 بعد نحو عشرة أشهر من انطلاقها، ولعبت حكومة جنوب السودان دورا محوريا في تلك المفاوضات حيث كلفت كبير مستشاري رئيس الدولة ممثلا عنها. والشاهد أن الاتفاق وصف ب “المثير للجدل”، حيث ظل موضع جدل وسجال بعضه دستوري وآخر سياسي، ووصفه آخرون بأنه مشهد سمج وممل في مسرح العبث السياسي السوداني، وذلك لاندفاع المفاوض الحكومي لتوقيع الاتفاق بأي ثمن، دون النظر إلى مآلات وانعكاسات ذلك في المستقبل، لذا تم رفضه/انتقاده على المستوى القومي من قبل بعض الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات القومية والناشطين السياسيين وكذلك من طيف واسع من أهل دارفور كبعض الحركات المسلحة وبعض الإثنيات لأن الاتفاق لم ينصف مواطن دارفور، كما رفضه أهل المسارات الثلاث كالمؤتمر الجامع لأرض الحضارات لمسار الشمال والمجلس الأعلى لنظارات البجا من مسار الشرق، كما رفضه المجلس الأعلى لتنسيقية مسار الوسط ومنبر البطانة الحر الذي يجمع كيانات ممثلة للمسارات الثلاث. والشاهد أن تلك الانتقادات لم تجد آذانا صاغية تستجيب لذلك الجدل من المؤسسات صانعة القرار. والمثال الصارخ لرفض الاتفاق هو قفل الميناء في شرق السودان من عموم قبائل البجا المناهضة لمسار الشرق قبيل الانقلاب المشؤوم، وهو مثال لثمرة تالفة من ثمرات ذلك التجاهل. وحاليا جهرت العديد من الأصوات منادية المنادية بإلغاء سلام جوبا برمته. والآن وللأسف الشديد وبعد كل هذه الانتقادات يجرى تنفيذ الاتفاق بعسف وأحيانا بصلف وتارة أخرى بشيء من العاطفة. والغريب في الأمر أن سعي الحكومة لتوقيع اتفاق السلام كأحد مهام الفترة الانتقالية اكتسب قدسيه وجدية في تنفيذه بخلاف التراخي الذي صاحب تطبيق بقية مهام الانتقال الأخرى (18 مهمة)، والتي من أهمها قيام المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وعدد من المفوضيات المختلفة والاهتمام بمعاش الناس كجزء من حل الضائقة الاقتصادية وتطبيق العدالة الانتقالية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.
ويقف وراء الجدل حول اتفاق سلام جوبا عددا من الأسباب مشمولة في ثلاث عناوين رئيسية، وتدخل بعض هذه الأسباب تحت أكثر من عنوان، ولا يتسع المجال للدخول في تفاصيل مكامن الجدل تحت هذه الخطوط العريضة في هذا المقال، إلا أنه يمكن اختصارها كالتالي:
أولا: تقاطع الاتفاق في كثير من مواده وبنوده مع قواعد أساسية تخضع لها الدولة ومع موجهات عامة مرعية تقليدا وعرفا، حيث تركت الحكومة التنفيذية “طواعية” ملف السلام لمجلس السيادة، وكان هناك خلطا في قيادة التفاوض من قبل وفد الحكومة حيث جرى مع كيانات ثورية كالجبهة الثورية في مسار دارفور، وأحزاب سياسية كحزبي مؤتمر البجا والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة في مسار الشرق والاتحادي الديمقراطي في مسار الوسط، وشخصيات لا تملك وزنًا سياسيا أو اجتماعيا كما في مسار الشمال والوسط، وغاب عن المفاوضات أكبر فصيلين مسلحين في دارفور وكردفان، وهما على التوالي حركتي تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة عبد العزيز الحلو، وغابت كذلك بعض الاثنيات الأخرى ذات الثقل السكاني من دارفور، كما غابت عنه مؤسسات المجتمع المدني ومعظم إن لم يكن الأحزاب السياسية. وبغياب الأخيرة هذه وقَعَ الاتفاق في نفس الخطأ التاريخي لاتفاق السلام بين حكومة الإنقاذ وحركة تحرير السودان المعروف ب (اتفاق نيفاشا)، اقتصرت فيها المحادثات على حكومة الإنقاذ والحركة الشعبية لتحرير السودان وممثلو المجتمع الدولي، وكان من الممكن أن تصبح هذه القوى مجتمعة جزءا من السلام وتقوم بدور مقدر فيه وتساهم في ديمومته. وبالنسبة لسلام دارفور على وجه الخصوص جرى التفاوض بين ممثلي الحكومة والحركات المسلحة (حسبما تم ذكره آنفا) لتكون المحادثات شبه دارفورية – دارفورية، وفتح ذلك الباب واسعا لاتهام الأطراف الموقعة بالتواطؤ لالتقاء مصالحهم وتعاطفهم مع بعض قضايا التمييز الإيجابي والتعويضات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الخصوص ليس ببعيد عن الأذهان حديث رئيس حركة جيش تحرير السودان السيد مني ماركو مناوي بعد توليه منصب حاكم إقليم دارفور، بوجود بنود سرية في الاتفاق سمّاها اتفاق جنتلمن (gentlemen)، من أهمها أن تغض الطرف الحركات الموقعة على الاتفاق عن تسليم البشير والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية كأحد أهم ما ينادي به أهل دارفور إنصافا لهم وتحقيقا للعدالة، مقابل عدم تسليم العسكر السلطة للمدنيين والصمت حيال التحقيق في جريمة فض الاعتصام. وإذا ثبت ذلك فقد يُعد ذلك التواطؤ مؤامرة كبرى في حق مواطن دارفور خاصة والوطن عامة، وقد يُسقط ذلك اتفاق سلام جوبا برمته. كذلك نص الاتفاق على إصدار عفو عام في الاحكام الصادرة والبلاغات ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها رغم القاعدة العامة التي لا تجيز الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما نص على تعيين عدد من ضباط حركات الكفاح المسلح من الرتب الرفيعة استثناءً في القيادة العامة وأن تكون فقط إجادة القراءة والكتابة هي معيار اختيار الضباط وأن لا يحال مقاتلو قوات حركات الكفاح المسلح الذين أدمجوا في المؤسسة العسكرية والأجهزة المهنية إلى التقاعد خلال ال 6 سنوات الأولى من دمجهم، بغض النظر عن الأسباب التي قد تستدعى إلى الإحالة كالعمر على سبيل المثال حسب قوانين القوات المسلحة السودانية.
ثانيا: بما أن الحكومة هي الممثل لكل الشعب في قضاياه العامة، إلا أنها لم تقف على مسافة واحدة من أطراف العملية السلمية شكلا ومضمونا، خاصة للتشابه التاريخي بين أقاليم السودان في الظلم إذا صح التعبير. فإقليم دارفور ليس بالعنزة الفاردة في معاناة أهله من قضايا النزوح والتهميش والهجرة مقارنة بأقاليم السودان الأخرى وإن اختلفت الأسباب، فإذا كانت عوامل الطبيعة من جفاف وتصحر في ثمانينيات القرن الماضي قد أدت إلى النزوح الاضطراري لأهل دارفور ليصار لاحقا إلى هجرة قسرية بسبب الحرب، فإن أسباب النزوح الاضطراري لأهل الشمال سبقت أسباب النزوح في دارفور بعشرات السنين. وبالرغم من أن هذا التشابه استوجب تحليلا موحدا لقضايا الأقاليم المختلفة ومقاربة متماثلة في حلها، من حيث الاقتسام العادل للثروة والسلطة، إلا أن الاتفاق منح دارفور حقوقا ومزايا تفضيلية يراها البعض تحيزا، وهو ما يعضد الزعم بأن المفاوضات كانت دارفورية – دارفورية. حيث جاء اتفاق مسار سلام دارفور في 79 صفحة، محكمة الصياغة وشاملة من حيث المحتوى لكل القضايا السياسية والتنموية والاقتصادية ووسائل وآليات ومواقيت وأحيانا مصادر تمويل هذه الآليات لإنفاذ بنود الاتفاق، وفي المقابل وقَعَت اتفاقات مسارات الشمال والشرق والوسط في حوالي 9 إلى 11 صفحة فقط لكل منها، اتصفت بضعف الصياغة وضآلة المحتوى وعدم شموليته في مخاطبة جذور مشاكل هذه المسارات، كما أن بعض القضايا الواردة فيها لا ترقي أن تكون ضمن اتفاق السلام، بل هي من المهام التي يمكن للمحليات القيام بها، على سبيل المثال في مسار الشمال ورد النص التالي “تلتزم الحكومة السودانية بتوفير الأشجار المثمرة للحد من ظاهرة التصحر، وكذلك تلتزم الحكومة السودانية بتوفير مياه الشرب النقية لكل الإقليم”. ومرد الضعف والضآلة أن هذه المسارات أقحمت اقحاما غير مبررا حيث تم ردفها فقط في هذا الاتفاق، إذ لم تكن هذه الأقاليم طرفا في حرب مع الدولة، وكذلك للعجلة التي تم بها اختيار الشخصيات الموقعة، وفوق ذلك يرى البعض أن هذا الاختيار تم جزافا لعدم وجود معايير صارمة لهذا الاختيار، علاوة على أنها لم تكن مستعدة أصلا بشكل لائق للتفاوض، ولم تقدم أوراقا تفاوضية جامعة تخاطب قضايا هذه الاقاليم واجتراح كيفية حلها. وذلك بعكس الأطراف الموقعة على اتفاق سلام دارفور، فهي قيادات تاريخية للجهات التي يمثلونها ومتمرسة وخبرت دروب ودهاليز عمليات وفنون التفاوض واستعدت بشكل له جيدا. كذلك وفي الجانب الاقتصادي منح الاتفاق إقليم دارفور تمييزا إيجابيا في الثروة يفوق كثيرا ما منح للسارات الأخرى، حيث ألزم حكومة السودان بتوفير 750 مليون دولار سنويا لمدة عشر سنوات من تاريخ توقيعه (وهو أمر قد يصعب توفيره لظروف السودان الاقتصادية الحالية)، كما ألزمها بسد الفجوة المالية المطلوبة لتنفيذ اتفاق سلام دارفور علاوة على توفير 100 مليون دولار أمريكي خلال 30 يوم من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، كما سمح الاتفاق لحكومة دارفور باقتراض أموال من الخارج بضمان حكومة إقليم دارفور ضمن سياسات الاقتصاد الكلي، كما سمح لإقليم دارفور باستغلال بعض الموارد في الإقليم الأخرى، مثل استخدام الحوض النوبي في الزراعة لتوطين الرحل. أما في جانبه السياسي، فبخلاف مسارات الشمال والشرق والوسط، فقد غطى اتفاق سلام جوبا بإسهاب اختصاصات رئيس حكومة إقليم دارفور والسلطات التشريعية والتنفيذية والاختصاصات الأخرى، ونص على مراجعة التقسيم الإداري ومستويات وهياكل وصلاحيات واختصاصات الحكم بعد ستة أشهر من تويع الاتفاق إذا تعذر قيام مؤتمر نظام الحكم في السودان المناط به ذلك، وعلى استيعاب أبناء وبنات دارفور في الوظائف العليا والوسيطة (من وكلاء وزارات وسفراء ومديرين عامين ….إلخ) بنسبة 20%، وفي الخدمة المدنية وفي السلطة القضائية بعد اصلاحها والنيابة العامة بنسبة 20% في كل منها خلال 6 أشهر من الاتفاق، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 15% من مجموع المقبولين في الجامعات والمعاهد العليا لأبناء دارفور في التخصصات الطبية والبيطرية والهندسية والإنتاج الحيواني والمختبرات الطبية والصحة العامة والأشعة والصيدلة والهندسة، وتخصيص ما لا يقل عن 50% من مجموع المقبولين في جامعات دارفور لأبناء دارفور وإعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية في كل مؤسسات التعليم العالي لمدة عشرة أعوام من توقيع الاتفاق واستثنى الاتفاق الحركات السياسية المسلحة من شروط الأحزاب السياسية لسنة 2007، كذلك منح الاتفاق إقليم دارفور حق تسجيل الزواج والطلاق والميراث والمواليد والتبني والانتساب، وهو ما يتعارض مع دستور وقوانين البلاد، كما منح الاتفاق أطراف دارفور الموقعة عليه نسبة 25% من مجلسي الوزراء والمجلس التشريعي. أما ما يخص وسائل وآليات تنفيذ الاتفاقات وأيضا بخلاف ما جاء في اتفاقات المسارات، فقد نص اتفاق سلام دارفور على تشكيل 8 مفوضيات ومجلسين و3 بنوك وصناديق و6 لجان، وحدد بالتفصيل كيفية تكوين ومهام واختصاصات ومصادر تمويل هذه الأجسام.
ثالثا: هناك عددا من المواد في الوثيقة الدستورية التي خرقها اتفاق سلام دارفور، ومن أخطر هذه الخروقات أن يسود قانون سلام دارفور في حالة تعارض احكامه مع الوثيقة الدستورية رغم أنها هي القانون الأعلى بالبلاد كما أسلفنا، ولا يلغى أو تعدل أحكامها إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي. ومن الخروقات أيضا دخول الحركات المسلحة إلى الخرطوم قبل “نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج” حسب ما نص عليه الاتفاق، واقحام مسارات الشمال والشرق والوسط في الاتفاق السلام بالرغم مما نصت عليه الوثيقة بأن يتم عقد اتفاق سلام بين الحكومة والحركات المسلحة. واستثنى كذلك الاتفاق موقعي اتفاق السلام من حظر الترشيح في الانتخابات بخلاف ما نصت عليه الوثيقة الدستورية بعدم أحقية أعضاء مجلس السيادة والوزراء وولاة الولايات وحكام الأقاليم على الترشح في الانتخابات العامة التي تلي الفترة الانتقالية. وصادق رئيس مجلس السيادة بمفرده على الاتفاق بالرغم من أن المصادقة من صميم عمل المجلس التشريعي، وفوق كل ذلك ترك الحكومة التنفيذية ملف السلام طواعية للشق السيادي من الحكومة خاصة العسكري منه، كما أسلفنا.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الحديث عن اتفاق مسار دارفور دون بيان بعض تداعياته على المشهد السياسي عامة، وكذلك على كيفية تفادى الآثار السالبة لهذا الاتفاق، لأن توقيعه والتراخي في تنفيذ بعض المرتكزات الأساسية للوثيقة الدستورية، كانت وستكون له عدة تداعيات سالبة آنية ومستقبلية. ومن أهم التداعيات الآنية: بروز المنظور القبائلي والعنصري في الممارسة السياسة الحالية وهو الأخطر على السياسة، حيث ولّد الاتفاق غبنا وأثار ضغائنا في نفوس عموم أهل السودان بما في ذلك بعض كيانات وحركات دارفور، وبصفة خاصة لسكان أقاليم المسارات الأخرى لما تعرضوا له من ظلم واضح في هذه الاتفاق. حيث لم تخاطب اتفاقات المسارات جذور المشاكل في الأقاليم المعنية وفارق الاتفاق التوزيع العادل للثروة والسلطة. كذلك وبعيد توقيع الاتفاق وبدء تنفيذ سلام دارفور خرجت قوات الأمم المتحدة (اليوناميد) من دارفور، مما أسهم في تفجر الأوضاع واستمرار الحروب الأهلية فيها بنشوب أعمال عنف وقتل. وأسهم الاتفاق بشكل لا جدال فيه في قيام انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي تعاني البلاد بسببه حاليا واقعا بئيسا من فراغ دستوري وأزمة سياسية هي الأعمق منذ استقلالها، كما تعاني من فوضي أمنية وانفلات في الأسعار غير مسبوقين، وقتل العشرات وجرح المئات في المناهضات الشعبوية لهذا الانقلاب، ورفض بعض الوزراء من الحركات المسلحة الذين جاءت بهم المحاصصة نتيجة الاتفاق التخلي عن وظائفهم الدستورية التي انقلبوا عليها، مما أسهم بقوة في انغلاق الأفق السياسي الذي تعيشه البلاد حاليا، وكان ذلك أي تمسك هؤلاء الوزراء بمناصبهم أحد المتاريس التي واجهت رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة تكنوقراط من مستقلين بناء على اتفاق 21 نوفمبر بين البرهان قائد الجيش وحمدوك رئيس الوزراء، ودفعته للاستقالة من منصبه. وشهدت الفترة منذ بد المفاوضات وتوقيع اتفاق سلام دارفور بكثافة التدخلات الخارجية حيث لعبت بعض دول الجوار ذات المصالح في السودان أدوارا خبيثة حماية لمصالحها، خاصة في ظل الفراغ الأمني (المتعمد) الذي تشهده البلاد خاصة بعد سقوط نظام الإنقاذ. والغريب في الأمر أن الحصول على المناصب (المحاصصة المشار إليها) هو أول البنود الذى تم تنفيذه من تفاق سلام جوبا، حيث لم تحظى بنود الاتفاق الأخرى في مسارته المختلفة بذات الاهتمام. أما التداعيات المستقبلية للاتفاق فمن أهمها احتمال (لا سمح الله) تقسيم وتفتيت البلاد في إطار ما يعرف بسايكس بيكو (2)، ونشوب حروب يتعدد أطرافها واحتمالات تدويل الشأن السوداني، وكذلك الوصول إلى نقطة اللا عودة ونبذ لغة الحوار كلية بين الحكومة وأقاليم الشمال والشرق والوسط، وبالتالي اللجوء إلى طرق أخرى لإسماع صوتهم في مواجهة التجاهل الحكومي لمطالبهم المشروعة، كحمل السلاح (لا سمح الله) كما حدث في جنوب السودان (سابقا) وغربه (لاحقا)، مما قد يهدد الأمن والسلم المجتمعي اللذان ظلا سمات ايجابية بارزة تميز أهل هذه الأقاليم.
لتفادي الاثار السالبة من تطبيق اتفاق سلام جوبا والسعي لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم ينعم به كل أهل السودان، حفاظا على وحدة تراب الوطن ووصولا لاتفاقيات تسهم في التنمية المتوازنة والشاملة والمستدامة في كل أرجاء البلاد، تزيل ما لحق ببعض أجزائه من غبن وتقلل من آثار التهميش، يجب تجميد العمل باتفاق سلام جوبا برمته أي بكل مساراته، خاصة أن الاتفاق لم ينصف كل أهل دارفور ولم يحقق لهم العدالة المطلوبة، وهو ليس أوثانا مطروحة للعبادة، وذلك إلى حين تكوين مؤسسات الانتقال المعنية بإجازته والموافقة من مجلس تشريعي ومحكمة الدستورية ومفوضية للسلام لعرض الاتفاق عليها. ومن الأجدى أن يسبق التفاوض حول جذور المشاكل في كل المسارات دراسة شاملة تشخص الأسباب الحقيقة النزاعات في السودان والقضايا الرئيسية ومخاطبة جذورها (دراسة الوضع الراهن ومن ثم الإسراع في عمليات جبر الضرر وانفاذ العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى الشروع الفوري في تنفيذ الترتيبات الأمنية وتوحيد الجيوش المتعددة تحت القوات المسلحة السودانية، مع ضمان إنفاذ الإصلاحات التي تضمن مهنيتها وقوميتها، وأن تتحول الحركات المسلحة إلى أحزاب سياسية. وبالنسبة لدراسة الوضع الراهن يجب العمل على قيام مؤتمر قومي شامل لكل إقليم على حدة، يخاطب قضايا الإقليم وتحدياته التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويخطط لغد مشرق لإنسانه تحقيقا لرفاهيته وأمله في العيش الكريم، على أن يكون المؤتمر برعاية حكومية والتزام منها بإنفاذ توصياته.
- المقال مختصر من ورقة شاملة في ذات الموضوع ستنشر قريبا بحول الله، والقصد منه هو إلغاء حجر في بركة ساكنة لإثارة نقاش كثيف حول الموضوع
د. سيد تمام
اقتصادي وباحث سياسي
(sayedtamam@gmail.com)