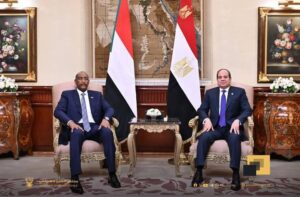في رثاء الحسيب النسيب السيد على الميرغني: هل أمهاتنا بيولوجيا أم ثقافة أيضاً؟ (٣-٣)

من عيوب التراجم التي يكتبها المتعلمون بالمدرسة عن أنفسهم أنها غالباً ما بدأت بمدرسة ما لا البيت. فقد تشربوا عقيدة بخت الرضا من أن موضع ميلادهم في الثقافة هو يوم دخولهم مدرسة “المبشر” (والاستعمار بعثة تبشيرية قبل كونه بعثة اقتصادية) لا في بيت من أب وأم. فقال قريفث، الذي من وراء خيال معهد بخت الرضا ومناهجها، إن المدرسة التي توافر على صناعتها فينا “خضراء دمن” أي أنها المرأة الحسناء في منبت السوء. ومنبت السوء هنا هو البيت. وعليه صار الأم والأب عند خريج المدرسة من حقائق البيولجي فحسب لا حقائق الثقافة.
لم يكن لي ترف الترفع على ثقافة البيت وأمي هي جمال أحمد حمد إزيرق مثقفة جيلها. خضعت معها لمنهج صارم في الثقافة التقليدية في الحجا والغناء (يا للمغني النوبي) والمديح والرد السريع والدعاء (اليسويبك واليسويبك)، والصاح والغلط (قالت لي مرة والله لو شغل الحكومة دا عيش ما تاكل). ولكن كانت أكثر دروسها أحاطة بي وعناية ونفاذاً هي محبتها للسادة الختمية. كان لا يطربها شيء مثل ذكرهم وما عداهم “زي الواطا دي”.
في مناسبة يوم المرأة العالمي أعيد نشر مقالة نعيت بها الحبيب النسيب السيد على الميرغني (وفاته في ٢٣ فبراير ١٩٦٨) الذي جلست إلى كورسات يومية تلقيها جمال أحمد علي عنه، بل وإلي “معامل” جربت علي فيها كل بخرة منه وذرة رمل من مقابر المحجوب. وهذا في معنى قولي إن جمال لم تكن مجرد بيولجي كأمهات كثير من صفوة تعليم المدرسة (دعا عليها الشيخ علي بيتاي فقال إن شا الله يقرقر فيها البعشوم) بل ثقافة لها إيقاع وأريحية وقوة.
وفي شباب سيدي وفي المدينة تعلمنا أول درس في النظافة والنظام وتلاقي الألوان وتضادها بعد أن ظلت الدمورية الشاحبة ثوبنا وجلبابنا وعمائمنا. وفي موالد سيدي دخلت الكلمة حياتنا بالإيحاء والوقع والشحنات العاطفية. وحين يطبق المساء ويلتقي المريدون وتبدأ قراءة الموالد تصبح الكلمات أكثر رفاهة والتصاقاً بالعاطفة. وتتعطر بالسر وبالشفافية والألق. وحين نرى انكباب المريدين، وقد تجاوز بعضهم أميته فحفظ عن ظهر قلب لوحاً، واحتفظ به لنفسه بحق اذاعته دون الآخرين، كانت الكلمات تزداد إشراقاً ونغماً وخصوصية. وحاولنا حين أمسكنا بسر الحروف وهجائها أن نربط بين الخطوط التي تتشابك على أوراق اللوبيا لنكون منها اسم سيدي بين فرحتنا المزدوجة: وجود اسم سيدي حتى على ورق اللوبيا، وبهجتنا بسلوكنا المستقل دون عون في التوصل إلى فك مخبوء الحروف.
وفي المدينة تساقطت من ذواكرنا معالم القرية واحدة أثر واحدة. حائط السوق، وبئر ود جيني، ونخلتنا الجميلة. وبقي السر الأعظم والغموض الأكبر بحضورهما المستمر في ذاكرتنا يتخطيان بنا شظف عيشنا، ويمطران عافية على الفراغ النفسي الناجم عن صدامنا صراعاً ومجاهدة مع وجه المدينة الغليظ والبارد والمتهجم.
أسعدتنا الظروف، هذه أو أخرى، بزيارة لسادة ببحري أو كسلا أو سنكات فحل وصل خفف من غلواء الوجد، وشذب غموض السر، وكسر حدة إبهامه. وطفقت المدينة تشمخ، ويسمق فيها البناء، وتتعدد الأسماء، والروح واحدة. وقالوا استقل بنو السودان وارتفع علم البرلمان. وهيل وهيلمان. وامتص اختلاط الحابل بالنابل على معنى كريم وسمو أصيل وانهار الضمير وتداعى الخلف. نشأ برلمان فما انعقد حوله ولاء الأمة، ولا استقطب روحها الغارق في الدسيسة، والمسحوق بحذاء المصلحة والغرض، بين المستشفى أو المدرسة أو مكتب الجنسية، دون أن يمس الحاجة الروحية والإنسانية. وانما هي أرقام والسلام يرد ذكرها في خطاب الميزانية دلالة على أن العناية بنا زائدة. وأن أمرنا في أيدٍ موثوق بها. وتولى أمر هذه المؤسسات قوم لا يحسنون صنعاً ولا يردون جميلاً لشعبهم. ما يلجأ إليهم المحتاج حتى يزداد اقتناعاً بأن الحاجة آفة مذلة. جردوا المؤسسات الحكومية في المدن من كل محتوى روحي.
ومن هنا افترقت بالناس الطرق، وأهلنا أقاموا على العهد القديم ويا سيدي علاجهم، وقُوتهم، ومسرتهم بهذا البلد وما عليه.
وأخذنا طريقاً آخر. حملنا هتاف الثورة في حناجرنا لتملأ مؤسسات الحكم والخدمات انسانية تَنّزل على روح شعبنا المهدود المكدود بلسماً واشتراكية. افترقنا. وما تبين لي إلا مؤخراً أننا حين أخذنا الطريق الجديد كانت تزدحم في افئدتنا، وتملأ اخيلتنا، وترهف احساسنا تهاليل أهلنا، واذكارهم، ودعواتهم الصالحات، وروحهم العامرة بالخير عطاء واستقبالاً. شهد الله في خاطري ومستقر شعوري “سفينة” أهلنا الختمية ما تزال خضلة. وعاطر صداها في مسمعي يصدح بها أهلنا إذا قدموا لختان أو عرس من رهافة العبير وطلاوته وموسيقاه. ومن شحنة الشعور والروح في كل ذلك تحسسنا دربنا لكي نقضي على برود الذهن، وبؤس العاطفة، وسماجة الخيال الذي يطبق على مصير بلادنا. وأن نقيم على أنقاض ذلك عناق المؤسسية الاجتماعية وحلال العيش، فنستقطب فيها البدن والروح، ونعيد التئامهما وتمازجهما كسابق العهد.
وحين افترقت بنا الدروب عن دروب السيد كانت بنا حدة وغلظة لا يجمل والمقام هكذا أن نتطرق لتفاصيلها. ومضت بنا الأيام. وإذا بنا نحلم مثل ما يحلمون، وما نزال وما يزالون. ويبدو أننا وحين افترقنا كانت أقدامنا جميعاً (لأبي ابراهيم) التي يودع بها أهلنا بعضهم البعض.
قلت لأمي وأعرف فيها وهناً بفعل السنين حين انتهى إليها نبأ وفاة سيدي.
-أبك قدرة على السير من وراء النعش؟
– أجي “سيدي” مو ولدنا وأبونا.
حملت القاطرة خالي للعزاء. وحين التقى بوالدتي شالا الفاتحة وتعانقا في أسى وهزيمة وانكسار. كنت أقول: من لهما من بعد هذا؟ من لهؤلاء الذين غمطتهم المدينة حقوقهم في الراحة النفسية والشعورية، وشمخت دورها الكافرة البشعة في وجوههم؟ من لهم إذا دعوا وقد كان حضور السيد علاجهم وشبعهم وريهم وخلاصهم. حزين على قومي. حزني عليهم. فليس لهم من بعد من يؤلف قلوبهم، ويرشدهم، ويقوم زلتهم، ويتغاضى عن زيفها، ويمنحهم صبراً على مرارة الأيام وصروف الليالي.
الموت حق. ويرعف القلب والعين ولا نقول إلا ما يرضى الرب. محزونون، محزونون، محزونون. وقد قيل في أدب الختمية: إذا كنت في هم وغم فنادني. ونحن قد عاشرنا الهم والغم وتزاوجنا بهما وأنجبنا الشائه والمجدور والمجذوم.
أعوذ بالله، ثم أعوذ بالله، ثم أعوذ.
IbrahimA@missouri.edu