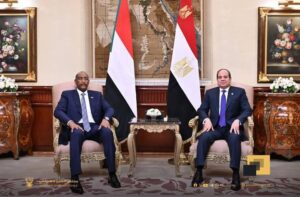توطين السذاجة في مديح (هبنقة)

“العالم في خطر.. البشرية تسير ناحية الهاوية..” انقذونا
من فيلم هوليوودي يظهر البطل وفريقه في طريقهم لإنقاذ الكون من خطر وشيك، ولإيهامنا فإن ضرورات التشويق تقتضي أنهم يواجهون الخطر المصطنع الذي قد يتمثل في “قنبلة ذرية” وقعت في أيدي جماعة مهووسة، عديمة النُبل والإنسانية، وهم حملة السلام، السلام للعالم. وفي مشهد آخر يطل أحدهم وهو يهم أن يُفعّل شفرة محروسة ليدمر بمحتوياتها العالم بأسره، وأيضاً ولمزيد من السلعنة تظهر فتاة دقيقة الملامح تبدو مرفهة ترتدي سترة سوداء إمعاناً في التحديق، فتاة تحمل حقيبة مُرقمة بالسر، وفي داخلها أنبوب شفاف طوله 60 سنتميتراً يحوي خلاصة تجارب معامل طبية استخلصت نفسها في النشأة لعلاج الكائن الحي، وإنقاذاً للألم من رهن الأجساد، لكن أمراً ما جعلها تُغيّر نشاطها لتنتج فيروساً قاتلاً وصيته تدمير البشرية والعالم في ثواني عند الانطلاق، كل هذا ليس عبثاً بل هو صميم عمل الحياة؛ حياة يراد لها أن تكون سعيدة في النهاية، ولأن لكل عالم نهاياته المؤقتة، فإن مفهوم التسعيد يظل مقبولاً في سياق ترويج الخير المشروط، والشرط أن تكون سعادتنا رهينة البطل، وفي ذلك يُستبعد الأغبياء والسُذَج، إذ لا مكان لهم في هذا الكون، فالغلبة لقانون القوة وسلطة الأقوياء، وتتبدى معالم السلطة الموصوفة بالخير في حشر جمهرة من الناس مساكين، وأشغالهم مستهلكة، ينتظرون أن يتفق ذهن البطل عن حلول سماوية فوق طاقتهم، هؤلاء هم جمهور البطل، جمهوره المصاب بعدوى التصفيق المُلقن، كم هي مؤثرة تضحية البطل هذه، بل ومجانية يلقيها كتحية عجلى على البسطاء وهم صاغرون، ذلك أن كل شيء إلى زوال.. إلا البطل، يا لمديح الأغبياء من شأن منفرٍ ومهجوس بالاستعارة والتنميط.
فكما تنحو الفلسفات الحديثة إلى إعادة الاعتبار لماهيات ظلت مغلقة ومستبعدة، بل وممنوعة من التأسي والانحياز، وهي على هذه الحال تولي اهتماماً لدرس النقصان، وبذلك فإن المعرفة تمارس تمييزاً سلبياً تجاه العالم وإنسانه، فالمدح للذكاء والفطانة والرفاعة قد يبدو معقولاً، لكن البحث في جوهرانية هذه الصفات يكشف لنا إلى أي مدى تتبنى المعرفة أشكالاً من الامتياز تدافع بها عن نفسها والآخرين محل القيادة، ولذلك لن تجد من يتجاسر بمدح العّي والغبي والمُغفل، فمن جملة المعارف المقموعة مفهوم السذاجة، عجيب أمر هذه اللغة تنتخب مغارفها من أشكال قد تبدو متينة وأكثر جسارة على البقاء، ولكنها في النهاية تواجه بهذا الوهم المسمى الرفيع من القيم، وقد يبدو البحث في مفهوم مثل “السذاجة” انصراف إن لم يكن تجافي عن قضايا عديدة لا تزال تحتاج إلى السبر والبحث والاستقصاء، لكن من السذاجة ترك مثل هذا المفهوم يجوس كيفما شاء ووفقما يريد، ومن السذاجة أيضاً الانصراف عن تقعيد هذا المفهوم/التهمة دون مساءلة، ولذا وجب في الصورة، صورة السذاجة، فكلما ترد كلمة السذاجة يتراءى للذهن صورة من البله والغفالة ونسيان الإرادة، فالساذج شخص يعتبر بالأمور محل التفاهة، ولذلك فهو ساذج إذ لم يعترف بالقانون الاجتماعي الذي يرتفع بالأشياء إلى مصاف العلو وسمو المقام.
فالساذج شخص فطري النزعة يملك بياض فوق القانون، ولم يخضع بعد لسلطة القيم، وحتى القول بالحُجة غير البالغة، فمنتهى البلوغ المعني يجسد بالكامل فكرة الخضوع لتراتب أو تركيب يكتسب شرعية معنوية من خلال ممثلين له. والمظلمة الرئيسة التي يتعرض لها الإنسان هو الإيقاع به بعيداً من حيز النخبة الموصوفة بالفكارة ودقة المنطق، ولا شك بوجود هيمنة لقيم بعينها يتم استنباتها من داخل حظائر الوعي، وهذه القيم مسئولة عن تحديد مستوى العيش الاجتماعي، وفكرة تساوى المَلكات تظل فكرة عرفانية، تهرب باستمرار من السطح لتعلن مساواتية بين الناس، ولكنها في العمق تقيم تفرقة ذهبية، تفعل ذلك في عالم افتراضي، ولا يهمنا هنا السطح بقدر النزوع المسيطر على الممسكين بسُلَم المعارف يعملون حثيثاً على تنميط البطولة المتشحة بالذكاء عملاً على قمع البقية كونها فاقدة لأهلية التمايز والانتماء.
في مديح (هبنقة):
يعج قاموسنا العربي بنماذج للغباء المتهوم، وبفضل هذا الإصرار على الدفع بالغباء جريمة استقر في الذهن نموذج للشخص عديمة الحيلة، ومواصفاته هي: الكسل الذهني – التسليم باللاحظوة – الاندفاع للأذى الجماعي بفضل تصرفاته الذاهلة عن المتن والمتجهة أكثر ناحية الخوف؛ الخوف من إبداء الرأي مع تجاسر في الفعل، إن توفير فرص للوقوع على الغبي في تراثنا الشعري والأدبي أمر جيد لباحث يريد الوصول إلى صورة منمذجة للغباء والسذاجة، لكن انشغالنا هنا يريد الوصول إلى شروط التسذيج التي تلازمنا كثيراً ونحن نطالع شؤون العالم، وبالفعل يريدنا الأدب أن نقول بأن الساذج هو قرين السائمة، وهي إذ تكتفي بالرعي في أكثر الحول، فإنه يتشبع بالسكون رغم ربقة الانقياد، كما أن من مواصفاته “السفه” وهي بحسب الجرجاني دالة على الخفة يتعرض لها الإنسان من الفرح والغضب فتحمله على العمل خلاف طور العقل.
ويفيدنا جداً أن نعيد القول بأن ثمة جنس سري يظل قار في عمق الظاهرة يعمل على التوجيه والتحديد والمحاكمة، فهل العقل شيء آخر خلاف التقييد، ففي اللغة يقال: “عقلت البعير، أي قيدته”، لنضف إلى قاموس السذاجة أن أصحابها مقيدون بقانون البعير/النخبة، والمزاوجة هنا بينهما تظل في صالح النخبة، فالبعير يسير بالقافلة، والنخبة تُسيّر العامة.
والمهم في سيرة الساذج/الأحمق هو الموقع الذي يحتله من الذاكرة، فإنه لو فتح المزاد لإضافة عناصر بناء الشخصية ولو بغرض التشويق لما تمكنا من إيقاف سيل التهزيم والتقزيم تجاه معنى السذاجة ودور الساذج، إن الأمر أشبه بسيرك ريفي كل المشاهدين فيه يحفظون عن ظهر قلب تفاصيل العرض ويعلمون أسراره، لكنهم ورغم ذلك يبدون الدهشة والاستنكار والتساؤل عن سر هذه الأشكال من الغرائب والصور المختلقة، فالقصد من تبيان دور السذاجة في حقيقته محاولة من عالم الأذكياء تمييز أنفسهم عن الآخرين، فكونك ذكي وشديد الحرص على صورتك الاجتماعية فإنه ينبغي مبدأً أن تصنع مغايرك بالصورة التي تمكنك من إضافة قوالب جديدة وفي كل مرة لحافظتك من التعالي، ونحن إزاء حالة تبادلية، فكلما كان الساذج شخصية موغلة في الغرائبية ومتمكنة من انتزاع الشتيمة، كان الذكي حاملاً لواء المغايرة أنصع وأكثر بياضاً، وهذا هو حال القانون الاجتماعي الذي تعارف عليه البشر، لا وجود لشجاع دون جبان، والشجاعة درجات كذلك كما الوهن، والغباء بدوره درجات تتغذى عليها مستويات التذاكي.
لعله يتحتم على العالم إعادة النظر في قضية البلاهة والغباء، لأنه من غير الممكن أن تتحقق المعادلة بوجود البطل دون الخائن/الضحية، إذاً ومن باب أولى إعادة الاعتبار لهذه الثنائية بالشكل المحقق للعدل، ومن ذلك دور الأطباء النفسانيين في تشخيص هذه الظاهرة غباء/ذكاء، ولأجل ذلك فالوعي الكامن في الذاكرة عن الشخصية الغبية سيتحرر بشكل كبير من هيمنة التجريم المطبق على كل ما يخالف قانون الأقوياء، بالله أليس من السذاجة أن يكتب المرء ألف كلمة ليدافع عن الغباء في مواجهة الذكاء؟. لا، بل التحية للسذاجة في زمن البطولات المزيفة..