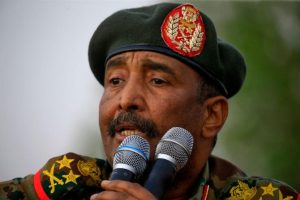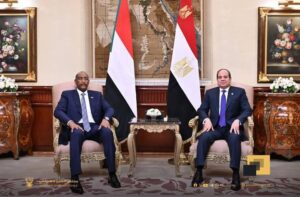معرض فرانكفورت للكتاب وغياب العربية
كسوف عربي عن عالم صناعة الكتاب

مقدمة
ما أطيب قول شاعر النيل حافظ إبراهيم عندما أشار إلى جلال وبهاء لغة الضاد:
وَسِعْتُ كِتابَ اللَهِ لَفظاً وَغايَةً وَما ضِقْتُ عَن آيٍ بِهِ وَعِظاتِ
أَنا البَحرُ في أَحشائِهِ الدُرُّ كامِنٌ فَهَل سَأَلوا الغَوّاصَ عَن صَدَفاتي
إسبانيا والوطن العربي والكتاب:

احتفى معرض الكتاب في جولته الأخيرة لعام ٢٠٢٢ بإسبانيا، مملكة وشعبًا، كضيف شرف في هذه الدورة التي جاءت بعد عامين من الغياب الحقيقي للزواد ومؤسسات الإعلام ودور النشر بسبب جائحة كورونا. لم يجِئ هذا التكريم من الفراغ! فتعتبر إسبانيا من أكبر الدول التي تستهلك القراءة والكتب على حد سواء ذلك حتى على النطاق العالمي. ومقارنة لإنتاجها في هذا المجال وإنتاج الدول العربية فنجد إن هذه الأخيرة لا تنتج ولا حتى حوالي الخمسة بالمائة مما تنتجه هذه الدولة الذكية من علم ومعرفة واستنارة. والمقارنة بين الدول العربية ودولة إسبانيا أو لنقل مملكة إسبانيا جديرة بالتمعن، حيث مكث العرب في أرجائها ما يقارب الثمانية قرون، لكن أين ذهبت كل تلك العلوم التي أدت إلى نهضة حقيقة وسلام وأمن، ومن ثمّة أين ذهب علماء العرب الذين وطدوا لنهضة الدول الغربية وأسسوا لما يسمى بعصر التنوير والنهضة التي كانت الانطلاقة الأولى لتفوقهم وارتقاء شأنهم في المسائل العلمية والأدبية والاجتماعية بكل ما تحمل هذه الكلمات من معان عميقة ودروس ثرّة. ذلك نبراس لكل الأمم لا سيما دول العالم العربي من المحيط إلى الخليج فضلًا عن الدول الإسلامية كاملة اللهم إلا من رحم ربي. لم يفت ملك إسبانيا أن يكون حاضرًا بهذا المعرض الذي يعتبر أكبر معرض للكتاب في العالم على الإطلاق وكانت نقطة الثقل فيه تُعنى بقضايا الترجمة ونقل العلوم والآداب من الإسبانية إلى لغات العالم أجمع. لذلك نجد حسب البيانات التي نشرت من قبل اللجنة المنظمة للمعرض أن أكثر من ثلاثمائة مؤسسة تنشر باللغة الإسبانية كانت حاضرة، وبالتالي لم تكن دعوة الشرف منحصرة على الدولة الإسبانية بذاتها – ذلك على سبيل التدقيق – لكن منفتحة لكل الدول والمؤسسات التي تنشر بتلك اللغة أو بالمنقطة اللغوية التي تتحدث الإسبانية كلغة أم وهذا لم يمنع من أن تشارك لغات رومانية وغيرها في تلك البوتقة المزهرة، فجاءت لغات إقليمية مهمة كالكتالونية (أو الباسكية)، التي نجد فيها ترجمات هامة جدًا من وإلى اللغة العربية، ونذكر بأن هذه اللغة كانت من اللغات الهامة قبل انتشار اللغة الإسبانية في مناطق كثيرة من شبه الجزيرة الإيبيرية وقد كتب علماؤها بها وباللغة العربية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر العالم الكتالوني رومان لول.
غياب لغة القرآن … ما الأسباب:
يا سادتي إن معرض فرانكفورت للكتاب هو دون مغالاة أكبر معرض للكتاب في العالم، يوفر للحضور من دور نشر وزوار مساحات واسعة للتبادل الثقافي وللحوار المتمدن ويعتبر هذا المعرض، دون أدنى شك، من أكبر المنصات التسويقية والتجارية للكتاب بكل أشاكله، المسموع المقروء، البودكاست، الخ. لكن وللأسف سجلت الدول العربية وجامعتها غيابًا واضحًا في سماء هذا المعرض الفخيم بمدينة فرانكفورت الألمانية ذلك من ناحية الكم وحتى من ناحية الكيف، على حد سواء. فجاءت دول قليلة تعد على أصابع اليد، أزعم للتمثيل الرمزي فحسب، فكان بالتالي حضروها الفعلي هزيلًا، نلخصه في بهاء ورونق أماكن العرض وفخامة التكريم للزوار وبعض المعروضات أو التظاهرات الخجولة.
الحقيقة يا سادتي، فإن الذي يريد أن يتعرف حقا على بلد ما أو أمّة ما فينبغي عليه الاطلاع على أدبه/أدبها. ولقد رأينا خلال تجولنا بالمعرض وفي مناسبة هي حقيقة لائقة لهذا الأمر، إذ أُتيحت لنا الفرصة لنرى ما وصلت الشعوب من رقي وتقدم في مجال الأدب خاصة والعلوم عامة وفي التقنيات التي يمكن أن تخرج بهَا هذه المنتوجات الفكرية. فالأدب المعاصر يقدم نظرة شاملة عن تفكير وسلوك الناس اليوم، وذلك بعكس الأدب الكلاسيكي. وهناك ميزة إضافية أن اللسان الذي يستخدمه الأدب المعاصر لأي لغة كانت هو في الحقيقة لسان الشعوب والأفراد بل وصوتها الذي يعيش وينبجس من عيون مجتمعاتها الدافقة، فيعتبر الأدب كسيزموغراف لتحركات دواخل الشعوب وما يجوش بأعماقها.
تمعنت بعد غروب شمس معرض الكتاب بهذه المدينة المشرقة أن أعيد ما قلته في غير موقع، حديث عن العربية والعرب في يومها العالمي، وعن تضييعنا لها بدلاً من دعمنا لها، لما فيه من آيات بيّنات لكل كاتب وناشر وحادب على حريّة الكلمة وحرية التعبير. شاركت في هذا المعرض، وللأسف وجدت أن الأغلبية من الناشرين والعارضين العرب قد شابت معروضاتهم سمة التقليد والركود والرجعية، فلا تزال تلك “الكتب الصفراء” تباع حتى في هذه المعارض التي تحمل على أعلامها رسائل سامية عديدة وجليلة، منها التنوير والسلام والإخاء. ولا تزال القلوب تقدح بالتملق والكذب والزيف ومحاربة الرأي الآخر دون حجج بيّنة. يا ليت هؤلاء مرّوا على أجنحة الدول الأوروبية ليروا ما وصلت إليه هذه الشعوب من رقي، إتقان وسمو في صناعة الكتاب، الارتقاء برسالة الكلمة فضلًا عن حريتها. وسوف أعود في الاقتباس أدناه لهذه الأمور. ولقد لخصت محنتنا وحضورها على السياق الدولي في مقال كتبته في مناسبة “يوم العربية العالمي” وهاكم مقتطف منه:
اقتباس:
كلمٌ أغرّ وصوتٌ أبرّ، في لحنها ونغمها، وقعها ونبرها، لغة القرآن ووحي الإنسان، هالة من نور ودرر من سرور، لكن هل من داعٍ للسرور وللافتخار وحتى للغرور؟ لغتنا العربية يا سادتي في عيدها العالمي أو لنقل في مأتمها العالمي في محنة وأيّ محنة، بمخمصة وأيّ مخمصة، أوضعناها في جُبّ يوسف الأمين، في صحراء بوادٍ غير ذي زرع؟ وهل تهافت عليها أبناؤها ليقضوا وينقضّوا عليها، أم أنها لفظت أنفاسها الأخيرة بين أنياب الذئب؟ وكأنما يا إخوتي قد جئنا بقميصها، مضمخ بدم كذبٍ، في حضرة أبيها الساميّ يعقوب، متصافقين ومعلنين موتتها الأبديّة؟! لكنها كما يوسف، سترى برهان ربّها بعمل أهلها والحادبين عليها، بالدأب والمثابرة الحقّة، وسيرى جميعنا – إن عملنا بنكران ذات – أن أحد عشر كوكبا والشمس سيخرّون لها ساجدين.
لغتنا الضاديّة الساميّة، رغم جمالها وألقها، لسانها وفصاحتها، حلاوتها وشهدها، غزارتها وإرثها التليد، الذي لا يزال يتدفق منذ أكثر من أربعة عشر قرن ونيّف مدرارًا كالسلسبيل، هي الآن بغرفة الإنعاش المكثف! أرانا نحتفل في الثامن عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) بيومها هذا ونفتخر ونقول ملئ أشداقنا أنها صارت – يا إلهي – لغة الفيفا ومسي ونيمار وليفندوفسكي، بل ذهبنا إلى أبعد من ذلك لنطلق عليها لسان الأمم المتحدة – أم هي في الأصل الأمم اللامتحدة. من جهة أخرى هل يدعو الراهن في محنتها العالمية هذه بربكم للاحتفاء والاحتفال؟ وهل يدعو حالها الآنيّ للغبطة والسرور؟ أم يدعو أغلب الظنّ للندب والبكاء، وللنحيب والمكاء؟ أين هي بربكم من محلها في الإعراب؟ هذه اللغة كانت يومًا ما لغة العلم والفن والحضارة، لسان الشعر والأدب والفلسفة، صوت الحق والأذان والأديان، نداء المعارف الإلهية وصدى الحقائق الكونية، بحر بمداد لا ينفد ولا ينضب، ولو جئنا بمثله مددا! دعوني أطرح التساؤلات الآتية: أنبكي على أطلال أندلس مفقود كانت فيه هي سيدة المكان والزمان؟ لقد صار فعلنا فيها ولها مبني للمجهول، فاعلنا غائب ومفعولنا لا مكان له من الإعراب وحتى بيننا نحن الأعراب.
أنندب حظنا العاثر على أطلال جامعات النور في طليطلة والبندقية وحتى في أقصى جنوب فرنسا حينما كان “الكتاب” في الطب لابن سيناء يلقن كمرجع من المراجع الأساسية بلغة الضاد. أنبكي على هوامش الطرقات الضيقة بين الحارات والحانات كما شعراء التربادور، (الشعراء الجوّالون) ونحث خطانا حثًّا في أزقة غرناطة وبلد الوليد لنقول هاهنا عاش ابن زيدون وها هناك أشعرت ولادة بنت المستكفي ووقتئذ دندن زرياب بعوده الرنان تحت أشجار الصفاف والقرنفل، نسرد ونقص القصص لأحفادنا وأحفاد أحفادنا أن كل هذه الدرر راحت بلا رجعة وانتقلت بفضل العرب والعربية إلى كل أنحاء أوروبا دونما تنتقل إلى أصلها في وصحن مملكة الأمويين، راحت نعم بلا رجعة ليستنير بنورها أبناء الغرب وأحفاد موليير وجوته وفكتور هيجو، وانطلقوا لا يلوون على شيء عبر لغتنا التي نحتفي بها، إلى آفاق العالمية وبلغوا بها عصر النهضة والتنوير، حلّقوا على براقها إلى عطارد العلم ومشترى المعرفة، نعم بلغتنا العربية نحن الأعراب، فأين هم الآن وأين نحن، وأين لغاتهم في دور العلم والمعارف وبالجامعات الشامخات، وأين لغتنا العربية بينها؟ هل تقدِّرون يا سادتي الخسارة المعنوية، التاريخية الجسيمة في هذا الفقدان المبين، وهل تحسبون الفارق المعرفي والمخزون العلمي بين ألسنتهم وألسنتا؟ هي بلا جدال، وحدث ولا حرج، سنين ضوئية ويا حادي العيسِ عجل وصلنا كما غناها صباح فخري، عندما صدح ب “لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت في الدجى الإبل” بلسان الشاعر المنسي أبو الحسن محمد بن القاسم. وهذا المشهد المبكي المحزن، والذي تنزف من وطأته الدموع، يذكرني بالخروج من الأندلس كما حاكتها ريشة الأديبة رضوى عاشور في ثلاثية غرناطة وكما سردت وقائعها في مقال سابق بعنوان: “ثلاثية غرناطة والأندلس المفقود”. ولغتنا العربية بحق وحقيقة أندلس مفقود. في ساعة الخروج والهروب تلك، خوفًا من ملوك القشتاليين، وقف أحد ملوك قرناطة على تل وبكى فصاحت بهِ أمّه: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟! وأنا أقول أما آن لنا نحن العرب أن نترجل، ونترك البكاء على الأطلال ونصنع فيفا العربية الخالصة وأممها المتحدة التي توحّدنا نحن العرب، ومن نسى قديمه راح، أي ضاع، وإن نسينا أربعة عشر قرنا من الحضارة المتعلقة بلغة الوحي والتنزيل، لرحنا، وبالأصل نحن رُحنا سلفًا في عداد الغابرين، إلا أن يشاء ربي.
الحضور العربي الخجول:
إن الحضور الفعلي لا الرمزي هو في نظري بمثابة فرصة كبيرة لنقل وترجمة وترويج الأدب العربي في ألمانيا خاصة، وبالعالم الغربيّ عامة إذ أن شعب ألمانيا والعالم الغربي هما من أكثر الشعوب نهمًا للأدب والفكر. لكن وللأسف لقد خمدت حركة الترجمة الناشطة التي عرّفت بالكثير من الكتاب والأدباء العرب في سماء أوروبا والعالم، ذلك في خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم، ويمكن أن نقول بأنها كانت جيدة وفعّالة في ذلك الحين كمرآة لجمال الكلمة العربية وعمق أدبنا العربي وأصالته التي ظلت مهضومة الحقوق في كل الأزمان. لذلك لا بد لنا من أن نطرح تساؤلات هامة وجديرة بالتمعن مثال قضية نمو تجارة الكتاب في العالم العربي ومن ثمّة نشره وترويجه، وأن ننقل محنة الأدب العربي من المقاهي إلى المنصات الإلكترونية لنصل به إلى العالمية التي ينشدها كل كاتب كتب كلماته لأن تُرى وتقرأ وتسمع ويشار إليها بالبنان. كما يجب على الدول العربية والمؤسسات المعنية بالأمر أن تتناول مسألة التحديات التي تواجه الكتاب العرب، وأيضا الناشرين العرب في الغرب من جهة والناشرين الدوليين الذين يودون الدخول في السوق العربية من جهة أخرى، فضلاً عن التطور المتناسى أو المنسي من الجهات الرسمية في الدول العربية للأدب والأدباء فالعالم العربي به من الأدباء من يمكنهم الوصول إلى العالمية كما وصل إليها نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، رضوى عاشور والطيب صالح، فأدبنا، وهنا أتحدث كمعنيّ بالأمر، يشهد صحوة حقيقة اليوم بين الشباب والشابات من الكتاب الأفاضل،حتى ولو أنها لا تقارن بالكم والكيف مع حركة الأدب وحراكه المستمر في الغرب.
Mohamed@Badawi.de