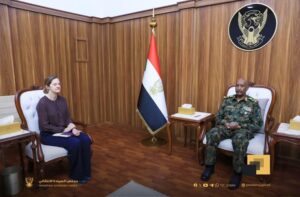ِلمَ مات الراهب؟

رُوزنامةُ الأسبوع
الاثنين
رغم أن إيقاف الحرب ضرورة قصوى، إلا أن ثمَّة تحفُّظات ينبغي، للأسف، عدم إغفالها بشأن ما صار يُعرف بـ “اتِّفاق سلام جوبا” بين حكومة حمدوك الانتقاليَّة التي انتهت ولايتها بانقلاب 25 أكتوبر 2021م، وبين بعض مكوِّنات الجَّبهة الثَّوريَّة السُّودانيَّة التي تضمُّ حركات مسلحة وغير مسلحة، من دارفور، وجنوب كردفان، والنِّيل الأزرق، وأقاليم أخرى. ونقول لمن تثور ثائرته، كلما وجدنا نطالب بإعادة فتح هذا الملف، ومناقشة هذه التَّحفُّظات، إن خطورتها ناجمة مِن كونها، إذا لم يتمَّ الالتفات إليها، الآن، يمكن أن تعيق، غداً، تطوُّر العمليَّة السِّلميَّة في أيَّة مرحلة قادمة، لذا ينبغي تداركها، باكراً، من جانبين على الأقل:
الجَّانب الأوَّل: هو الخلل البنيوي في إجراءات التَّفاوض، حيث أن:
(1) المفروض أن الطرفين كليهما هما، في الأصل، طرف واحد، فالحركات المسلَّحة في «الهامش» تنتمي إلى نفس الثَّورة التي تنتمي إليها حكومة الانتقال في «المركز»! لذا يُخشى أن يفضي المنهج المتَّبع حاليَّاً، إلى وضعهما بإزاء بعضهما البعض، كخصمين متعاديين، نفسيَّاً على الأقل، ليس في جوبا، فحسب، بل في مستوى مجمل علاقاتهما المستقبليَّة!
(2) التَّفاوض نفسه كان ينبغي أن يكون تفاهماً ودِّيَّاً بين طرفين داخليَّين، لولا خراقة التَّصرٌَّفات العدائيَّة التي بعثت، منذ البداية، برسائل سالبة مِن قِبَل جنرالات “اللجنة الأمنيَّة”، كاعتقال ياسر عرمان، مثلاً، وترحيله، مصفَّداً بالأغلال، إلى خارج البلاد!
الجَّانب الثَّاني: هو المتعلِّق بعدم وجود فارق جوهري كبير بين هذا الاتِّفاق وبين ما سبقه من ترتيبات فاشلة، سواء في أبوجا مع حركة مناوي، أو في الدَّوحة مع حركة خليل وجبريل، أو ربَّما حتَّى في ضاحية نيفاشا الكينيَّة مع حركة قرنق وسلفاكير. بعض مظاهر انعدام هذا الفارق هي:
(1) عزلة “أصحاب المصلحة stake holders”، في معسكرات النُّزوح واللجوء، عن المشاركة المباشرة في عمليَّة السَّلام، بما فيها ترتيب عودتهم إلى مواطنهم الأصليَّة؛
(2) ثنائيَّة التَّفاوض بما أقصى عنه القوى السِّياسيَّة الوطنيَّة والاجتماعيَّة؛
(3) عدم إلحاق حركتي عبد الواحد والحلو بهذا التَّفاوض، ولا يعلم غير الله، حال التحاقهما مستقبلاً، مصير الاتِّفاق الرَّاهن، والمحاصصات التي تأسَّس عليها، وكشف الكثير من نخب “الهامش”، عبرها، عن تطلعاتهم بشأن “السُّلطة” و”الثَّروة”، مِمَّا أقرَّ به حتَّى جمعة كندة، مستشار رئيس الوزراء السَّابق للسَّلام، وإن اعتبره، مِن عجب، “أمراً لا غبار عليه”! وقد فاق ما أبدى هؤلاء مِن تكالب على هذه “المكاسب”، حرصهم المفترض على قضايا السُّلام نفسها!
(4) عجز الاتِّفاق، كسابقيه، عن الاهتمام باستعادة أراضي الوطن السَّليبة، حلايب وغيرها، أو، على الأقل، باستعادة أراضي المجموعات الإثنيَّة، وبالذَّاًت «الحواكير» في دارفور؛
(5) إقحام مسألة التَّعويضات في التَّفاوض، قبل حسم إجراءات “العدالة الانتقاليَّة”، أو المسؤوليَّة عن مصائر الشُّهداء، والجرحى، والمفقودين، خصوصاً في مذبحة ساحة الاعتصام؛
(6) غياب أيِّ توجُّه جادٍّ للمحاسبة على الفساد، أو لتسليم المخلوع وهارون وبقيَّة مطلوبي “المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة”؛
(7) عدم ترتيب آليَّات لا غنى عنها لقضيَّة السَّلام، كـ “المجلس التَّشريعي”، و”مفوضيَّة السَّلام”، بمنأى عن ولاية مجلس الوزراء، وترك الأمر برمَّته لما يسمَّى بـ “المجلس الأعلى للسَّلام” الذي لا يُعرف له سند دستوري!
(8) تجاوُزُ بعض الآماد المنصوص عليها لأمد حكومة الانتقال ذاتها!
الثُّلاثاء
لجان المقاومة برزت، أصلاً، كخطة في غاية العبقريَّة، إذ أن المهام التي يُفترض أن تؤدِّيها لا يُفترض أن تؤدِّيها أيُّ تنظيمات أخرى، ولا تتماهى، بوجه خاص، مع أنشطة أيِّ حزب سياسي. ولئن كانت هذه المهام تلامس، برامجيَّاً، وفي حدِّها الأدنى، احتياجات المواطنين “الصِّحيَّة” المتصوَّرة، فإنها تلامس، في حدِّها الأعلى، بلا أدنى شكٍّ، احتياجات المواطنين “الأمنيَّة” المتصوَّرة كذلك. فإذا أخذنا، مثلاً، حالة الانفلات الأمني السَّائدة منذ حين، والتي راح ضحيَّتها عدد من المواطنين، وقد لا يكون آخر نماذجها المؤسفة حادث الابنة ترتيل الطيِّب عثمان، لتجلَّت أمامنا ضرورة تنظيم دوريَّات شبابيَّة، ليل نهار، مِن أجل الحماية الطوعيَّة للأسواق، والأحياء السَّكنيَّة، والشَّوارع الطرفيَّة دعماً للآليَّات الرَّسميَّة. فلا يظنَّنَّ كريم أن النهوض الأهلي، بهذه المهام مخالف لشعار “السِّلميَّة”، أو أنه يخرق القانون بأيَّة كيفيَّة، إذ ليس في التَّهيُّؤ لممارسة “حقِّ الدِّفاع الشَّرعي” عن النَّفس والغير أيُّ “عنف” أو خرق للقانون!
الأربعاء
لست مِمَّن يؤمنون بـ “نظريَّة المؤامرة”، لكنَّني، أحياناً، لا أجد في غيرها ما يفسِّر بعض الظواهر، أو المشكلات!خذ عندك، مثلاً، “النَّفخ” و”الغُلوَّ” اللذين ظلَّت تمارسهما الأنظمة الشُّموليَّة، خصوصاً النِّظام البائد، في ما يتَّصل باقتصاديَّات الصُّحف، لجهتي الجَّمارك والضَّرائب، بالأساس، دَعْ بقيَّة بنود التَّكلفة، حتَّى أضحى سعر الصحيفة اليوميَّة عبئاً لا يطيقه منسوبو الطَّبقة الوسطى الذين يشكِّلون القوَّة الشِّرانيَّة الرَّئيسة على هذا الصَّعيد!
ما زلنا نذكر كيف ظلَّ أفراد الشَّعب، مِن مختلف القطاعات، بمن فيهم حتَّى طلاب المدارس الثَّانويَّة، يتزاحمون، منذ أوَّل الصَّباح، عند “أكشاك الجَّرائد” للحصول على نسخهم من الصُحف، حيث كانت كلٌّ من “الأيَّام” و”الصَّحافة”، على سبيل المثال، توزع ما يبلغ، على أيَّام عبود والنِّميري، حوالي مائة ألف نسخة، يوم لم يكن سعر النُّسخة يتجاوز الخمسة قروش، ناهيك عن المجلات السُّودانيَّة والأجنبيَّة. وليس مِن سبيل، بطبيعة الحال، للمقارنة مع سعر الصَّحيفة الذي قفز، على أيَّام النِّظام البائد، قفزات مجنونة، حتَّى بلغ، خلال الثُّلث الأخير مِن ذلك العهد، خمسين قرشاً، ثمَّ ما لبث أن واصل القفز، بقوَّة ذلك الدَّفع اللامعقول، إلى أن بلغ اليوم ٢٨٠ جنيهاً، ما يُعزى إلى الرَّفع المتواصل لتكلفة جمارك وضرائب استيراد الورق، والأحبار، وغيرها من مدخلات الطباعة. فقد كان سعر طن الورق، مثلاً، يتراوح، في منتصف الثَّمانينات، بين ٥٠٠ ـــ٦٠٠ دولار، ثمَّ أخذ يزداد حتَّى أضحى يتراوح، حاليَّاًً، بين ١٠٠٠ ـــ١٢٠٠ دولار تسليم ميناء بورتسودان بدون جمارك وترحيل، علماً بأن نوعيَّة الورق تتفاوت ما بين العادىstandard، والآخر مِن الدَّرجه الأولى الأكثر بياضا Waterproof. حيث يبلع فرق السِّعر بينهما بين ٣٠٠ – ٤٠٠ دولار فى الطن، وقِس على ذلك أسعار مدخلات الطباعة الأخرى، كالأحبار وغيرها، مِمَّا جعل النَّاس ينفضُّون مِن حول الأكشاك، لهذا السَّبب، كما ولغيره من الاسباب السِّياسيَّة المعلومة بالضَّرورة (!) فلم يعُد ثمَّة مَن يشتري الصُّحف الورقيَّة، أو حتَّى يقرأها إن صادفها. أمَّا متابعتها “أون لاين”، فدونها خرط قتاد المعارف التِّكنولوجيَّة، وأسعار الحواسيب وتكلفة النِّت، وتكلفة مقاهي الانترنت، دَع عنك عذاب التَّيار الكهربائي، حتَّى لو تيسَّر كلُّ ما تقدَّم من عوامل!
وبعد، فإذا علمنا أن الصُّحف مِن أهمِّ مصادر المعرفة السِّياسيَّة، فهل، ترى، يكون في الأمر عجب إن تصوَّرنا “مؤامرة” ما في إبقاء الأنظمة الشُّموليَّة على كُلفة صناعة الصَّحافة عالية، وبالتَّالي على سعر الصَّحيفة خارج متناول اليد؟!
الخميس
بعض ممثلي القوى الاجتماعيَّة مِمَّن أفادوا من النِّظام البائد، ثمَّ عادوا، الآن، يدعمون محاولات استعادته المستحيلة، وصفوا “إقرار” المخلوع ، أمام محكمة مدبِّري انقلاب 1989م، بمسؤوليَّته وحده عنه، دون مشاركة المتَّهمين الاسلامويِّين الآخرين، عسكريِّين أو مدنيِّين، أحياءً أو موتى، بأنه “إقرار ينمُّ عن شجاعة فائقة”!
“الشَّجاعة”، كقيمة إنسانيَّة، إمَّا أن تكون متَّسقة مع “المنطق”، أو لا تكون! لذا فإن هذا “الاقرار” لن “ينمَّ عن شجاعة فائقة”، إلا إذا قرنه المخلوع بتفسير “منطقي” لـ “إقرار” سابق نقلته عنه وسائط مرئيَّة، بالصُّورة والصَّوت، بأن الانقلاب وقع بتعليمات “الجَّبهة الاسلاميَّة القوميَّة”!
الجُّمعة
أسعدني أخي عفيف اسماعيل، في مهاتفة من أستراليا، بأن زفَّ إليَّ، مع تباشير العام الجَّديد، خبراً مبهجاً بأن الصَّديق الشَّاعر الفذ عاطف خيري بدأ في مراجعة قرار محزن كان قد سبق له اتِّخاذه بالاقلاع عن قرض الشِّعر .. بخٍ بخِ!
السَّبت
تعرَّفت، قبل أكثر مِن نصف قرن، إلى الأخ الأكبر، والصَّديق الحميم، وعالم الأحياء الفذ، البروفيسور احمد عبد المجيد، عبر زمالة دراسيَّة رائقة مع شقيقه الأصغر المرحوم البروفيسور سمير “فوزي”، وقد تحوَّلت إلى صداقة أم درمانيَّة عذبة، بين المرحلة الثَّانويَّة في السُّودان، والجامعيَّة في الاتحاد السُّـوفيتي. كما أسعدتني الظروف، قبل زهاء الأربعين عاماً، بالقرب من الإنسان الطيِّب، والمربِّي الفاضل، والأب الرَّءوف، والمعلم الحكيم، المرحوم العميد يوسف بدري، فأصبت من نَعماء معرفته الكثير، وازددت نعماءً حين طالعت مذكِّراته الدَّسمة التي سكبها في سِفْره القيِّم “قَـدَر جيل”. وكـنت، ذات حفل أقيم لتكريمه، سمعـت المرحـوم العالم عبد الله الطيِّب يصفه بـ “المُسَلَّط”، أو ربَّما “الانسلاطي”، وعجبت، كون الوصف ذاته، بصيغة الجَّمع، سبق أن سمعت العميد نفسه يطلقه على مَن تصدَّوا لتأسيس جامعة أم درمان الأهليَّة، ومن خلال معرفتي بأحمد ويوسف، لاحظت عمق المحبَّة والوفاء بينهما، مِمَّا سرى، لاحقاً، إلى علاقة أحمد و”العميد الإبن” قاسم، وبينهما وكلِّ من التحق بالمجموعة الماجدة، تحت مظلَّة “الأحفاد”، كليَّة، ثمَّ جامعة شامخة للبنات. وإذ شرَّفني بروف أحمد، وناشره مركز عبد الكريم مرغني، بأن دفعا إليَّ بمخطوطة كتابه عن هذه العلاقة كي أقدِّم لها، فإنني شاكر لهما هذه الثِّقة وهذا الشَّرف.
ظلَّ بروف أحمد يلقِّب “العميد الأب” بـ “الأسطورة”. وعندما تصفَّحت المخطوطة التي تتبَّعَت مراحل ذلك الإنجاز المتجاوز نحو تأسيس الكليَّة، تحت قيادة العميد من فوق ربوة سنام أسرته الميمونة، وعبر مسيرة تتَّسم بأقصى ما في الجُّرأة من دلالات، ثمَّ تطويرها، إلى جامعة تقدَّر أعداد خرِّيجاتها بالآلاف، فإنني لم أفاجأ بهذا القدر الهائل من “المحبَّة” و”الوفاء” ينبثقان من كلِّ حرف، ويفيضان من كلِّ سطر، كبعض شيَم الكاتب، وبعض خصال المكتوب عنه،
أمَّا الركيزة الثَّالثة لهذه الكتابة فهي “العمل”، حيث في كلِّ فقرة تمجيد لقيمته، شاملاً نشر “المعرفة”، وإشاعة “الوعي”، كطاقة دَّافعة للنَّهضة، بل وللوجود الإنساني نفسه.
“العمل”، إذن، وليس أيُّ “عمل”، إنَّما المقترن، وجوباً، بالمحبَّة، والوفاء، والإخلاص، والإتقان، والعزيمة الصَّادقة، كان وسيلة العميد يوسف الأساسيَّة، هو وكلّ من تجيَّش خلفه، وفي مقدِّمة صفِّهم الأوَّل بروف أحمد، فور أن بلغته دعوته للالتحاق به في مغامرة تأسيس المشروع ـ الحلم، ما يعني ترك جامعة الخرطوم، بكلِّ عسل ستِّيناتها المشتهى، تأسِّياً بالمثل القائل: “الصديق الوفي هو مَن تجده إلى جانبك عندما يكون بإمكانه أن يوجد في مكان آخر”!
ويدلِّل بروف أحمد على “العبقريَّة الأسطوريَّة” للعميد بما حدث، مثلاً، مطلع 1967م، العام الثَّاني لتأسيس الكليَّة، فقد كان كالحًا تميَّز بالجَّفاف، حيث لم تتقدَّم أيَّةُ طالبة للالتحاق بها. لكن العميد لم يجزع، أو يصيبه اليأس، فاستطاع أن يجد، بين بنات أسرته وأصدقائه، من يعالج بهنَّ المعضلة. ويروي بروف احمد أنه عندما ذهب يشكو للعميد من تعثُّر استيعاب الطالبات، خاطبه الأخير قائلاً: “ما تقلق يا أحمد، الفرق بينَّا وبين الناس التَّانيين إننا بنخلق من الفسيخ شربات”! وفي موضع آخر يؤكد بروف احمد أن “كلَّ مَن لازم العميد تعلَّم منه ما لم يكن يعلم، وأنا واحد منهم، إذ رأيت فيه دائماً كوكباً درِّيَّاً يشعُّ ذكاءً وحكمةً وعطاءً، ينظُم العلم في قلادات من ورود الياسمين، يفوح دومـاً عطـرها، وما العطـر عند العبقـري بشحـيح”. ويواصل بأن العميد ما نَشِبَ يذكِّر بعبارته الخالدة: “لا إرهاب في التَّعليم”، لا يرمي بذلك “إلى علم القلم فحسب، بل إلى الدِّيموقراطيَّة نهجاً وأسلوباً في الحياة عموماً”. ويضرب، في موضع ثالث، مثلاً لاقتدائه بـ “العبقري الأسطورة”، حيث ظلَّ يعمل معه، طوال ربع قرن، محاضراً غير متفرغ بجامعة الأحفاد، بدون أجر مالي، إذ “خصَّصتُ استحقاقاتي الماليَّة كمنح شهريَّة تستفيد منها طالبات الجَّنوب، وجـبال النُّوبا، ودارفور، والشَّرق، وكان (الأسطورة) يمنحهنَّ مجانيَّة التَّعليم، كما خصَّص لهنَّ منزلاً كداخليَّة بالمجَّان داخل الحرم الجَّامعي. وكانت د. عواطف مصطفى تستلم استحقاقاتي وتوزِّعها عليهنَّ، بشرط ألا تذكر المصدر، تيمُّناً بشيم عطاء قدوتي السَّخي الزاهد المتجرِّد في توفير فرص التَّعليم الجَّامعي للمهمَّشات”، وهذا نفسه هو ما سار عليه، لاحقاً، العميد الإبن قاسم.
قبل ذلك كان بروف أحمد قد حدَّثنا، في مطلع كتابته، عن أوَّل تعارفه مع العميد يوسف، وهو لمَّا يزل طالباً بكليَّة العلوم بجامعة الخرطوم، يؤدِّي، ذات أمسية من ديسمبر 1957م، دور هارون الرَّشـيد فـي مسـرحيَّة “زواج السـمر” لعبد الله الطيِّب، فتقدَّم نحوه العميد، عند نهايتها، يُظهر إعجابه، ويدعوه لزيارته بالأحفاد، فسطع في الأذهان تساؤل قديم متجدِّد لطالما حاول معالجته كثير من الفلاسفة، حول جدوى الكتابة نفسها؛ وبشكل أكثر مباشرة: إلامَ يهدف بروف أحمد من كتابته هذه؟! مبرِّرات التَّساؤل تكمن في مأزق الاستلاب يستغرقنا في نمط القيم البورجوازيَّة تنشب أظفارها، ماديَّاً وفكريَّاً، في روح وعقل الحياة المعاصرة. لكن الكِّتابة، مع ذلك، ما تزال، لحسن الفأل، تتحمَّل مسؤوليَّة التَّبشير بالقيم الخيِّرة، فلا تتلهَّى عنها بالألعاب الهوائيَّة! لذا نخطئ، ابتداءً، حين نتوهَّم أن الكاتب يسعى، فحسب، لسدِّ حاجة نفسيَّة إلى نوستالجيا ما! ذلك أنه يريد، في الواقع، إيصال رسالة أكثر أهميَّة، بسرديَّة مبسَّطة، في نسق بعد ـــ كولونياليٍّ يفجِّر وعياً جديداً، يتجاوز قيم “التَّشيُّؤ” السَّائدة، ويتماهى فيه “الموضوعي” مع “الأخلاقي”. أنظر، مثلاً، إلى واقعة أوَّل زيارة قام بها بروف أحمد إلى مكتب العميد في الأحفاد، تلبية لدعوته له أمسية المسرحيَّة، يقول: “وأنا أدخل المكتب استرعى انتباهي الأثاث المتواضع. وعلمت، لاحقاً، أن طاولة الكِّتابة، وكرسي الخـزران، هما بعض إرث والده الشَّيخ بابكـر بدري. وقف العميد يصافحني، ويدعوني للجُّلوس على أحد المقعدين أمام الطاولة، ولدهشتي كانا حاويتي شاي خشبيَّتين فارغتين قُلبتا على ظهريهما”! وبرُغم ما قد يبدو على السَّمت الخارجي لهذا السَّرد من بساطة، إلا أنه لا يمكن اعتبار الكاتب قد استلَّ هذه الواقعة العابرة من التَّاريخ الاجتماعي لسودان ما بعد ـــ الكولونياليَّة قاصداً التَّلهِّي النُّوستالجوي! بل إنه ينحو للرَّبط بين “الموضوعي” و”الأخلاقي”، مركِّـزاً على مشروعيَّة التَّطلُّع لتحقيق الذَّات، وخلق “الوجود المغاير”، بعبارة التِّجاني يوسف بشير، بغضِّ النَّظر عن الفقر الشَّائع، وقلة الحيلة المادِّيَّة الموروثة من أزمنة الاستعمار، عبر المتاح من الإمكانات الذَّاتيَّة، بالغاً ما بلغت من التَّواضع، لأجل بناء مجتمع تتحقَّق فيه كرامته وتُحترم. وهكذا يتماهى شرط الكتابة “الأخلاقي” وشرط الكيان المعنوي للكاتب، مِمَّا يعيننا على اكتشاف ما رمى بروف أحمد لإعلائه على خلفيَّة ما استمدَّ مِن العميد.
لذا لا نكتفي بالإشادة بانتباهة بروف أحمد لتخصيص هذا الجَّانب من مذكِّراته لعلاقته بالعميد، وبمؤسَّسة الأحفاد، بل نحثَّ كلَّ من بلغ إسهامه في العمل العام مبلغ الكاتب لأن يحذو حذوه بتسجيل مذكِّراته، كليَّاً أو، على الأقل، جزئيَّاً، بما يحيط بأهمِّ الجَّوانب؛ فما أحوجنا إلى كلِّ تفصيلة في تاريخنا الاجتماعي.
أخيراً، وبعد صراع طويل مع المرض، غادر دنيانا، ضحى السَّبت 7 يناير 2023م، بروف احمد الذي نسأل الله أن يتقبله القبول الحسن في الفراديس العلى، وأن يكرم نزله، ويرفع مقامه، ويجعل مقعده مع المقرَّبين إليه، المرضي عنهم منه، وأن يغفر له، ويرحمه، إنه خير الرَّاحمين.
الأحد
في بعض البلاد انتشرت شائعة بأن ثمَّة راهباً يملك وسيلة لتمديد عمر الانسان إلى الأبد! فأرسل الملك وزيره ليعرف من ذلك الرَّاهب تلك الوسيلة! لكن الوزير، عندما وصل جبل الرَّاهب، وجده قد توفي! فاستشاط الملك غضباً على وزيره، منحياً عليه باللائمة لكونه لم يتحرَّك بالسُّرعة اللازمة! قأجابه الوزير قائلاً: “أطال الله عمر مولاي، لو كانت لدى الرَّاهب وسيلة لتمديد العمر إلى الأبد .. فلماذا مات”؟!
kgizouli@gmail.com