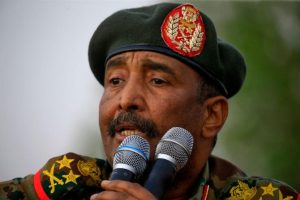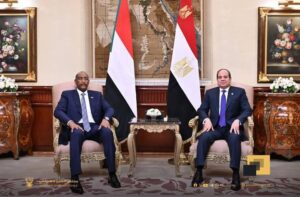لم أعد صالحاً للكتابة عن السودان!

تنقيب الظلام
(1)
أصبح كل شيءٍ عنه -لأول مرةٍ- موادَّ مُجرَّدةً ومجازيّة؛ خليطاً من صور وأصوات محادثات وتعليقات وتفسيرات، إضافةً إلى الأحلام والكوابيس (حيثُ تجري وقائع السودان يوميّاً، فإما نحن في منفىً التقينا أصدقاء المدينة القدماء، مدينة الخرطوم الماضية، وإمّا نحن في طريق النزوح، أو، وهو الأسوأ، لا نزال في الخرطوم وسط القصف والأسلحة الكيميائيّة! حدث أن رأيتُ ذلك، طائرات تُلقي أطناناً من رغوةٍ تتدفّق بدورها من أعين وأفواه وجماجم ناسٍ وجنود، وفي قلب السوق العربي تحديداً، قبل القصف بقليل –للأمارة- كان راشد عبد الوهاب، صديقنا وزميلنا الصحفي، يلاحق صبية من الجنجويد ويقول لهم: أضرب رصاص يا زول، ما بتقدر يا جبان).
عندما أهمّ بالقراءة عنه في الصحف الإلكترونية –حمدلّه على سلامة عدم فيسبوك- أجد صعوبةً بالغة ومُرهقة في العثور على مقالٍ واحدٍ، خلال بحث يومٍ كامل، يُمكِن أن يُقرأ بتأثّرٍ حقيقيّ إن كان ما كُتِبَ يأتي مباشرةً من أرض الواقع. أي كتابة سودانيّي الداخل، إن كانوا في الخرطوم أو في الولايات أو المعابر. أي من عبروا الحرب بكلّ عنفوانها وشبابها ودمها الحار المُتفجّر قتلاً ونهباً واغتصاباً وقصفاً. مهما كان شكل كتابتهم ما بين حكاية من الواقع، أو سوداويّة عدميّة ساخرة حدّ الضحك الذي تَليه دموع الحزن ثمّ الغضب.
(2)
أصبحت لمجموعة “الممر”، أخيراً، حكمةٌ من إيجادها، حتّى الاسم أصبح مستقبلياً؛ لقد كان، وما زال، ممراً حقيقيّاً؛ ففي أرض الواقع كان ممرّاً واقعيّاً للخروج من الحرب، ممراً آمناً يا قول المجتمع الدولي وأممه المتحدة. أما داخليّاً فكان ممراً للقلوب بمحبّتها، واهتمام الجميع بالجميع، دعم المبادرات وإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من ناس وحيوات. هو ممرٌّ للذكريات، الشخصيّة والعامّة، وممرٌّ للغناء والموسيقى اللذين طالتهما يدُ الحرب في أرشيفهما المادّي في جميع أنحاء المدينة، كما هو المكتبة لمقترحات الكتب، حيث أصبح الـPDF بديلاً لمكتباتنا التي خلّفناها وراءنا. كما إنه ممرٌّ لرؤية حجم الكارثة، ممرٌّ للشعر المكتوبِ توّاً (من إنتاج أعضائه الشعراء)، والقصص المروية حالاً (بكتابها وقصاصيها وفنانيها وصحفييها وبشرها وناسها وموظفيها وأطبائها..إلخ)، ثمّ المواقف السوريالية والهزليّة التي تحدث أثناء القتال.
أُنشِئت المجموعة في العام 2017م، وهي الوحيدة التي أحتفظ بها، والتي أعادتني للاتصال بكل من أحب. إنّه المكان الوحيد الذي لا يُرهقك، إذ تجد، بسهولةٍ، ما تقرأ.
(3)
لم أعد صالحاً للكتابة عن السودان بعد، إذ أنني سأكتب حينها عن سودانٍ آخر، لم يعد موجوداً، إلا أن الأطفال الذين هُرّبوا، ووُلدوا، أثناء وما بعد حادث البلاد المعتوه، يجب أن يجدوا يوماً ما سيُقال لهم إنهم من مواليده، بل مواليد حربه؛ يجب أن يجدوا صوراً وموسيقى وكتابةً وأهلاً يخبرونهم عن ما كان مدينةً، وكم هو جميلٌ أن تظلّ أجزاءٌ من السودان، إلى الآن، بأمانٍ؛ أُناسها، مبانيها، تاريخها. وكم هو قاسٍ، من ناحيةٍ أخرى، تدحرج قرىً ومدنٍ سودانيّة كُبرى إلى الجحيم في إقليمي دارفور وكردفان أثناء القتال، بل وتدمّر بعضها تماماً. لقد ذبحوا أعيان وأمراء قبيلة المساليت، ما الذي تبقى؟.
(4)
“لن أعيش خارج السودان أبداً، اللهم إلا في حالة قَصَفونا”، هذه كانت جملتي الأثيرة عندما يتحدّث معي شخصٌ عن الخروج من هذه “الحفرة” كما يُسميها الكثيرون. لم يكن لديّ أية أسبابٍ للخروج، فحياتي في الخرطوم والسودان كانت أجمل حياة وناس وتاريخ طويل.
وها قد قصفونا، دفعونا دفعاً بأسلحتهم الناريّة للهرب بحياتنا وجلودنا. والآن نحن في الخارج، كيف يمكن أن نكون صالحين للكتابة عن سودان اليوم؟. ربما كنتُ محظوظاً بكتابة الشعر، فهي تنزف الألم، ولكن كتابة عن السودان لن تكون عن ذلك الذي خلّفناه في غروب الأمس.
(5)
في العام 2012م، إبّان عملي مديراً تنفيذيّاً باتحاد الكتاب السوداني بداره في العمارات، حيث كنت أجلس وحيداً معظم النهار في مكتبٍ خارجي؛ وصل مسرعاً القاص والروائي الفاضل الكباشي وجلس على الكرسي المواجه لي، وكان مرعوباً، وفي يده الكتاب المقدّس. فتح الكتاب على صفحات معيّنة كان قد رقّمها ووضع بعض الحواشي، وقال –في تفسيره لهذه النصوص، وما أتاه من خلف الحُجُب- إن حرباً ضروساً ستندلع بين معسكرين عسكريّين في الخرطوم، وأن عليّ أن أُخبر كل من أعرف بأن لا يتدخل أي شخص في هذه الحرب، وأن ندعهم يُبيدون بعضهم البعض، بعدها –حسبه- ستقوم حكومة السودان الحقيقيّة. سألته متى؟ قال لي: قريباً جدّاً. بل قال إن الدكتور باقر العفيف سيكون الرئيس القادم! أخبرت عبد الله محمد الطيب “أبسفة” بالأمر، قال لي، إن صحّت نبوءة الفاضل فسأكون أبوبكر الصديق لهذا السيد المسيح. يا حليل الفاضل، ويا حليل الخرطوم التي كانت كلّها مسرحه وحياته.
(6)
قيل أن بيوتنا قد نُهبت، وتحوَّلت لثكنات. عندما أفكّر في ما يحدث في الجنينة الآن أقول: دعهم يستبيحون بيوتنا “القديمة” و”المهمّة” أكثر من حياة الناس، دعهم ينهبون كل شبرٍ منها ما دمنا سالمين، جسداً ولحماً –ليس عقلاً أبداً- دعوهم يستبيحون مكتباتنا ومجالسنا.
(7)
عندما أفكّر في ملتقى النيلين، المُقرن، لا يسمع ذهني سوى صدى صوت الأرض: هذا مكاني، أنا إلهتكم الأرض، وقد دمّرتم ما حوله، لكنكم لن تُدمّروا التقاء النيلين.
أتذكّر، كذلك، ما كتبه جورج أورويل حول استمرار الطبيعة أثناء الحرب العالمية الثانية: “القنابل النووية تتراكم في المصانع، وأفراد الشرطة يطوفون عبر المدن، والأكاذيب تتدفق من مكبّرات الصوت، لكن الأرض ما تزال تدور حول الشمس، لا الديكتاتوريّون ولا البيروقراطيّون ـ مهما اعترضوا بعمقٍ على العَمَليّة ـ قادرون على إيقافها”.
أمام حلّتنا بيت المال، مباشرةً، يسيرُ النيلان كتفاً بكتف. كنت أُسرع، كلما دهمتني الوحشة –كنتُ طفلا- إلى كبري شمبات، أشاهد نيلَين محدّدين يُحاولان أن يتداخلا. كُنت أُدخل جزءاً من رأسي الصغير ما بين قضبان أسوار الجسر الحديديّة، ما تسمح به المسافة، “جالساً تتدلّى قدماي”، فلا أرى ما خلفي ولا الجسر ذاته بل مياهاً جاريةً تمنحك شعور التحليق.
في العام 2008 كتبت قصيدة مطوّلة -طفلٌ يُكذِّب البراءة- في جزءٍ منها خيالات طفولتي عن كبري شمبات، حيث تجري أحداث التداخل المائي:
بأقدامٍ مغرورةٍ،
جلَسَ الصبيُّ على الجسرِ الأسمنتيِّ،
وأرجحَهما فوق ماء النيل،
ميِّتاً من الجوعِ لمدينةٍ غارقةٍ في الأسفل.
ومن حقِّه، وهو مُكْتَشِفها، أن يحكمها بوحشيِّةٍ طُفوليَّةٍ،
هو الفَرِحُ بانشغال الكِبارِ عنه بأيامهم المتلألئة على شفتيه ابتسامةً خبيثةً،
إنه، بأرجحةٍ، يدَفع الريح بساقيه لأن تُهاجم الماء الجَاري،
تركبه، وتحفر على ظهره شوارع وبنايات ملوّنةٍ،
له فيها عَرشٌ وأسلحةٌ وأصدقاء،
وهو، أحياناً، يبكي صارخاً يناديهم.
من خلفه تعبر السيارات المعدنيّة بهديرٍ حقيقيٍّ يُشوِّش أوامره للريح،
يُحسُّ بوخزٍ جبَّارٍ في ظهره،
يُحسُّ بمعدنٍ يخترق جسده الصغير،
ويخرق به حديد سياج الجسر:
رَعدٌ قديمٌ تصاعد من عينيه،
انكسرت شفتاه وجرحتا ظهر الثعبان المائيّ،
غاصت عظامه المُكسّرة في الماء،
تفرَّق لحمه بين الأمواج حديثة السنّ،
شقَّ قلبه طريقاً عبر صدره،
وغَرِقَ وحيداً في الليل الطويل الممتدّ إلى قاع النهر،
ونام.
هل كان يحلم؟
ملايين القلوب هنالك تَبني، بهمّةٍ باكيةٍ، مدينةً:
رأى قلبه عرشاً يُركَّبُ بمياهٍ سوداء لامعة.
هل كان يحلم؟
دماءٌ سميكةٌ وحيَّةٌ تُشكِّل طبولاً وكماناتٍ
أجيالٌ شَهِدت (عبور النّهر آلاف المرات)
أجيالٌ مائيَّةٌ تحتفظ بلحظات العالم بيديها السّائلة الفانية في كلّ ثانية،
موسيقى خائنة وبعيدة عن قانون الكونِ تُخَلُق بروح التيَّار،
أمواجٌ كبيرةُ السنّ تحدِّق فيه.
هل كان يحلم؟
رفع عينيه لسطح الماء
رأى جسده الصغير، مُحطّماً ومُفرَّقاً كأخشابِ زورقٍ سيء الحظ
رآه يبتسم في نومه الجديد.
(8)
في نهايات القرن العشرين الذي نمونا بين أحراشه، كان القادة يُحاسَبون على الكذب، بل إنهم يتحاشونه، ويحاولون، بقدر الإمكان، أن يُغلّفوا كل وحشيتهم ولا إنسانيّتهم ببعض ورق التوت الأخلاقي؛ دين، عقيدة، آيديولوجيا، وات إيفر، ولكنهم كانوا فعلاً مُقنّعين. أما اليوم فقد جاء عصر “القوة الصريحة”، الذي رآه هنري ميللر في منتصف القرن الماضي: “قد انطلَقَ المارد. لقد أمسَى عصر الكهرباء متخلّفاً وراءنا، كأنه العصر الحجري. عصرنا هو عصر القوّة، القوّة الخالصة الصريحة. اليوم… أمامنا: إمّا الجنّة أو النار، ولا وسط بينهما. وكل الدلائل تُشير إلى أننا سنختار النار”.
ها قد اخترنا النار، فهذه الحرب العالميّة المستمرّة منذ عقود بدأت تلتهم جميع المُدن التي كانت تقتل البشر وتسحقهم داخل أمعائها. فجأة، أصبح العالم الماضي ذو القرن العشرين أخلاقيّاً بصورةٍ فظيعة مقارنةً بما يجري اليوم. أصبح القادة “ترامبيون” جميعهم، وقحون، ولا يتورّعون عن الكذب مباشرةً في وجه العالم. جرى ذلك قبل هذه الحرب! لن يُصدّق أحدٌ كيف انقلب مديح الجنرالات لبعضهم قبل اندلاعها إلى هذه الشتائم القاتلة! الغريب في الأمر أننا ننظر إلى الأمر بسخرية مريرة حقّاً، ولا يصدمنا، أو يصدم العالم، ذلك التحوّل من الكذب الصراح بأنهما على قلب رجلٍ واحد، إلى المكاشفة الحقيقيّة التي كان ينتظرها الجميع.
(9)
رأيت آثار الحرب في جميع أنحاء السودان خلال أسفاري، لكنني لم أشهدها أبداً قبل حرب الخرطوم. لكننا كنّا نرى ونسمع صراخ آثار الحرب في جميع أنحاء العاصمة. في أطرافها تكوّمت أعضاء الحروب التي شملت السودان جميعه، إن كانت حرباً دمويّة ووحشيّة، أو كانت إقصائيّة. كنّا نسكن جوار حيّ مايو قبل أكثر من عشر سنوات، التقيت طفلاً كانت والدته تساعدنا في مشروعٍ فشل بسببنا، سألته: انتو من وين أصلاً؟ ذكر لي اسم معسكر لاجئين. قلت: وقبل ذلك؟ صمت لمدّة من الزمن ثم قال: والله ما عارف.
هذه “الما عارف” هي التي تدوّي في أذهان السودانيّات والسودانيين اللذين لم يعرفوا حياةً سوى الخرطوم، والمهاجر العربيّة ربّما، ها هم يهرعون إلى تلك المهاجر، وتُصفع في وجوههم بوّابات الحدود.
(10)
لا أحد خارج مدن دارفور وكردفان والعاصمة يُدرك الرعب الذي يعيشه الموجودون هناك، لا أحد غيرهم هُم، ومحاولات إنكار فرح المواطنين بدحر الجيش للدعم السريع في بعض مناطق العاصمة هي محاولات خالية من الحواسّ الخمس.
سينسى الناس بسرعة غريبة قصف ذات الجيش لهم ولعائلاتهم داخل منازلهم، أو أطفال أحيائهم المجاورة الذين تمزقوا بالقذائف التي يتبادلها الجانبان. قال الشاعر حاتم الكناني، محقّاً، وهو الخارج توّاً من قلب الأتون: “الحرب دي ضدَّ الشعب السوداني من الطرفين، الجيش والدعم”. والإبادة العرقيّة الحادثة في دارفور تقوم دليلاً قاطعاً. دعك عن ما يحترق في الخرطوم وبقيّة الولايات.
(11)
أخيراً، يُعلّق الشاعر العظيم أمل دنقل، في سبتمبر 1970، على “ما حدث في مخيّم الوحدات”:
(1)
قلت لكم مرارا
إن الطوابير التي تمر..
في استعراض عيد الفطر والجلاء
(فتهتف النساء في النوافذ انبهارا)
لا تصنع انتصارا.
إن المدافع التي تصطف على الحدود، في الصحارى
لا تطلق النيران.. إلا حين تستدير للوراء.
إن الرصاصة التي ندفع فيها.. ثمن الكسرة والدواء:
لا تقتل الأعداء
لكنها تقتلنا.. إذا رفعنا صوتنا جهارا
تقتلنا، وتقتل الصغارا !
(2)
قلت لكم في السنة البعيدة
عن خطر الجندي
عن قلبه الأعمى، وعن همته القعيدة
يحرس من يمنحه راتبه الشهري
وزيه الرسمي
ليرهب الخصوم بالجعجعة الجوفاء
والقعقعة الشديدة
لكنه.. إن يحن الموت..
فداء الوطن المقهور والعقيدة:
فر من الميدان
وحاصر السلطان
واغتصب الكرسي
وأعلن “الثورة” في المذياع والجريدة!
(3)
قلت لكم كثيراً
إن كان لابد من هذه الذرية اللعينة
فليسكنوا الخنادقَ الحصينة
(متخذين من مخافر الحدود.. دوُرا)
لو دخل الواحدُ منهم هذه المدينة:
يدخلها.. حسيرا
يلقى سلاحه.. على أبوابها الأمينة
لأنه.. لا يستقيم مَرَحُ الطفل..
وحكمة الأب الرزينة..
مع المُسَدسّ المدلّى من حزام الخصر..
في السوق..
وفى مجالس الشورى
قلت لكم..
لكنكم..
لم تسمعوا هذا العبث
ففاضت النار على المخيمات
وفاضت.. الجثث!
وفاضت الخوذات والمدرعات.
mamoun.elfatib1982@gmail.com