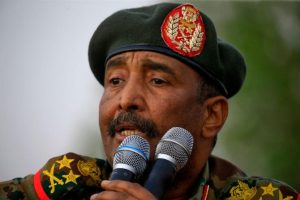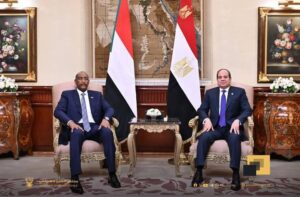في التوكل على الله

يبدو هذا الفعلُ أبلهاً تماماً في ظلّ دولةٍ ونظامٍ رأسمالي، دعك من أن تكون في السودان، وفي زمن دولةٍ دينيَّة بوليسيّة. ظلَّ السودانيّون يعملون بهذا الفقه الغريب عن العالم الحديث، حتَّى أنك تظنّهم أنبياء/أغبياء في هذه الحالات، لذلك بدا أن أغلب المستغلّين لأوضاع الحرب غُرباء.
لقد برزت الأخلاق التي خلَّفها “الأخوان المسلمون” واضحة للعيان بمفارقتها لأخلاق السودانيين، في جميع بقاع أرضه، أعني من رفعوا أسعار الإيجارات، والمواصلات، والحياة ذاتها.
لا يمكنك أن تتوكَّل على الله أبداً ما دامت البنوك والأسواق والتجارة الحرَّة والنظام السايب على حالو بتاع: “الحشَّاش يملا شبكتو”.
لكن في أزمنة الحرب؟ فما من أحدٍ تتوكَّل عليه –في رواية أخرى: تتكي عليهو- غير الله.
إنه الرب الذي لن تستطيع أن تلمس قدرته الفائقة إلا في حالاتٍ كهذه، الحالة التي وصفها التشكيلي عبد الله محمد الطيب:
أكياس نايلون شايلها الهوا، لا عارفة حترك وين، ومتين، ولشنو ذاتو!”. وعبد الله أكثر من يكره البلاستيك، لدرجة أن سمَّى عصرنا –نكايةً بالحجري- بالعصر البلاستيكي.
فعلاً، أصبح كلُّ شيءٍ بلاستيكيٌّ بطريقةٍ مُريعة، والتوكّل على الله بلاهة. لكن ما الذي غرز السخريَّة والتهكّم على وضعنا العبثي سوى هذا التوكُّل؟ قالت صديقتي نماء، وقد عاشت آخر أيامها في الخرطوم وسط معارك جبرة والطرد من البيوت: الناس فاهمة الموضوع غلط عديل، تتوكل على الله وترجى الطيارة تضرب حنانك؟ والله ربنا بنجيك، لكن قال ليك إنت أمرق أول وأنا بنجّيك”.
والآن، ما هي النجاة فعلاً؟ بالنسبة لي أصبح معناها مُضلّل بأسلوبٍ ساخر؛ ففي حين فقدنا الوظائف المجانيّة –بالكاد تُغطي نفقات السكن والأكل والشرب- وجدنا أنفسنا في عالمٍ رأسماليٍّ متحجّر القلب. في الماضي كانت لنا أهداف، كان العمل ذاته هادفاً: أن تحرر مجلةً، أو صفحات ثقافيّة، لهو عملٌ جليل –علمنا أسامة عباس والصادق الرضي- حتّى وإن لم يُؤتِ أُكلَهُ مالاً. ولكننا تعلّمنا كذلك أن عملاً كهذا لا يمكن أن يكون جليلاً خارج أراضي النيلين وصحاريها وغاباتها. إذ ما الذي تسعى لتغييره حقاً؟ العالم؟ النظام العالمي البشع؟. على الأقل كانت الرقعة الجغرافيّة التي وُجدنا فيها تعني شيئاً يُسمّونه وطناً، وكان الناس تستشهد لأجله. ولكن لمن تستشهد الآن؟ ولماذا؟ إنك مجرّد “كيس نايلون شايلو الهوا”.
وبما أننا دخلنا العصر الحديث بمناسبة الحرب، وجدنا أنفسنا لا نعرف أصلاً كيف نتحصل على وظائف ومال! صحيح أن الكثير من الكُتاب والفنانين المغتربين منذ أن بدأ الإنقاذيون “إنقاذنا” ندموا على الهجرة، ولكنهم اليوم في وضعٍ مُفضّل، إذ فهموا وخبروا كيف يديروا حياتهم داخل أمعاء وشرايين قلب العالم الحجري، ولكننا، نحن المتوكّلون على إلهنا، أخرجنا ربّنا ونجّانا، ولكننا واجهنا إلهاً آخر لم نعرف عنه شيئاً: “إله الأشياء الصغيرة” يا قول أرنداتي روي، ذلك الذي لا يرى فيك سوى لحمٍ يُنهش بالتفصيل الدقيق الممل.
أعيش اليوم في قرية صغيرة بحجم 300 شخص في العام. أعلى جبالٍ في جنوب غرب يوغندا، وتقبع، تحت بيتنا، بحيرة كاملة هي من بحيرات منابع بحيرة فكتوريا، أي أنني، لحظة هذه الكتابة، أجلس أعلى أصل أصول النيل الأبيض. يصحون مع الفجر ويذهبون إلى الحقول، ويعودون نهاراً ويتوجهون مباشرةً إلى “كناتين” الحِلّة، يشربون، ببطءٍ شديد، كاسات صغيرة من عرق الموز، ويضحكون: نساء ورجال بجميع الأعمار، وأطفالهم يتراكضون حولهم: جبالٌ وأمطار، حتّى السحاب شخصيّاً يعبر بيتنا كل صباح، وبينما أكتب الآن، تملأ الأمطار خزانات المياه، وتمنح تربة أرضنا شراهة الولادة والجمال. مع كل هذا فقدت الإيمان، بل فقدت كل شيء.
لا جمال في العالم يوازي جمال مدينتنا الخرطوم، جمال سكّانها ونضالهم القاسي لأجل حياةٍ أفضل. كم بكينا على قضبان حديد كبري النيل الأزرق أمام “قوّاته المُسلّحة” ونحن نشاهد ملايين السودانيين يشعلون هواتفهم ويصدحون بنشيد علمهم. حتّى ود الزين -المتشائم الأكبر- كان يجلس بجانبنا، أنا وأفّه، وكان يتفاءل.
أريد أن أقول أنني كرهتُ مدينتي أمدرمان لتعاليها على السودانيين، وكرهت الخرطوم أكثر، وعملتُ ما في وسع حياتي لأبرهن على غطرسة أهلها وتباهيهم بها. لكنني اليوم أتعاطف مع نفسي وأقول، كما يقول ملاك: شبابك في ما أفنيته؟ كيف أنفقت حياتك تحارب الخرطوم؟.
أتذكر الآن أيام أن نُبذنا من الصحف الورقيّة، وتحولنا إلى مجرَّد مصححين لغويين في المعامل –نسميها المسالخ- مع إخواننا التشكيليين المصممين. بعد الورديّة التي تبدأ في الرابعة وتنتهي في العاشرة مساءً، كنت أسير من شارع المك نمر طلوعاً إلى كبريه الحديث، مروراً ببيت “عشَّة” حيث تتناول قزازة عرقيك، وتذهب، بكامل روحك إلى النيل. تجلس وتمدّد قدميك، كذلك ستشاهد، على المصاطب القريبة من المياه، حيث أعمدة الجسر، أطفالاً ينامون بلا غطاء، ينامون بعمق، ولن تدري أبداً كيف يشعرون أو كيف يحلمون، إلى أن تأتي حربك: حيث الكوابيس اليوميّة تصبح عادة لن تُخبر بها حتّى زوجتك، لأنك ستصبح مملاً وسقيماً.
أخيراً. إنني أعيد تعريف نفسي: أنا خرطومي عتيق، ولن أتنازل عن مدينتي، وإن متُّ أخبروها بأنني أحببتها، ولن أحب مدينة سواها.
2 أغسطس 2023م
mamoun.elfatib1982@gmail.com