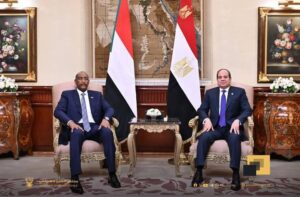التركية إليف وسحر البساطة
قواعد العشق الأربعون

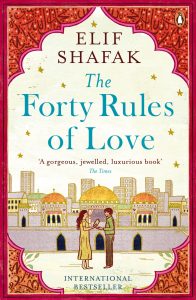

مذهلة هذه الكاتبة، ومشوّق كلما يقع بين أيدينا من وحي يراعها. تجد رواياتها تنتظم في ألق هندامها بفواتح المكتبات، ذلك ودون مغالاة، من المحيط إلى الخليج. ما أجمل اختيارها للمواضيع وما أوفق ترجمتها للسِيَر، وما أعمق معالجتها للمضامين، فضلاً عن الزي الخارجيّ الذي تُلبسه لهذه القصص.
تجابهنا الكاتبة شفق بخطاب عصريّ، حديث، طارئ، متجدد وفاضح – رغم البعد التاريخيّ للرواية – ونحن نرانا نُجابه في هذه الألفية تحديات شتّى، منها الإرهاب النفسي والمادي، الدمار بكل أنواعه وأهمه الدمار الروحيّ والروحاني، وسقوط القيم كماً، ونجابه بالقدر نفسه عنفاً سياسيّاً دينويَاً لم يشهد له العالم من مثيل. ونفتقد يا سادتي في الركود الفكريّ الذي عشّشَ بألبابنا، وفي حالة الاكتئاب المزمن التي نعانيها لبعض من أمور أبجديّة. وربما ننسى بين هذا وذاك، بل قُلْ نتناسى في خضمّ كل هذه المصائب “لكلمة السرّ” أو “مفتاح الكنز” التي بها تنشرح الصدور، وتتعافى الجروح، وتختلج الأنفس، مزاملة بعضها البعض في سلام وطمأنينة، وهي بكل بساطة: كلمة “الحب”! نعم، – مرّة أخرى وبكل بساطة – الحبّ بكل معاييره، مقاييسه، أطره، أبعاده وتجلياته.
قواعد العشق الأربعون رواية تاريخيّة وتأريخية للكاتبة ذات الأصل التركي إليف شفق. نشرتها – باللغة الانجليزيّة – بعد أن ذاع صيتها قَبل برواية سبقتها: “لقيطة اسطنبول”. القصد من خطابي هذا الحث على قراءتها والتحفيز على ارتياد آفاق أوسع – متحاشيا لفظ “واسعة” – أغلب الظنّ بعيدة أو ربما قريبة، يتمكن من خلالها القارئ معرفة حقائق تاريخية تهمه وتمسّ أيما مساس محيطه الذي يعيش فيه وربما يتمكن – إن وفقني الله – أن يرى بعين لُبِّه الحقّ ليكون هو – لا أحد غيره – “الفاروق”.
في رواية قواعد العشق الأربعين تسحرنا شفق – في بساطة السهل الممتنع – بسلاسة السرد المتوازي لقصتين في الأصل منفصلتين تماما، يربطهما خيط مرهف واهن لكنه جيّاش. تتهادى أحداث إحداها في الزمن المعاصر (2008) وتموج أشعة الأخرى في الهامات بحور القرن الثالث عشر للميلاد.
إنها يا سادتي قصة سيّدة يهوديّة في زهراتها الأربعينيّة تدأب، في اجتهاد تحسد عليه، باحثة في أنقاض التاريخ البشريّ عن حقيقة ما، لمستها في تجوال الدرويش العارف بالله شمس التبريزي وعبر لقائه ومولانا جلال الدين الرومي. تعيش السيّدة أيلا روبنشتاين في عشّ أسرتها، زوجها وأولادها، بمدينة منسشوتيس بالولايات المتحدة.
تتبدّى كربّة بيت ماهرة في كل ما تشرع إليه وفيه، بيد أنه ينقصها في حراكها اليوميّ هذا خبز العقل وغذاء الفكر الذي طالما أجهضته ناكرة للذات متفانية بحق فلذات أكبادها؛ كانت تستثيرها – في حلم يقظيّ مستمرّ – مشاركة المجتمع بعمل جدير تقوم به ويرضى عنه الأخرون. تجد ضالتها المنشودة بعد لأي واجتهاد ومثابرة في دار نشر فيوكل إليها مهمّة تحمل في ثناياها نقد رواية باسم “الكفر الحلو”، ألّفها كاتب هلوندي، باحث في طرقات الحياة، انتهج التصوّف بعد أن غدرت به ومن قبل زجرته ثم هجرته سبل الحيوات الكريمة فطرق أبواب الله متوكلا في بقاع الأرض المختلفة – كمصوّر فوتوغرافيّ – يتحسس بصيص نور الهداية والهدى والاهتداء في آخر النفق.
شرعت إيلا، ربة البيت، في عملها الجديد لا تلوي على شيء إلا وأن تفهم سرّ هذه الرواية المفعمة بفكر غريب وروح تجازفيّة لم تعهدها من قبل في كاتب بعيد كل البعد عن مدارات الشرق وثقافاته. عزيز (اسمه الجديد) نزل ضيفا على طريقة صوفية بديار المغرب وعلى شواطئ محيطه الأطلسي الذي أحاطه بدفيء لم يعهده من قبل. وكانت ها هنا بداية المسيرة وانطلاقته الأولى للبحث عن أصل الصوفية. مع مرور الزمن والتعمق في رواية عزيز الباحث انتقلت عدوى هذا البحث المستمر إلى ربّة البيت إيلا. أدركت حينئذ أن قصة شمس التبريزي ما هي إلا انعكاسات لقصة عزيز التي ترى فيها نفسها فضلا عن حبّها للإطار الذي كونته شخصية مولانا جلال الدين الرومي لهذه السياقات. فبدأت ترفل على عتبات عهد جديد: مراسلات مع الكاتب عزيز، ثم رسائل، شكوى ثم هيام ثم موعد فلقاء. ولا أودّ أن أشرع في سرد مفاتح القصة ألا أسلب عن خيالكم العصارة. فلا بد لكل من اشتهى المعرفة أن يقتفي أثر إيلا، عزيز، شمش وجلال الدين الروميّ.
على أيّة الأحوال تجسد لنا الكاتبة شفق في هذه الرواية روح العصرين وتحدياتهما: هذا الذي نعيشه وذاك الغابر الحاضر، متنقلة بين دواوين بغداد وأرصفتها وطرقاتها، بيادي فارس وتاريخها حتى تحطّ بنا في مدينة الزهد والصوف “كونيا” بتركيا التي اشتهرت فيما بعد بالدراويش والتصوف والحب الإلاهيّ.
ترسم لنا في هذا السياق لقاءً تاريخيّاً، لقاء الروح للروح، لقاء الخليل للخليل وولادة طفل رضيع رأى النور عند لقاء شمس التبريزيّ لخليله مولانا جلال الدين الرومي. وكان ذاك المرشد الروحي للعلامة في تواضع العلماء. كيف يغدو الدرويش الرّحالة شمس مرشدا لمولانا الروميّ؟ بل تسافر بنا الكاتبة بين صحائف التاريخ إلى أبعد من ذلك لتجسد لنا كيف نجح الرجلان في تجسيد رسالة الحب الخالدة التي أنارت دنيا الكثيرين بروح السلام فضلا عن أنها ابهرت أدباء العالم أجمع بسحرها المتجلي في سلسبيل الروميّ وملكته في النظم والنسج الشعريّ، سيما شعراء أوربا ونذكر على سبيل المثال لا الحصر متنبئ اللغة الألمانيّة: فولفقانق يوهان فون جوته (التي سميت معاهد جوته أو غوته باسمه) ومن ثمّة بُحتريها، الشاعر الفذ فريدريش روكرت (ذاك القاموس الشعريّ اللغويّ المتحرك الذي أجاد أكثر من45 لغة منها العربية والفارسيّة والتركيّة والأردية والهنديّة).
في نهاية المطاف اسمحوا لي أن أختم مقالي المتواضع هذا بالقاعدة الثالثة عشرة من قواعد العشق الأربعين (بتصرّف):
تكتظ دنيانا بأساتيذ علم الزيف وغيرهم ولو كان البحر مدادا لعدّهم لنفد البحر قبل أن تنفد أعدادهم. لا يخلط الحكيم بين علم نافع وعلم دافع (تدفعه الأنانية والتسلط). إن المعلم الصادق لا يشدّ انتباهك إلى شخصه ولا يلزمك بطاعة أيّا كانت، مطلقة أو غيرها، ولا يستبيحك أن تعجب به وبعلمه المدرار لكنه يشدّ من أزرك ويقوّي شوكتك وعضدك أن تُقدِّرَ أوله وآخره نفسك وأن تهذبها وهي الأمّارة وأن تحسّ دواخلك وأن تحترمها حق الاحترام أليسها من خلق البارئ؟! فالمعلم الحقيقيّ والأستاذ الحقّ شفاف كسلسبيل الماء البلوريّ، يتخلل جوانحه جلّها نور الله السرمديّ. فعلى المرء ألا يقاوم تغيرات تعترض سبيله وسراطه، بل عليه أن يترك للحكمة ومشيئة الخالق زمام الأمور كي تعيش الحياة بداخلك كما ينبغي لها، وألا ينتابك القلق والهذيان إذ انقلبت عليك سبلها على عقب، فإنك لن تدرك جوهر الجانب الآخر، المجهول لديك إلى لحظتئذ، وأنه خير وأبقى من ذاك الذي سلقت عليه واعتدت.
(رحمة الله على والدتي عزّة الريح العيدروس ووالدي د. بدوي مصطفى اللذان زرعا فيّ حبّ الخلق وعظمة الخالق في ما برأ، وعززا في نفسي احترام الحق وقوله والجهر به دون أن أخشى في الله لومة لائم)
mohamed@badawi.de