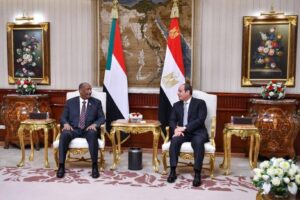معاويه محمد نور ..أديب منسى


المقدمة التي كتبها الطيب صالح لكتاب السني بانقا عن معاوية محمد نور :
تمر بحي الموردة، حيث ولد معاوية نور، وإلى يمينك مراكب خشبية راسية جاءت من أعلى النيل تحمل القنا والخشب والبروش وأزيار الفخار. تمر على حي الهاشماب, حيث نشأ محمد أحمد محجوب وعبد الحليم محمد صاحبا “موت دنيا”. إلى اليمين حي “السور” ودور آل المهدي، ثم مدرسة الأحفاد على اليسار، ثم إلى يمينك جامع الخليفة بسوره القديم، ثم المستشفى الكبير والمدرسة الثانوية. تنزل في السوق ويواصل الترام سيره إلى “أب روف” الحي الذي نشأت فيه حركة فكرية “فابيانية” تعرف بمدرسة “أب روف”.
البيوت من الطين في الغالب وقليل منها من الطوب الأحمر، وكلها من طابق واحد. دور الحكومة فقط أكثر من طابق، وهي لا تزيد على طابقين. تدخل دار الطين، فلعلك تجد أرض “الديوان”– غرفة الاستقبال– مغطاة بالبلاط، وربما يكون في الدار كهرباء والماء جارٍ في المواسير. كل شيء كما عهدته ولكن أحسن قليلاً. عندكم الحيشان، فها هنا حيشان. وعندكم “العناقريب” هذه الأسرة الخشبية المنسوجة بالحبال، فها هنا عناقريب. ربما بعضها من الحديد ولكنها منسوجة بالحبال. الطعام هو الطعام لكنه هنا مطهو بطريقة أفضل، الكسرة والويكة والملوخية كما عهدتها. ذات الناس والوجوه واللغة. والأسر في أم درمان ما تزال تحتفظ بروابطها في الريف، من حيث جاءت. الشايقي مايزال له أهل في ديار الشايقية يزورهم ويزورونه في الأفراح والأتراح. والجعلي، وسكان الجزيرة والبطانة والشرق والغرب.
المدينة لم تقطع بعد جذورها وتتحول إلى كائن منعزل، لا صلة له بما حولها. مولد معاوية محمد نور: في هذه البيئة ولد معاوية محمد نور عام 1909، كما يحدثنا السني بانقا في كتابه، وذلك في العام نفسه الذي ولد فيه يوسف مصطفى التني، وقبل عام واحد من مولد محمد أحمد محجوب والتجاني يوسف بشير، وقبل ثمانية أعوام من مولد جمال محمد أحمد، وتسعة أعوام من مولد أحمد الطيب، وعشرة أعوام من مولد محمد المهدي المجذوب، واثني عشر عاماً من مولد عبد الله الطيب. كل هذه الأسماء لعبت أدواراً مهمة في تاريخ الحركة الأدبية والفكرية في السودان، وبعضهم لعب أدواراً رئيسية في الحركة السياسية. وكان مولد معاوية محمد نور بعد أحد عشر عاماً من غلبة الاستعمار البريطاني على السودان عام 1898. ذلك الحدث الفادح الذي أثر بشكل أو بآخر في مصائر كل الأسماء التي ذكرتها آنفاً، وفي مصائر أجيال من السودانيين، وكان سبباً رئيسياً في مأساة هذا الإنسان النابغة، معاوية محمد نور. اختار إدوارد عطية في كتابه “عربي يروي قصته” الذي صدر في لندن باللغة الإنجليزية عام 1946، عربيين، اتخذ أحدهما مثلاً للنجاح، والثاني للفشل المأساوي لعملية الامتزاج بالثقافة الإنجليزية، وربما بالحضارة الغربية عموماً. لم يقل هذا صراحةً، فلم تكن تلك الظاهرة قد تبلورت وأخذت مضامينها الفادحة، كما رأينا في ما بعد الصراع العربي ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وصراع مصر مع القوة الاستعمارية إطلاقاً، وكما رأينا وما نزال نرى في الصراع العربي– الإسرائيلي في فلسطين.
وقد كان إدوارد عطية نفسه، خير مثال على التأقلم الكامل، ظاهرياً مع الحضارة الأوروبية، وكان سورياً تعلم في جامعة أكسفورد وتجنّس بالجنسية الإنجليزية وتزوج وأقام في إنجلترا بشكلٍ مستديم، وكان يتحدث اللغة الإنجليزية كأنه إنجليزي، وقد عمل في السودان في مكتب “الاتصال العام” ثم استقال لما نشبت الحرب في فلسطين والتحق بـ”المكتب العربي” وساهم في الدعوة للقضية العربية، وأبلى بلاءً حسناً بشهادة المرحوم موسى العلمي. وقد كتب رواية عن السودان باللغة الإنجليزية، عنوانها “الطليعة السوداء”، وظل إلى أن توفي في الستينيات، يكتب في الصفحة الإنجليزية، مدافعاً عن القضايا العربية. اختار إدوارد عطية، أمين عثمان باشا مثالاً على نجاح عملية التأثر بالحضارة الأوروبية، فقد ذهب أمين عثمان من كلية فيكتوريا إلى جامعة أكسفورد في إنجلترا، وعاد إلى مصر حيث لمع نجمه واحتل مكانةً مرموقةً في فترة وجيزة. وكان أثيراً لدى الإنجليز، مقرباً من المندوب السامي البريطاني. لكن حتى هذه القصة انتهت بالفشل، ففي عام 1950، أي بعد صدور كتاب إدوارد عطية، أصبح أمين باشا وزيراً في حكومة الوفد، فاغتيل رمياً بالرصاص بتهمة الخيانة. وكان أحد المتهمين في قتله، المرحوم أنور السادات، ومن العجب أن أنور السادات نفسه قتل اغتيالاً في ما بعد، بالتهمة نفسها، تهمة الخيانة والعمالة للغرب. إنها خيوط متشابكة في مأساة مثل المآسي الإغريقية. أما معاوية محمد نور ثاني الرجلين، فقد شاءت أقداره أن يسلك طريقاً آخر، انتهى به إلى الهزيمة بطريقة أخرى. ذهب من كلية غردون، وقد كانت مثل كلية فيكتوريا في مصر، لا إلى أكسفورد أو كامبردج، ولكن إلى الجامعة الأمريكية في بيروت، ذلك لأن الإدارة الإنجليزية في ذلك العهد كانت تحدد للشباب نوع الدراسات العليا المحتم عليهم تلقيها، فحددت لمعاوية دراسة الطب. لكن معاوية كان قد عشق الأدب الإنجليزي وصمم على مواصلة دراسته مهما كلف الأمر. وهكذا، فرغم اعتراض السلطات الإنجليزية الحاكمة، ورغم مقاومة عائلته، فقد تم له ما أراد، فأرسلته والدته ليتعلم على نفقتها في الجامعة الأمريكية في بيروت. وربما يكون أول سوداني يدرس على نفقة عائلته في الخارج. ولا يملك المرء هنا إلا أن يقارن بين إصرار معاوية، ولين عريكة التجاني يوسف بشير، الشاعر الملهم الذي أراد أن يسافر ليدرس في مصر، فلحق به أبوه إلى محطة السكة الحديد في الخرطوم، واقتاده حزيناً مكسور الخاطر إلى أم درمان.
لماذا لم يبعث الإنجليز معاوية إلى أكسفورد أو كامبردج؟ إنه لأمر يدعو للعجب، فها هنا شاب أحب لغتهم ونبغ فيها، وكان هو صبي دون العشرين يبز الإنجليز أنفسهم في الحديث عن دكتور جونسون وشكسبير وبرنارد شو. الفرنسيون كانوا حتماً سيحتفون به ويرسلونه إلى السوربون في باريس، كما فعلوا مع سنقور إلى أصبح من كبار شعراء اللغة الفرنسية، وكان أول شخص غير فرنسي إطلاقاً، ينتخب عضواً في الأكاديمية الفرنسية. أما الاستعمار البريطاني، فلم تكن متطلبات العقل والوجدان، ضمن أهدافه. وكان معظم حكام السودان إنجليزاً في ذلك العهد، من العسكريين، وهؤلاء لا يحسنون الظن بمتطلبات العقل والوجدان على أي حال. ولابد أن معاوية خلق لهم مشكلة. كانوا يريدونه أن يأخذ من لغتهم ما يفي بالغرض، لكنه أخذ الأمر مأخذ الجد، فغاص في أعماق اللغة. وتبحر في طيات وجدان المستعمرين وعقلهم، كمن يبحث عن مفتاحٍ للغز، وحاربهم في ما بعد بسلاحهم وانهزم، لأنه جاء باكراً، أبكر مما يجب، ولم يكن أمثاله كثيرين. وربما يكون من الطريف، أن يتصور ماذا كان سوف يحدث له، لو أنه ذهب بالفعل إلى أكسفورد أو كامبردج. إنني أعتقد أنه كان سيسعد جداً، في بداية الأمر على أي حال. كانت هاتان الجامعتان في تلك الأيام في العشرينيات، وخاصة جامعة كامبردج، بؤرتي إشعاع فكري وانطلاق روحي لا مثيل لهما. كان معاوية سوف يلتقي بالفيلسوف أي. جي. مور، والفيلسوف برتراند راسل. كان سوف يقابل العالم جوليان هكسلي وأخاه الروائي المبدع أولدس هكسلي. هناك كان سوف يتعرف على ليونارد وولف الذي تزوج في ما بعد من الروائية العبقرية فرجينيا وولف. وكان سيقابل الرسامة فانسا بل أخت فرجينيا وولف. كان سيتعرف على لتن ستريشي وبقية آل ستريشي، وعالم الاقتصاد الذي قلب الأفكار الاقتصادية رأساً على عقب، كينز. وكان بطبيعة الحال سوف ينضم إلى مجموعة “بلو مسبري” التي كانت تلتف حول فرجينيا وولف ولتن ستريشي. وكان حتماً سوف يتصل بجماعة الفابيانيين المكونة من بعض هؤلاء، إضافةً إلى برنارد شو وأتش. جي. ولز وبروفيسور توني وسدني ويب وزوجته بياتريس ويب، وكان سوف يجد إنجليزاً من نوع آخر، كأنهم لا يمتون بأية صلة لنوع المديرين والمفتشين الذين يحكمون السودان، بضحالتهم وعنجهيتهم وضيق أفقهم. ها هنا لا حدود على العقل البشري في محاولته ارتياد المجهول، ولا قيود على الفرد في التعبير عن نفسه.
وكان معاوية محمد نور وسيماً جداً، كما يروي كل من عرفوه، هذا بالإضافة إلى شفافية روحه وتوقد ذهنه وعمق ثقافته. لذا فأغلب الظن أنه كان سيجد فتاةً من مثقفات الطبقة الأرستقراطية تقع في حبه. كانت فتيات هذه الطبقة، خصوصاً المثقفات منهن، يبحثن عن الطريف و”الأكسوتيكي” غير المألوف. وكن سيجدن في معاوية إنساناً طريفاً حقاً. والحب من الحلقات الضائعة في قصة معاوية. إنسان كهذا لابد من أنه أحب كثيراً. ماذا حدث له في بيروت؟ وماذا حدث له في مصر. وما حدث له في السودان يمكن أن يتخيله الإنسان؟ ويورد السني بانقا عرضاً في كتابه، أن معاوية أحب فتاةً سودانية وشقراء، يا للعجب!بلى، كان سوف يسعد في أكسفورد أو كامبردج. وكان سوف يطلق لخياله العنان، ويرتاد كل الآفاق العقلية التي كان يحلم بها. ولا شك عندي، أنه كان سيصبح ناقداً مرموقاً في الأدب الإنجليزي، وسط الإنجليز أنفسهم. هل كان سيفقد “هويته” ويصبح “مستلباً” كما نقول هذه الأيام؟ ربما، ولكن عذاباته ومعاناته كانت ستسمو إلى مستويات أرفع، ولابد أنه كان سيصنع منها فكراً وأدباً عظيمين، يضيئان الطريق لمن بعده، في الشرق والغرب. ولعل من الطريف أيضاً أن ننظر إلى ما حدث لشخص مثله أو قريب منه من الذين قبلوا بالواقع وصبروا على العيش في السودان. وربما يكون أكثر الناس شبهاً به المرحوم محمد أحمد محجوب. يحدثنا السني في كتابه أن محجوباً كان من أصدقاء معاوية المقربين الذين كان يقضي أوقاته معهم يتحدثون في شؤون الأدب.
كان محجوب في مثل سن معاوية وولد بعده بعام، سنة 1910، في حي قريب من الحي الذي نشأ فيه معاوية في أم درمان، كان أديباً شاعراً، ولو كانت الظروف مختلفة، لعله كان يتفرغ للأدب. لم يكن في مثل نبوغ معاوية، ولكنه كان موهوباً يحيط به ألقٌ لازمه في نهاية حياته. تعلم مثله في كيلة غردون وفرض عليه الإنجليز أن يدرس الهندسة فأذعن وتخرج مهندساً. ثم لما فتحوا فرعاً للقانون تحول للقانون وعمل قاضياً في السلك الإداري لحكومة السودان. ولما قامت الأحزاب وعلت الدعوة للاستقلال استقال من القضاء وانضم إلى حزب الأمة، فأصبحت له فيه مكانة. وكان زعيماً للمعارضة في أول برلمان سوداني، ثم صار وزيراً للخارجية فرئيساً للوزراء. وفي كل مراحل حياته لم يكف عن ممارسة الأدب، فكتب القصة والمقالة والشعر. وشعره ناصعٌ حسن، وله عدة دواوين. وقد تزوج وأنجب وعاش حياةً ميسورة واكتسب شهرةً في القضاء والمحاماة والسياسة وحتى الشعر. توفي– رحمه الله– وهو يخطو نحو السبعين. لكنني أظن، بأن محجوباً رغم النجاح الذي ناله، كان يحس في قرارة نفسه، بأن المجد الحقيقي الذي يشتهيه، وكان في متناول يده، لم يحصل عليه. ذلك هو مجد الشعر. هكذا نجح المحجوب، بعض النجاح، بينما فشل معاوية فشلاً مأساوياً. ذلك لأن معاوية كان “أديباً” صرفاً و”مفكراً” صرفاً، ولم يكن يرضى لحياته في الأدب والفكر بديلاً، ولم يكن مستعداً للمساومة وقبول أنصاف الحلول. واللمحات القليلة الكاشفة التي يذكرها السني عرضاً في الكتابة، تعطي القارئ صورة غريبة لحياة معاوية في السودان. كان يلبس ربطة العنق المساماة “ببيون” وهي ربطة قليل من يلبسها حتى هذه الأيام، وكان حين يعود إلى السودان يقيم في “هوتيل” وهو أمر شاذ في عرف السودانيين إلى اليوم، وكان يلعب التنس في ملعب خاله، وقد أدهشني أن سودانياً كان عنده ملعب للتنس عام 1926! وكان يلعب “البليارد” في “كلوب أم درمان”. هذا إلى جانب أنه أحب فتاةً “شقراء” عندها فونوغراف من نوع “صوت سيده”، وكان يقرأ “كانت” و”نيتشه” و”شوبنهاور” و”شللي” و”بايرن” و”هازلت” وفلاسفة وشعراء وكتاب، كلهم أوروبيون، قليل من قرأهم حتى في أيامنا هذه. وكتاباته عن التراث العربي تشي بنوع من الاحتقار. أليست هذه إرهاصات لما يسميه أخواننا المغاربة “الاستلاب”؟ لو عاش حتى قرأ “فرانز فانون” لأدرك أن الاستعمار، الذي كرهه وقاومه بفكره، كان ينفث سمومه في روحه من حيث لا يدري.
لم تكن أولها. وهي تنم عن مقدرة وعمق وكان يتحدث فيها إلى الكاتب الفرنسي الكبير حديث الند. وكان معاوية أول من تحدث عن الشاعر الأمريكي– الإنجليزي تي. اس. إليوت، الذي ما يزال يشغل كثيرين من النقاد العرب. وكتب منذ خمسين عاماً عن الروائي البريطاني جون كوبر باور، الذي يعتبر اليوم من أعظم كتاب الرواية في العالم، وما زال مجهولاً لدى أغلب المثقفين في العالم العربي. ونشرت له “السياسة الأسبوعية” في أبريل عام 1930 عن الراقصة إيزادورا دلكن” مقالة لو نشرت اليوم في بعض البلدان العريبة لأحدثت ضجة. ومقالته “نحن وجائزة نوبل” التي نشرت في جريدة “مصر” في سبتمبر 1931، يمكن أن تنشر اليوم فما زاد الناس كثيراً على ما ورد فيها من أفكار. واستمع إلى قوله في معرض الحديث عن كاتب نمساوي يدعى آرثر سنتزلز في جريدة “مصر” في أكتوبر عام 1931: (نحن في مصر نتكلم عن كتاب الدرجة الثالثة في فرنسا وإنجلترا، ونجهل من هم في طليعة كتاب العصر الحديث، لا لسبب سوى أنهم من أمم ليس لها حظ إنجلترا أو فرنسا من الاتساع أو السلطان… بل يخيل إلي في كثير من الأحيان أن أدباء النرويج وبولندا وتشيكسلوفاكيا والسويد والنمسا، نحن أقدر على فهمهم والاستفادة منهم من أدباء الإمبراطوريات والممالك الضخمة التي لا نشترك معها في عاطفة أمل أو ألم… وفي يقيني لو أن أدباءنا ابتدأوا يتدبرون منتجات “هامسون” و”ستيفان زفايج” وأندادهما لوجدوا فيها أشياء جديدة من نفوسهم مكان العطف والمجاوبة… ولاكتشفنا في تلك النغمة صداقة وقرابة روحية مثل ما وجدنا من صداقة وقرابة في الأدب الروسي).
ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أعجب قوله: “صداقة وقرابة روحية” منذ أكثر من خمسين عاماً! وفي مقالة عن الجامعة المصرية نشرت في جريدة “مصر” في أكتوبر 1931، يقول: (وليس بنا حاجة إلى أن نقول إن الجامعة “وسط” قبل أن تكون معهداً لتلقي المعارف والعلوم، وإنها “مؤسسة” تشير إلى مجهودات الأمم الفكرية وخصائص عبقريتها، وتنتج لها من الشبان من يشيرون إلى أنبل وأعمق خصائص تلك الأمة ومنتجاتها الفكرية ومساهمتها في الحضارة العالمية. وليس قصاراها أن تمنح كذا وكذا من الشهادات وأن تلقى فيها الدروس على هذه الطريقة “الإسكولاستيكية” العتيقة. والسبب في كل هذا الارتباك والبعد عن جادة الصواب مرجعه إلى حب مظاهر الأشياء دون بواطنها وصميمها). أليس هذا من دلائل عظمة الكتّاب، أن يقول القول ويمضي عليه أكثر من خمسين عاماً، فيظل صادقاً كأنه قيل لساعته؟!كذلك أنت ترى أن العقاد لم يكن مغالياً حين قال في رثائه: بكائي على ما أثمرت وهي غضةٌ وما وعدتنا وهي في الغيب ماضية تبينت فيه الخلد يوم رأيتموها بان لي أن المنية آتية هذا الإنسان، بهذه الصورة، انتهى به المطاف إلى داره في أم درمان، فلزمها لا يخرج ولا يقابل أحداً، وعاد إلى لبس الثوب الوطني، وأصيب في عقله، فركن إلى شيخ يعطيه الرُّقى والتعاويذ. وتوفي في عام 1941 وعمره فوق الثلاثين بقليل. لا عجب إذاً أن صديقنا السني بانقا قد شغف بقصة معاوية محمد نور الذي جاهد جهاداً نبيلاً، ومات موتاً مأساوياً. والموت المأساوي للنوابغ في السودان، أمر مألوف، فهو بلد أعطاه الله كل شيء، وحرمه كل شيء؟! ذلك أن أخانا السني فياض الشعور، سريع التأسّي، ثم أن معاوية قريبه، ولابد أنه وهو طفل لمحه أو سمعه، ولابد أنه ظل يسمع الحديث يتردد عنه بعد وفاته في محيط أسرتهما. والسني إلى جانب هذا، أديب، ولعله حلم أن يوقف حياته على الأدب، لو كان السودان غير السودان. كان من أكثرنا إلماماً بالأدب، ونحن صبية في مدرسة “وادي سيدنا” الثانوية. وأحمد له أنه نبهني إلى معاوية وإلى التجاني يوسف بشير. إنه أيضاً مثل على تبديد الطاقات في السودان، مثل أخينا مأمون حسن مصطفى، الذي كان نابغة في علم “الكيمياء” فانتهى به الأمر مثل السني أن أصبح إدارياً، وعبد الوهاب موسى, ومحمد خير عبد القادر, وسيد أحمد نقد الله, وكثيرين غيرهم. هؤلاء في جيلنا فحسب. لكن القصة لم تكتمل بعد، فالسني قد أعطانا خيطاً أو خيطين، ما تزال ثمة خيوط كثيرة. والسني يحث الباحثين والدارسين أن يجمعوا هذه الخيوط. لكنني لا أعرف أحداً أحق بهذا الشرف، ولا أقدر على هذه المهمة، منه هو. ويا ليته نذر نفسه، وليمد الله في الأيام، للنهوض بهذا العبء. سوف نحمده نحن وتحمده الأجيال القادمة، ولعله أيضاً يجد أن أحلامه الوضيئة، إذ نحن صبية في مدرسة “وادي سيدنا” لم تذهب كلها هباء