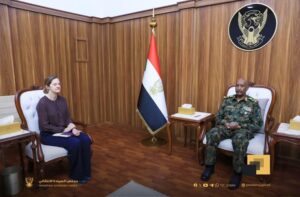وزير المال السوداني السابق: اقتصاد البلاد في طريقه للانهيار

ملخص
تناول وزير المالية السوداني السابق إبراهيم البدوي في حوار مع “اندبندنت عربية” أبرز المشكلات التي تعترض نهضة السودان وطرق استعادة عافيته في ظل استمرار الحرب المدمرة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”.
اعتبر وزير المالية السوداني السابق إبراهيم البدوي أن الحرب المندلعة في بلاده بين الجيش وقوات “الدعم السريع” منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 تشكل نقلة سلبية مدمرة لا مثيل لها في تاريخ الحروب داخلياً وأفريقياً، مؤكداً أنها أقرب ما تكون إلى حالة الحرب السورية، بخاصة أنها باتت حرباً متنقلة، من فصائلية عسكرية إلى إثنية جهوية، مما ينبئ باستمرارها لسنوات طويلة قد تصل إلى 15 و20 عاماً، وهو ما يجعل الاقتصاد السوداني يفقد نحو 189 مليار دولار في أقل تقدير.
وأشار البدوي في حوار مع “اندبندنت عربية” إلى أن “الخطورة تكمن في أنه عندما ينهار الاقتصاد يتجه البلد نحو التفكك، والاتجاه يكون في أحسن الظروف نحو السناريو الليبي وهو أمر وارد في ظل المعطيات القائمة”.
وبيَّن البدوي أن “مشكلة هذه الحرب أنها اشتعلت في مركز الاقتصاد ممثلاً في العاصمة الخرطوم التي تستحوذ بحسب التقديرات على ثلث اقتصاد البلاد ممثلاً بالصناعة والخدمات والبنى التحتية”، لافتاً إلى أن “نحو 10 في المئة من الرصيد الرأسمالي البالغ نحو 600 مليار دولار وفقاً لتقديرات عام 2019 تم تدميره في أول ثلاثة أشهر من الحرب”.
نقطة مضيئة
وفي استعراضه لمراحل سير وتطور الاقتصاد السوداني خلال الحقب التي أعقبت الاستقلال، قال البدوي، “في الحقيقة، إن السودان كان في نظر العالم قبل أن ينال استقلاله في عام 1956، النقطة المضيئة في القارة الأفريقية باعتباره إحدى أيقونات تركة الاستعمار البريطاني نظراً إلى ما يتمتع به من حركة سياسية ناهضة، وتعليم واسع، وإقامة أكبر مؤسسة زراعية على مستوى العالم (مشروع الجزيرة) تحت إدارة واحدة بمساحة 2 مليون هكتار، فقد كان هناك تفاؤل كبير بأن يكون بين الدول العملاقة في أفريقيا، لكن للأسف الشديد في الأدبيات المختلفة، عرف السودان بأنه الدولة الأكثر معاناة من الحروب الأهلية التي استمرت 50 عاماً في فترة ما بعد الاستقلال، فالفترة الوحيدة التي استقر فيها دون أن يشهد عنفاً كانت ما بعد توقيع اتفاقية أديس أبابا بين حكومة (الرئيس السابق) جعفر النميري وحركة الأنانيا المتمردة في عام 1972،
التي دامت 11 عاماً، لتشتعل بعدها حرب الجنوب في نسختها الثانية على يد الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق”. وأضاف، أن “مسألة العنف الذي انتشر في البلاد من حرب الجنوب، ثم حرب دارفور بسبب الإحساس بالتهميش وعدم التوازن في التنمية، أدى إلى عدم حدوث تطور كبير بعد الاستقلال، لكن أكثر فترة شهدت تطوراً كانت حقبة (الرئيس السابق) إبراهيم عبود (1958- 1964) التي أقيمت خلالها بعض المشاريع الصناعية، وإلى لحد ما أيضاً عهد النميري (1969- 1985) الذي استقطب استثمارات خارجية في ضوء إعلان السودان سلة غذاء العالم، لكن المشكلة الأساسية هي أن الديمقراطية أجهضت بالانقلابات العسكرية وبعدم التوافق على رؤية نهضوية، فمن الصعب أن تكون هناك تنمية اقتصادية كبيرة في ظل اقتصاد متخلف ومجتمع مؤثر عليه الانتماءات والانقسامات الجهوية والإثنية”.
وأردف قائلاً “لكن من يطلع على أدبيات مرحلة ستينيات القرن الـ20 الماضي، يجد أن الأفكار نفسها والمخاوف التي كان يحملها رئيس الوزراء الشاب آنذاك الصادق المهدي (1966-1967) ما زالت قائمة، فمثلاً من ضمن الأفكار التي تقدم بها، أنه لا بد أن ينفذ حكم إقليمي واسع للجنوب يشبه الفيدرالية الموسعة وأن تطبق اللامركزية في باقي الأقاليم، مع ضرورة الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، وفق برنامج واضح قابل للقياس، بخاصة في مجال التحول الاقتصادي الاجتماعي. وأعتقد أن عدم الإدراك بأهمية هذه التحديات كانت واحدة من أكبر المشكلات التي اعترضت تطور السودان على الصعيد الاقتصادي والسياسي”.
ومضى قائلاً، “بنظري بنظري فإن كل تجارب الحكم الشمولي كانت فاشلة ومانعة لاستقرار البلد ونهضته التنموية، حتى إذا عقدنا مقارنة مع إثيوبيا، التي يعتقد كثير من الباحثين أنها تتشابه مع السودان من ناحية تعقيدات المجتمع، نجد أن المشروع الإثيوبي أيضاً فشل بسبب الشمولية والدخول في حرب أهلية، وهو ما يشير إلى أن الشمولية التنموية أكثر نجاعة في المحافظة على السلطة وتحقيق إنجازات، من الشمولية الزبائنية التي كانت تمثلها حكومة الرئيس السابق عمر البشير”.
استخراج البترول
ورداً على سؤال حول الكيفية التي مكنت نظام البشير من استخراج البترول وتقديراته المالية؟ أفاد وزير المالية السابق بأن “هناك حقيقة لا بد أن يعلمها الجميع أن حكومة الديمقراطية الثالثة (1986- 1989) كان توصلت إلى اتفاق مع شركة شيفرون الأميركية بأنه إذا لم تتمكن خلال خمسة أعوام من الاستثمار في البترول ستفقد الحق القانوني في مواصلة عملها، وهو الاتفاق الذي استفاد منه نظام البشير الذي جاء للحكم في يونيو (حزيران) 1989 في استخراج النفط. وفي اعتقادي أنه إذا كانت الحكومة الديمقراطية آنذاك مستمرة لكانت استخرجت البترول بصورة أفضل في إطار التكنولوجيا الحديثة المتبعة، في حين اتجه النظام السابق لاستخراجه في ظل المقاطعة الاقتصادية التي فرضت عليه بسبب رعايته للإرهاب، فضلاً عن استضافة زعيم القاعدة أسامة بن لادن في الخرطوم”. وواصل “لكن الشاهد أن البترول استغل في تمويل سوق المال السياسي، فكان رئيس الحكومة عمر البشير يوزع ريعه بحسب الأولويات المتعلقة باستمرار النظام في السلطة، وعلى الزبائنية السياسية المرتبطة بنظامه على مستوى المركز والأقاليم بدليل أن التقديرات المتعلقة بالبترول أشارت إلى أنه خلال الحقبة النفطية، حصل السودان على أكثر من 100 مليار دولار، لكن إذا اعتمدنا أقل التقديرات أي نصف هذا المبلغ فسنجده يساوي أكثر من الناتج المحلي السوداني، وهو إذا كان وظف بصورة فعالة في بناء بنية تحتية مطورة من طرق وكباري ومطارات، لكان السودان في وضع مختلف عما هو عليه الآن، لكن كلنا يعلم أنه حتى القليل الذي تم توظيفه في بناء البنى التحتية تم من دون شفافية وارتبط إلى حد كبير بمصالح النظام الاقتصادية وداعميه، وليس بعيداً من ذلك، ما حدث لمشروع الجزيرة، والخصخصة التي تمت من دون شفافية لمؤسسات اقتصادية رائدة وناجحة، مثل الخطوط البحرية السودانية والخطوط الجوية السودانية”.
خزانة خاوية
وحول حجم النقد الأجنبي الذي تسلمته حكومة الفترة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك عقب سقوط نظام البشير، أجاب البدوي “بصراحة عندما تسلمت وزارة المالية وجدت الوضع كارثياً، فعلى سبيل المثال كان الصندوق العربي للإنماء يقدم قروضاً ميسرة لمشاريع مهمة جداً في السودان، من ضمنها كهرباء الفولة، ومياه القضارف. وكان الصندوق العربي للإنماء وكل الصناديق العربية الأخرى غير مقيدة بالعقوبات التي طالت البلاد، لكن لديه قانوناً صارماً جداً يتمثل في عدم منح قروض لأي دولة عندها متأخرات، وكان الصندوق على وشك تقديم قرض للسودان بقيمة 200 مليون دولار، لكن كان لدينا متأخرات بحدود 15 مليون دولار، وللأسف لم يكن المبلغ متوفراً في خزانة الدولة التي كانت خاوية من النقد الأجنبي، مما اضطرني لإجراء اتصالات عدة بعدد من المرافق الحيوية لتوفير هذا المبلغ مثل الميناء البحري والطيران المدني وغيرهما حتى لا تضيع تلك الفرصة”.
وتابع “لكن المفارقة أنه عندما باشرت لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد عملها، وهي بتقديري كانت لجنة مهمة جداً ولذلك تعرضت للاستهداف، أجرت تحليلاً وبحثاً في الحسابات المصرفية لعدد من قادة النظام السابق ووجدت فيها بحدود مليار دولار. وتمت مخاطبة بنك السودان المركزي لتجميد تلك الأموال وبالفعل تحرك المركزي، لكن للأسف الشديد خلال فترة وجيزة تسربت كل هذه الأموال التي كان يمكن أن تحل مشكلات اقتصادية عدة، وهذا دليل على أن النظام السابق بقي متنفذاً داخل مؤسسات الدولة بعد الثورة التي أطاحته”.
وأرجع الوزير التدهور الذي حدث في تلك الفترة بقوله “معلوم أن الاقتصاد يعتمد على روافد مثل المعادن أو البترول أو تحويلات المغتربين وقد تحدث صدمة تتسبب بانهياره، فالذي حصل هو أنه بعد انفصال الجنوب في 2011 حدثت صدمة كبيرة جداً في الاقتصاد السوداني بسبب أيلولة معظم حقول النفط إلى دولة جنوب السودان، في وقت كان النفط يشكل 90 في المئة من صادرات حكومة الخرطوم، ونحو 60 في المئة من إيراداتها، بالتالي تراجعت الإيرادات بصورة ملحوظة، وفي 2012 بدأت الأزمة الحقيقية، لكنها بلغت ذروتها بصورة واضحة في عام 2016 وهو العام الذي بدأ فيه التدحرج الاقتصادي ليصل إلى القاع في عام 2019”.
المؤسسات العسكرية
وفي شأن طبيعة الصراع بين المكونين العسكري والمدني حول وضع الشركات العسكرية، أوضح وزير المالية السابق أن “جزءاً من استراتيجية النظام السابق هو التركيز على المؤسسات الاقتصادية العسكرية والأمنية وإتاحة فرص تجارية احتكارية معفية من الضرائب لها، بيد أن حساباتها لم تكن واضحة على رغم أن القائمين عليها يؤكدون أنها تخضع للمراجعة القانونية. وسبق أن بحثت هذا الموضوع مع مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية (الإنتاج الحربي) ميرغني إدريس، وكان متجاوباً، إذ أكد ضرورة أن تكون وزارة المالية مشرفة على الشركات التجارية العسكرية والأمنية ولديها المعلومات الكاملة عنها. ومن جانبي أكدت دعمنا كحكومة مدنية للجيش كونه يملك القدرة على الإنتاج الحربي، لكن في ما يخص الدخول في الإنتاج المدني كالعمل في قطاع الزراعة، من خلال شركة زادنا، والقطاع الحيواني، بإنشاء المسالخ وغير ذلك، فهذا اقتصاد مدني لا يجب دخوله ومنافسة القطاع الخاص”. وأضاف “لكن بعد ذلك أصبح الموضوع عبارة عن حلقة مفرغة، إذ لم نستطع وضع يدنا على هذه الشركات، وعموماً إن الأمر كان في حاجة إلى إرادة سياسية قوية وتجاوب من قبل الجانبين، المدني والعسكري، وبخاصة الأخير، لكن هذا لم يحدث. وفي رأيي إن هذا الموضوع كان أس البلاء الذي أودى بالفترة الانتقالية، لأنه صحيح أن الصراع القائم بين الطرفين (الجيش والدعم السريع) الذي انتهى باندلاع الحرب كان حول السلطة، لكن أيضاً هو صراع حول الريع، لأن السلطة تمكن من الحصول على ريع سواء في استغلال الذهب أو الشركات العسكرية التي لم تكن خاضعة للمنافسة ودفع الضرائب”.
موازنة الدفاع
أما بخصوص موازنة الدفاع والصرف على الجيوش، سواء الجيش أو “الدعم السريع” والحركات المسلحة، قال البدوي “إن موازنة البلاد وقتها لا تعبر عن الاستحواذ عن الأموال، لكن من ناحية الأرقام كانت معقولة جداً، ففي موازنة 2020 كانت موازنة القطاع المدني، المخصصة للصرف على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، أكبر من الموازنة المخصصة للقطاع العسكري بشقيه (الجيش والدعم السريع)، لكن القضية ليس في الموازنة المثبتة بل في الموارد الجارية، التي كانت كبيرة للغاية، إلى جانب الأصول من المناجم والمصانع، فبحسب تقديرات الاقتصاد السوداني المردود نجد أن 80 في المئة منه كان يصرف على المؤسسة العسكرية، لكن لم تكن هذه الأموال مستغلة في زيادة كفاءة القوات المسلحة وهو مما ظهر فعلاً في الحرب الدائرة الآن”.
وزاد “لا بد عندما تضع الحرب أوزارها، ألا تكون هناك عودة لأي شراكة بين المدنيين والعسكريين لأنها ترسخ مصالح فئوية، فالمطلوب هو سلطة مدنية بحتة قائمة على المساءلة ومقيدة لنقل البلاد إلى تحول حقيقي سياسياً واقتصادياً، فإذا أصبحت كل الشركات العسكرية والأمنية تحت إشراف وزارة المالية وبات هناك شفافية وضرائب وتنافس فمن الممكن أن ينمو الاقتصاد بما يراوح ما بين 20 و40 في المئة، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وتخصيص موارد لكل المرافق بما فيها الجيش، فنحن محتاجون لمخاطبة المؤسسة العسكرية بأن تكون الفترة الانتقالية المقبلة مهنية تدار بواسطة كفاءات على أن تبتعد المنظومة العسكرية عن الحكم.
تهريب الذهب
وعند السؤال عن عمليات التهريب الواسعة للذهب التي شهدتها فترة الانتقال عبر المنافذ الرسمية من دون رادع لإيقافها، أجاب البدوي “صحيح شهدت تلك الفترة عمليات تهريب واسعة للذهب وبطرق عدة، على رغم أنه كانت هناك خطط طموحة وضعتها وزارة المعادن بالتعاون مع وزارة الداخلية للحد من تهريب هذا المعدن، لكن الفترة الانتقالية الماضية كانت فترة صعبة جداً بخاصة بداياتها التي مرت بحالة تدهور أمني مريع، نظراً لأنها جاءت عقب حقبة نظام شمولي استمر 30 عاماً، فضلاً عما شهدت تلك الفترة من اختلاف وتنافر في الرؤى حتى في معسكر الثورة، مما حد من فعالية الحكومة، كما أن الإمكانات المتاحة لمكافحة آفة التهريب كانت محدودة، لكن الأفكار والخطط كانت موجودة من ناحية أن هناك مشكلة ومعالجتها تتم من خلال وجود مدني وعسكري في مناطق التعدين بخاصة أن 80 في المئة من التعدين أهلي”. وواصل “كذلك، من التحديات في هذا الأمر اتساع رقعة البلاد، إضافة إلى أن هناك جهات في نظام البشير كانت تلعب أدواراً مضرة للغاية في الاقتصاد بهدف إفشال الحكومة القائمة وإسقاطها، لكن في نظري أن التهريب الأكبر الذي كان مضراً جداً هو تهريب السلع بخاصة المحروقات التي كانت تهرب إلى دول الجوار مثل جنوب السودان وتشاد وإثيوبيا وإريتريا، وغيرها لأنها كانت سلعة محررة في تلك الدول أي باهظة السعر بينما كانت في السودان من السلع المدعومة اقتصادياً، إذ كانت تشكل ثلث الموازنة، مما يعادل 60 مليار جنيه سوداني (171 مليون دولار) عام 2020، بالتالي فإن أزمة التهريب كانت مستفحلة جداً ولها علاقة بطبيعة المرحلة”.
ولفت إلى أنه لم يكن لدى الحكومة التي كان ضمنها معلومات تمكن من تقدير كميات الذهب المهربة في تلك الفترة، لكن الآن أصبحت التقديرات واضحة، لأن دراسات عدة عن الذهب تشير إلى إيرادات ضخمة من المعدن النفيس الذي تم تصديره إلى الخارج، لكنها لا تدخل خزانة الدولة وليس لوزارة المالية علم بها.
اندلاع الحرب
وحول علاقة تلك التوترات سواء كانت سياسية واقتصادية بالحرب الجارية الآن، ذكر وزير المالية السوداني السابق، “في اعتقادي أن هياكل أنظمة الحكم كانت إحدى الوسائل التي يتبعها الحكم الشمولي لكي يحمي نفسه من الانقلابات العسكرية بالتالي يلجأ إلى تعدد الجيوش لدورها المهم في هذا الجانب، وهنا نجد أن الدعم السريع لعب هذا الدور حيث أدت وظيفتين: الأولى أنها أوجدت تعدداً في منابر القوى وفي الوقت نفسه أصبحت مؤسسة عسكرية طليعية لمكافحة الحركات المسلحة المعارضة، فهذه التركة لم نقدر خطورتها خاصة في ظل التنافس على الريع بين قيادة الفصيلين العسكريين (الجيش والدعم السريع)، والثانية أنها أصبحت قوة كبيرة جداً ومتعاظمة وموجودة في العاصمة لأن البشير كان يتخوف من انقلاب عسكري، بالتالي أصبحت أمراً واقعاً”.
وخلص إلى القول “في البدايات كان هناك نوع من التوافق بين القيادات العسكرية من الجانبين وبالذات في مسألة إطاحة البشير، لكن بعد ذلك حصل فرز أدى إلى تنافر في ضوء حسابات مختلفة لكلا الفصيلين، لكن في النهاية إن الصراع على النفوذ والسلطة والريع هو السبب، لذلك نجد أن بذرة الحرب كانت موجودة أساساً لكن أخذت وقتاً لتتطور حتى حان موعد اندلاعها في منتصف أبريل 2023”.
حجم الدمار
وعن تقديراته لحجم الدمار الذي لحق بالبنى التحتية وغيرها من المنشآت وأثره في الاقتصاد، أوضح البدوي “عرف السودان على أنه بلد موبوء بالحروب الأهلية لكن على رغم التاريخ المأسوي لتلك الحروب، كحرب الجنوب الأولى والثانية، وحرب دارفور، لكن الحرب الأخيرة تعد نقلة سلبية مدمرة جداً لم نشهده في تاريخ الحروب الداخلية في أفريقيا وغيرها لأن الحروب الأهلية عادة تحصل بسبب تمرد على السلطة القائمة وذلك في المناطق الريفية والطرفية، ودواعي الحرب فيها هي التهميش وعدم التنمية، لكن هذه الحرب فصائلية عسكرية وأول بدايتها كانت في مركز الاقتصاد وما حوله، فمدينة الخرطوم الكبرى بحسب التقديرات، تستحوذ على ثلث الاقتصاد ممثلاً بالصناعة والخدمات والبنى التحتية، فهناك دراسة تشير إلى أن نحو 10 في المئة من الرصيد الرأسمالي البالغ نحو 600 مليار دولار حسب تقديرات عام 2019، الذي يمثل المنظومة المتكاملة من بنية تحتية وكل مقدرات الاقتصاد تم تدميره في أول ثلاثة أشهر”. وأضاف، “بحسب التقديرات أن خسائر الاقتصاد في السنة الأولى من الحرب تراوح ما بين 30 و50 في المئة، فحالة السودان أقرب ما تكون إلى حالة الحرب السورية التي بدأت في صورة ثورة سلمية ثم بعد فترة أصبحت صراعاً بين جيشين، وخلال أربعة أعوام انهار الاقتصاد السوري بنسبة 60 في المئة، إذ كان حجمه 60 ملياراً ليصبح 20 مليار دولار، ففي السودان وقعت الحرب بين جيشين في دولة واحدة وهي أشبه بحروب الدول، بالتالي نجد أن القدرة التدميرية كانت كبيرة جداً من ناحية الأسلحة المستخدمة ومناطق النزاع التي تركزت في العاصمة والمدن الكبرى والمصالح الأساسية الخاصة بالاقتصاد”.
وبين أن “خطورة هذه الحرب أنها باتت حرباً متنقلة من حرب فصائلية عسكرية إلى حرب إثنية جهوية، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار هذه الحرب لسنوات طويلة قد تصل إلى 15 و20 عاماً، كما حدثت في البلاد من قبل، سواء حرب الجنوب أو دارفور، وبحسب التقديرات التي استخدمنا فيها نموذج النمو طويل الأجل، فإنه في حال استمرت هذه الحرب خمسة أعوام مقارنة باقتصاد راكد بحجم 35 مليار دولار كما كان في 2022، فإن الاقتصاد سيفقد 52 مليار دولار ما يساوي مرة ونصف المرة حجم الناتج المحلي، أما إذا استمرت الحرب 15 أعوام في ظل اقتصاد نموه صفر فسيفقد الاقتصاد 189 مليار دولار وهو أكثر من ستة أضعاف الناتج المحلي وهذا تقدير محافظ جداً”.
ونوه بأن الخطورة عندما ينهار الاقتصاد، هي أن البلد يتجه نحو التفكك، والاتجاه في أحسن الظروف يكون نحو السيناريو الليبي وهو وارد جداً إذا استمرت الحرب بنفس الوتيرة لأن السودان في الأساس بلد يحمل كل بذور الانقسام، جهوياً وإثنياً، ومن الممكن والطبيعي جداً أن نجد الجيش يسيطر على جزء معين في الشمال، وفي المقابل يسيطر الدعم السريع على جزء في الغرب، وأن يكون الوسط منطقة تنافس بينهما”.
نهضة وإعمار
وفي شأن مدى إمكانية نهضة السودان من جديد في حال توقف الحرب، قال وزير المالية السوداني السابق، “إذا توقفت الحرب في الأشهر القليلة المقبلة أو قبل نهاية عام 2024 بموجب اتفاقية مضمونة أو مدعومة من طريق قرار صادر من مجلس الامن يفرض وقف إطلاق نار على أن يكون متعدد الأبعاد من ناحية الإغاثة الإنسانية والإصلاح الأمني بحسب المعايير العالمية، وفي المقابل تكونت جبهة وطنية واسعة وجامعة كخطوة أولى فقط، لكن الأهم منها الاتفاق على عقد اجتماعي لاستحقاقات قابلة للقياس خاصة في المجال الاقتصادي، فضلاً عن تشكيل حكومة كفاءات مدنية في الأقل لفترة انتقالية واحدة وحكومتين انتخابيتين ببرنامج واضح تدعمه غالبية القوى السياسية، فإن الاقتصاد السوداني سينمو سنوياً بمعدل يراوح بين سبعة و10 في المئة بالنظر إلى أهمية القطاع الزراعي الذي يعد من القطاعات القليلة في العالم خصوصاً في ظل الصدمات العالمية”.
وتابع “السودان ينعم بثروات هائلة في مجالات عدة سواء الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن، فهناك دراسة اقترحت التركيز على المدن المنتجة حيث حددت 14 مدينة لها خاصية إنتاجية، فعلى سبيل المثال هناك مدينة نيالا التي يمثل محور نموها الإنتاج الحيواني بخاصة الأبقار، فمن الجدوى احتضانها مشاريع في مجالات الجلود واللحوم، إذ نجد أن أكبر دولتين في أفريقيا تعتمدان على اللحوم من البرازيل والأرجنتين، هما نيجيريا والجزائر، في حين أن المسافة بين نيالا ونيجيريا ساعتين ونصف الساعة، وبين نيالا والجزائر أربع ساعات، كما هناك مدينة بورتسودان الساحلية التي تتمتع بساحل متميز يمكن أن يشكل قاعدة إنتاجية ويتم شبكه مع دول الساحل الأفريقي، فضلاً عن مدن القضارف والجزيرة الزراعيتين، والنهود التي تشتهر بزراعة الفول السوداني والدمازين وكسلا بإنتاج الموز، إضافة إلى محور الأبيض- الرهد- أم روابة – كادوقلي الذي ينتج الحبوب الزيتية بخاصة السمسم”. وختم “نحن مقدرين أن بإمكان القطاع الزراعي دعم هذا النوع من التطور النهضوي، وهو ما يتطلب نحو 18 مليار دولار خلال الـ10 أعوام الأولى، وذلك بالنظر إلى الاهتمام الخليجي بالذات في مجال الأمن الغذائي، لكن لا بد من إيجاد طبقة سياسية واعية تدرك أهمية الاقتصاد، فضلاً عن أهمية التوافق على مشروع قومي نهضوي في الأقل لفترة زمنية محددة ممتدة من 10 إلى 20 عاماً حتى تكون هناك نقلة حقيقية تؤدي إلى استقرار الحكم الديمقراطي والمحافظة على وحدة البلاد”.